
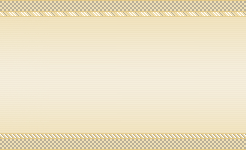
 |
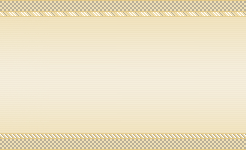 |
| روابط مفيدة :
استرجاع كلمة المرور|
طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
      |
|
|||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | المجموعات الإجتماعية | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
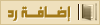 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
ندوة حول المشهد الثقافي في سلطنة عُمان
في مركز "الرأي" للدراسات–المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) ضمن الأيام الثقافية الأردنية في عُمان التي تنظمها رابطة الكتاب الأردنين والجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء الأحد 21 نيسان 2013 · المشاركون: الشيخ أحمد الفلاحي، م.سعيد الصقلاوي، د.عائشة الدرمكي، عزيزة الطائي ود.محمد المهري (عُمان). د.أحمد الحراحشة ود.عليان الجالودي (الأردن). · أدارتها: د.هند أبو الشعر. - تحدث الشيخ أحمد الفلاحي عن تجليات المشهد الثقافي في عُمان وتحولاته ومسيرته. - تحدث د.محمد المهري عن الحكاية الشعبية في التراث العماني. - تحدث د.أحمد الحراحشة (رئيس وحدة الدراسات العُمانية في جامعة آل البيت الأردنية)، ود.عليان الجالودي (الرئيس السابق لوحدة الدراسات العُمانية في جامعة آل البيت الأردنية) عن الوحدة ومشاريعها. - مرفق أوراق: م.سعيد الصقلاوي، د.عاشة الدرمكي وعزيزة الطائي.
__________________
ديواني المقروء |
|
#2
|
||||
|
||||
|
سلطة الخطاب والهوى في (عبد الفتاح المنغلق لا يحب التفاصيل)
عائشة الدرمكي " إن الخطاب شيء بين الأشياء ، وهو ككل الأشياء موضوع صراع من أجل الحصول على السلطة..." ، هو إذن ليس انعكاساً للصراع أو من أجله ، بل هو مدار يشكل نص يستثمر الرغبة ليمثل مدار الرغبة والسلطة ، لذلك فكما يعتقد فوكو فإن الخطاب لم يكن موضوع سلطة بل المدار الحاسم لها . والسلطة هنا تعتمد على مدى هيمنة الخطاب على النص بشكل داخلي أولاً ، ثم هيمنته على نظام التواصل داخلياً وخارجياً ثانياً ؛ ولذلك فإن الخطاب هو استراتيجية التلفظ ، أو نظام مرَّكب من الأنظمة التوجيهية والتركيبية والدلالية والوظيفية النفعية التي تتوازى وتتقاطع جزئياً أو كلياً فيما بينها ؛ فالإنسان يتقابل وجهاً لوجه مع خطابه كونه كائناً خارجياً مستقلاً لا يخضع إلاَّ لقواعد وجوده الموضوعية. ولما كان للخطاب سلطة اجتماعية وسياسية ونفسية ، يشعر بها أفراد المجتمع في مجتمعاتهم كلها من خلال الواقع المعاش؛ فإن الخطاب سنجده مختزلاً في النصوص الأدبية على أنواعها وأشكالها المتعددة ، التي تحرص أن تستقي خطاباتها من المجتمع ومؤسساته التي تتولى مهمة إعداد شروط إنتاجه وتداوله ، لتقوم هذه النصوص بعد ذلك بمهمة توظيف هذه الخطابات في مجتمع جديد تمثله سياقات النص وعلاماته ورموزه . ولأن للخطاب سلطة ضمن السياق الفضائي للنص عامة وللنص الأدبي خاصة – بحكم أننا سنخصص الحديث عنه - فإنه سيُكسب المادة الدلالية تمفصلاتها الأولى ، لتكون في شكل علامات قابلة للتأويل ، ليشكل بهذا فضاءً واسعاً يتهيأ من أجل تعيين هيئة ووساطة لعلامات ورموز النص لتتمتع بكيان مستقل ، تتبلور فيه التمفصلات التكميلية للعلامات ؛ ولذلك فإن السيميائية لا تعني دراسة العلامات المتمثلة في مستوى التمظهر اللساني أو التشكيلي أو الموسيقي أو البصري فحسب بل لكل ذلك ولكل ما هو ضمني فيها ، على أن الخطاب هنا "...يكتسب أهميته من (السيميم) نفسه الذي يشكل العلامات الخطابية..." . وضمن هذه المجالات الواسعة للسيميائية سندرس هنا تلك السلطة الهووية التي تسيطر على خطاب النص ، وتهيمن على الذات الفاعلة والذوات السردية المقابلة لها ضمن السيمات النووية التي تشكل الصور وتحيل إلى تصور خارجي للعالم ؛ فـ "... تنظيم هذه السيمات النووية في صور تعطي المجال لوحدات مضمونة مستقرة محددة بنواة دائمة تتحقق افتراضاتها بتنوعها حسب السياقات..." ، على أن تلك الصور ترتبط بالواقع المجتمعي من ناحية والمخيال من ناحية أخرى الذي يتصل بالإدراك قبل كل شيء فـ " الصور تُكلَّم قبل أن تُرى" يعتبر الخطاب هنا بمثابة حدث ، أي أن شيئاً ما يحدث عندما يتكلم أحدنا ، وتفرض هذه النظرية ، نظرية الخطاب كحدث ، نفسها بمجرد ما نأخذ بعين الاعتبار العبور من لسانيات الكلام أو الرموز ، إلى لسانيات الخطاب أو الإرسالية . ومصدر التمييز ، هو فردناند دوسوسير ولوي يلمسليف ، يميز الأول بين اللغة والكلام ، والثاني بين التصور والاستعمال ، بينما يذهب اللساني الفرنسي إميل بنفنيست إلى أن لسانيات الخطاب ولسانيات اللغة تنهض على وحدات مختلفة ؛ فإذا "كانت العلامة (الصوتية والمعجمية) وحدة أساس اللغة فإن الـ(الجملة) هي وحدة أساس الخطاب ؛ ولذلك فإن لسانيات الجملة هي التي تدعم جدل الحدث والمعنى ، الذي تنطلق منه نظريتنا (نظرية النص) " ، ولذلك فإنه لا يمكن الاكتفاء بالمستوى السطحي في التحليل بل يجب التركيز على الشبكة التركيبية للنص السردي بوصفها قادرة على اختيار اللكسيمات القيمية ، لذلك يظهر اللكسيم -كونه موضوعاً لسانياً- "... كمجموعة من الافتراضات التي لا تتحقق تحقيقاتها المحتملة إلاَّ بفضل مسارات تركيبية تنعقد أثناء التمظهر الخطابي" . وعلى ذلك يتم الانتقال من الصور اللكسيمية الخاصة إلى مستوى أعلى للتشكيلات الخطابية متمثل في هيمنتها على النظام السردي للنص داخلياً ثم إسقاط تلك الهيمنة خارج النص . عليه فإن الخطاب هنا حدث ما ، وهذا يعني أنه قد تحقق زمنياً وفي الحاضر ، في حين أن نسق اللغة مضمر وخارج الزمن ؛ بهذا المعنى يمكن لنا أن نتحدث مع بنفنيست عن (إلحاح الخطاب) على تحديد ظهور الخطاب نفسه كحدث . وفضلاً عن ذلك ، بينما لا توجد للغة ذاتٌ بمعنى أن سؤال (من يتكلم؟) لا يليق بهذا المستوى ، يحيل الخطاب على متكلمه عن طريق مجموعة مركبة من المؤشرات كالضمائر سنقول في هذا الاتجاه أن للخطاب مرجعية ؛ فخاصية الحدث ترتبط الآن بشخص المتكلم ، والحدث يكمن في كون أحد ما يتكلم ، أحد ما يعبِّر بأخذ الكلمة . والخطاب بوصفه حدثاً تحيل فيه علامات الكلام على علامات أخرى داخل النسق نفسه ، ويكون الخطاب دائماً على علم بشئ ما يرجع إلى عالم ينوي وصفه ، التعبير عنه أو تصويره ، ويكون الحدث هو المجئ إلى كلام عالم ما عن طريق الخطاب ، وأخيراً بينما لا تكون اللغة سوى شرط أولي لتواصل يقدم له العالم رموزه يكون الخطاب مكمن تبادل كل الإرساليات ؛ بهذا المعنى ليس للخطاب عالم فحسب بل عالم شخص آخر ، مخاطب موجَّه إليه ، والحدث بهذا المعنى الأخير هو ظاهرة التبادل الزمنية (بناء الحوار) ، الذي يمكن أن يُعقد ، أن يطول أو أن يقاطع . كل هذه السمات مجتمعة تجعل من الخطاب حدثاً ، ومن الملحوظ أنها لا تظهر إلاَّ في حركة إنجاز الكلام في الخطاب ، في تفعيل قدرتنا اللسانية في الإنجاز ؛ كل ذلك سيحيلنا إلى هيمنة الخطاب – بوصفه حدثاً - على الذات المتكلمة من ناحية والمتلقية من ناحية أخرى . وعلى ذلك فإن الخطاب هنا هو حالة من حالات التحوُّل المستمرة يكون (الفعل) أي فعل الخطاب هو الحلقة التي يدور في مركزها الخطاب كله ، فهذا الفعل يمثل القوة التي تحرك الذوات والأحداث بوصفه يملك طاقة مهيمنة أو مسيطرة على الخطاب ؛ وعليه فهوى الذات يُمكن أن يكون حصيلة فعل ما داخل النص ، ليس هذا فحسب بل "...إن الهوى ذاته ، الذي يبدو باعتباره خطاباً من درجة ثانية مودعاً في الخطاب ، يمكن أن يكون في الوقت ذاته فعلاً ..." ، فهذا الهوى (الفعلي) يرتبط ارتباطاً مباشراً بالذات الفاعلة التي تسعى بطريقة واعية أو غير واعية عن طريقه إلى الهيمنة أو السيطرة على فعل الخطاب عامة . الخطاب إذن هو الذي يستدعي تلك السيرورة السردية المعقدة ، المتعلقة بتشخيص الأشياء للذات الذي يبدأ بالانزياح بين ما يقال وما يُشعر به ، والقول المستمر بالتدوين في الحرف والمنتهي في الترميزات المركبَّة لآثار هذا الخطاب القولي والهووي ، وهذا التشخيص لا يجعل الفهم الذي يوسطه الشرح ممكناً فقط بل ضروري ؛ ذلك لأن على مستوى تشخيص الأشياء تتجلى لنا تلك الأهواء حاملة لآثار معنوية نفسية خاصة بالذوات من ناحية وبالسيرورة السردية من ناحية أخرى ، بل وبالمجتمعية من ناحية ثالثة، لينشأ عن ذلك كيفية خاصة بخطاب كل نص على حدة ، لتمثل استقلالية الخطاب هنا - كما لاحظ ديلتاي ذلك - واحداً من أكثر شروط وضعنة الخطاب أصالة ؛" ... فالنص نسيج من الكلمات يترابط بعضه ببعض كالخيوط التي تجمع عناصر الشيء المتباعدة في كيان كلي متماسك..." . وبافتراض أن هناك قصدية إبلاغية لخطاب الهيمنة في النص الأدبي تدفعه إلى البحث عن الدروب الملتوية التي تسلكها معاني الأشياء والممارسات ودلالاتها ، خصوصاً أن الذات لا تختفي لتُحِّل الخطاب وحده محلها ، "بل لتُحِّل الممارسة الاجتماعية المركبة محلها ومن ضمنها الممارسة الخطابية ، ومن ضمنها أيضاً الفرد الحديث كونه فاعل ونتاج لمجمل تلك الممارسات" ، وهذا ما يكشف عنه ما يسمى بـ (العلاقة المرجعية) ؛ وهذه الوظيفة المرجعية تعتبر مهمة لأنها توازن بشكل ما خاصية كلام أخرى ، هي خاصية الفصل بين العلامات والأشياء ؛ فالكلام بالوظيفة المرجعية ينقل للكون – بحسب تعبير غوستاف غيُّوم – تلك العلامات التي جعلتها الوظيفة الرمزية في ميلادها غائبة عن الأشياء ؛ فكل خطاب مرتبط بدرجة ما بالعالم الواقعي الذي يقع تحت سلطته خطاب النص بذواته وأحداثه وسيروته . وعلى ذلك فإن هذا البحث سيكون محوره الخطاب وسلطته داخل منظومة النص من خلال التأويلات المتعددة للسانيات الخطاب باتباع سيميائيات الأهواء وتحليل الخطاب ، وذلك بالتطبيق على المجموعة القصصية المعنونة بـ (عبد الفتاح المنغلق لا يحب التفاصيل) للكاتب العماني سليمان المعمري ، على أن يكون البحث من ثلاثة مباحث هي : الأول : الإنتاجات الرمزية كونها أدوات هيمنة الإنتاجات اللونية للسيميائيات في الثقافة الحديثة مكانة مميزة من حيث أنها تشكل أهمية كبرى في المشهد الفكري المعاصر ، فهي نشاط معرفي خاص بأصوله وامتداداته ومردوديته وأساليبه التخيلية ؛ فهي علم يستمد أصوله ومبادئه من مجموعة كبيرة من الحقول المعرفية كاللسانيات والفلسفة والمنطق والتحليل النفسي والأنثروبولوجيا ، وعلى ذلك فإنها تعتبر أداة لقراءة كل مظاهر السلوك الإنساني بدءاً من الانفعالات البسيطة ومروراً بالطقوس الاجتماعية وانتهاء بالأنساق الإيديولوجية الكبرى . ومن بين ما تهتم به السيميائيات (الألوان) كونها تشكل حيزاً مهماً في حياة الإنسان ؛ فهي علامات لها دلالاتها وتأويلاتها ، ولذلك فإن النصوص عامة والنصوص الأدبية خاصة اهتمت بهذه العلامات ، بوصفها عنصر من عناصر التشكيل السيميائي للنص أولاً وعنصر من عناصر التشكيل الجمالي ثانياً ؛ فالألوان تشكل مادة خصبة لبناء النص ومادة خصبة لفهم النص وتحليله وتأويله ؛ فهي إحساس يؤثر في العين ويعكس إحالات نفسية مهمة . إن الألوان بوصفها تغييرات في الشدة الضوئية الخاصة بالمواقع فإنها "تولد القيم بالمعنى التصويري (Pictural) للكلمة " ، ولذلك فإن الموقع الضوئي يرتئي منطقة فضاء معينة تجعل منه دالاً على مجموعة من الدلالات الخاصة بسياقات نصية معينة ؛ فنص (الأبيض والأسود) يطالعنا منذ عنوانه بوهج الألوان وهيمنتها على الخطاب ، إذ يقدم لنا إنتاجاً لونياً خاصاً متجانساً مع الجسد الذاتي من ناحية ، ومع الدلالات الموسوعية من ناحية أخرى ؛ فـ : " عندما رأى عبد الفتاح المنغلق فتاته ترفل في الأسود ، لم يفكر قط أن ابتسامتها بيضاء .. فكر فقط في قتل معلمه في الابتدائية الذي أدخل في رأسه أن الأسود لون شرير .. دار في خلده وهو يتأمل بياض عينيها أن علاقته بالأبيض لم تكن سيئة قبل اضطراره اليومي للذهاب إلى مقر عمله أبيض بكثير من السوء .ألهذا إذاً بات لا يشرب الحليب إلاَّ إذا مزَّق بياضه الشايُ؟!.. الأبيض بالإكراه ليس سوى أسود ، تمتم في سِّره لئلا تسمعه جدران مكتبه البيض". فالذات هنا رائية للسواد والبياض متلقية للون (الموضوع) المتمثل في علامات عدة ضمن سياقات مختلفة ، ويمكننا هذا النص من إيجاد تلك الهوة التي تجعل من التأويلات الخاصة باللون متضاربة بحيث تبدو متناقضة تماماً ، وهو أمر قد يعكس تلك المسافة بين الداخل (اللون) والخارج (الذات الرائية) ؛ إذ يقدم لنا النص اللون الأسود بوصفه علامة متجسداً في اللباس وهي المادة التي تحوِّل اللون من موضوع إلى علامة ذات تأويل مباشر تماماً يقدمه لنا النص صراحة في "... تذكَّر فتاته وهي تبرر سوادها في لقاء الأمس، وهو التبرير الذي يتلخص في أن رجلاً من أهلها مات في ازدحام شديد...". هو إذن تأويل مباشر يقدمه النص ليكشف عن قيمة العلامة (اللون + الجسد) في الانتماء المزدوج بين نظام الموضوع (اللون)، ونظام الذات (الجسد) ، ليصبح الجسد متمظهراً باللون كونه علامة تم التوافق على دلالاتها مسبقاً . فالنص يُنتج بذلك هيمنة فعلية على المتلقي في إسقاط ذلك التأويل على النص صراحة ، فيقدم تأويله الموسوعي خشية تأويل مفاجئ من قِبل المتلقي . هذه الهيمنة التي يحاول النص إسقاطها على المتلقي حيال اللون الأسود (الموضوع والعلامة) ، هي نفسها يطالعنا بها في تصوره للون الأبيض (الموضوع) بوصفه مقابلاً للون الأسود (الموضوع) ، ليجعله ضمن تمظهرات ذاتية ومادية تكشف عن علامات خاصة به ؛ وإذا ما تتبعنا هذه العلامات فإننا سنجد أنها تأخذ إنتاجات عدة : أولاً : الأبيض + الأسنان = ابتسامة ثانياً : الأبيض + العين = جمال ثالثاً: الأبيض + اللباس = سوء رابعاً : الأبيض (الحليب) + الأسود ( الشاي) = شراب مستحب إن هذه الإنتاجات التي يقدمها لنا النص تجعل من (اللون / الموضوع) ليس خالصاً كما يراه الرائي ؛ هو مرة يجعله ذا تأويلات مرتبطة باللكسيم (الأسنان ، أو العين) ، وهذا الارتباط إنما يعكس موسوعياً حالة من حالة التمظهر الجمالي ، بينما يكون خلاف ذلك عندما يرتبط باللكسيم (الجسد) ، ليقرر أنه لابد في تمظهرات مادية أخرى تبديد بياض (الموضوع) الحليب (العلامة) بموضوع مقابل له هو (السواد) . ليقرر النص في النهاية أن (الأبيض بالإكراه ليس سوى أسود) ، وهو تمظهر لا يكون في الحالات الأولى التي تنتج موسوعياً (الابتسام ، أو الجمال) ، وإنما في حالات قد تنتج سوءاً كما يعتقد الرائي ، وهنا ينفتح النص على تلك العلاقة التي تربط ما بين السيميم (البياض بوصفه كائناً) وبين الفضاء الذي يحيط بالذات التي تنتج تلك العلامات المتمظهرة في البياض الفضائي الذي يحيط به فيقرر أن يتمتم (في سره لئلا تسمعه جدران مكتبه البيض). هكذا سيجتمع اللونان (الموضوع) الأسود والأبيض في النتيجة والدلالة التي تحيل إلى حالة نفسية للذات الرائية ؛ إذ يكوِّنان معاً فضاءً حيوياً من الناحية العاطفية ففي قول المعمري : "... (سندريلا مان) عنوان مخيب لآمال عبد الفتاح الذي كان يفضل فلماً بالأبيض والأسود ، لكنه علل نفسه بأنه ربما يكون فيلماً مناسباً للمرحلة ..." ، وعليه فإن اللون (الموضوع) هنا لن تكون له دلالة في ذاته بل بما يحيل إليه من نوعية مادة تكون بصرياً باللونين (الأسود والأبيض) ، فهما ليسا سلطة مطلقة من الناحية الدلالية وإنما من الناحية البصرية المحضة . ثم يطالعنا اللونان بشكل فضائي بحت ؛ حيث يشكل أحدهما لوناً للفراغ بينما يشكل الآخر لوناً للكسيم (الأسنان) ؛ فـ :"... في منتصف الفيلم أظلمت الشاشة إيذاناً باستراحة قصيرة .. نظر عبد الفتاح إلى فَتاته فانذهل حين رأى أسنانها البيض .. خطر بباله أن المكان أسود وأن ضحكتها هي الأبيض الوحيد ، كأنها نجمة يتيمة في ليل بهيم ..." ، نجد أن الأسود (الموضوع) سيمثل لوناً للفضاء الخارجي الذي يجمع الذات والآخر والمحيط المكاني حولهما ، ليشكل البياض (الموضوع) لوناً لأسنان الفتاة المحبوبة يحيل إلى ظلمة المكان في الفراغ الخارجي ، ليصوره بأنه (نجمة يتيمة في ليل بهيم) وهي صورة أخرى للبياض والسواد في تصوير الفضاء واللكسيم ، على أنه ليس بالضرورة أن تكون (النجمة) ذات لون أبيض ! إنما هو انعكاس للبريق. إن خطاب البياض والسواد بوصفهما موضوعان لا يسيطر على الذوات فحسب بل وعلى الفضاء الزماني والمكاني في النص ففي قوله : "... امتعض عبد الفتاح وغادر المكان بسرعة سنجاب مذعور ، تاركاً فَتاته ترفل في الأسود .. وفُتاته أيضاً "، الذي يمثل الخطاب الأخير في النص ، سنجد أن فلسفة السواد والبياض في فضاء حياة الذات (عبد الفتاح) تسيطر عليه نفسياً حتى ليبدو المشهد مفعماً بهما معاً ليكون الفضاء الأخير (سواد) متمثل في لباس الفتاة المحبوبة ، و(بياض) متمثل في فُتات الفُشار. إنهما جزء من الذات أحدهما معنوي والآخر مادي لكنه تخلى عنهما معاً على الرغم من سطوتهما عليه منذ بداية النص ! بينما يطالعنا نص (حرية شخصية) بثلاثية لونية ستهيمن على الخطاب ، وستشكل الذات شخصية المبئِّر الذي يرصد بؤرة الفضاء النصي الذي يحوي العلامات اللونية ففي :" لا يهمني أن ينظر إليَّ بتلك العينين الشريرتين .. التحديق في الزرقة الأخاذة حرية شخصية ، ثم إنه حتى الأعمى سيلاحظ بلا شك أنها هي التي تحدِّق في شاربي . هي : زرقة مؤطرة بالسواد الضروري لحراسة البياض من الرماديين . هو : عينان من شرٍّ ترشقان المشهد بعناصر الخراب . أنا : تيه ممزَّقٌ بين زُرقتها وصُفرته . تيه يُسمونه : عبد الفتاح المنغلق !" الخطاب هنا يجعل من الأسود بوصفه علامة مظهراً بصرياً خارجياً ، بينما البياض مظهراً غير مرئي بصرياً ، ويجعل من (الرمادي) علامة هائمة غير مؤطرة ، ثم إنه سيجعل من الصفرة بوصفها نظير إشاري مؤول من (شرر العينين) . تسيطر هنا الفاعلية الحسية الإبلاغية على خطاب التجلي التي تتعلق بتوترية مقام ذات الإدراك الحسي ، فالصدع الشعوري الذي يصوره المبئِّر في هذا الخطاب إنما هو محاولة لتجسيد العلامات اللونية وإسقاط التوترية التي تكشف عن نشاط حسي ذاتي تحكمه الحسية والذوق في التلقي . إن النقل الشعوري الذي يقدمه المبئِّر في هذا النص إنما يعبر عن توتر شعوري محض ولا يفترض هذا النقل تفعيل تلك العلامات اللونية إلاَّ لزيادة حدة التوتر الذي يؤثر لاحقاً على السلوك وبالتالي الحدث . إننا إذن أمام مدى (التقبلية الذاتية) الفاعلة التي سـ"تشارك في انبثاق بنى القوى الفاعلة ..." ، التي ستسيطر خلال لونيتها على خطاب النص وبالتالي على الذات المبئِّرة ، فالشعور الذي سيحيله السواد والزرقة في نفس المبئِّر سيحيل الذات (المرأة) إلى موضوع ، وبالتالي سيصبح الإدراك الحسي الجمالي هنا ذا ثلاثة أبعاد تركيبية هي : أولاً : الإدراك الحسي الانعكاسي ؛ الذي يتمثل في تلك العلاقة التي تربط بين الذات (المرأة) وجسدها المتمثل في التأطير (الأسود) واللكسيم (الزرقة) . ثانياً : الإدراك الحسي المتعدي ؛ الذي يتمثل في العلاقة التي تربط بين الذات والموضوع اللوني عامة . ثالثاً : الإدراك الحسي التبادلي ؛ وهو الذي سيوطد العلاقة بين الذات من ناحية والمبئِّر من ناحية مقابلة . فالمبئِّر هنا يعمد إلى وصف الذات بقوله : إن "... هذه المرأة الوارفة الزُرقة ، المسيجة بالسواد ، وحيدةُ كبحر هجره المصطافون ، وما الابتسامة سوى حيلة للتملص من الهواء المثقل برائحة العزلة . ربما كانت عاشقة ، وهذا ما يفسر نظرتها التائهة . لكنها العزلة . أيكون حبيبها من التقط الصورة ؟!...". إذن هي محاولة منه للوصول إلى حالة من الإدراك الحسي التبادلي بعد أن فصَّل محاولته لإدراك تلك المستويات من الأبعاد التركيبية التي تربط اللون (الموضوع) بـ (الذات) . إن النقل الشعوري الذي يتقنه المبئِّر هنا يعتمد على تبدلات علاقات القوى المؤثرة في جسد ذات الإدراك ضمن الفضاء التوتري العام الذي يُغمس فيه نفسه ، فالمستوى التوتري الذي سيعتمد عليه مؤلف من إدراكات حسية لفهم مستوى التعبير ضمن تماسك التعبير والمضمون أو تناقضهما أو تفرقهما ، لنجده يعبِّر عن ذلك بقوله: "... وصاحب العينين الشريرتين يحاول اقتناصي . أيكون حبيبها ؟! . لا أظن ذلك ، وجهه يوحي بأنه خارج للتو من سجن في كهف ، ولا زرقة في الكهوف . لعل مأمور السجن هو من التقط الصورة كإجراء روتيني قبل الإفراج . ولكن ما الذي يجمع صورتين متناقضتين في صحيفة صفراء واحدة ، وفي مكانين متجاورين؟!...". إنه رهان على لون (الزرقة) الذي يعتمد عليه للتخلص من التوترية الحسية التي تسيطر عليه ضمن خطاب بصري فضائي ، ليساعده على إقامة توازن حسي بين الذوات . إنه إذن فضاء توتري على مستوٍ عالٍ إذ تسيطر العلامات اللونية سيطرة كاملة على الذات المبئِّرة ضمن فضاءات متعددة ، ستجعل من تلك العلامات توترات أولية ، متولدة بشكل قصدي نحو المبئِّر الذي سوف يكون متبوعاً لا تابعاً لها ، هي توترات مؤسسة عاطفياً بحيث ينشغل بها المبئِّر بوصفها إدراكات حسية ثم تنتقل إلى شكلها المهيمن على الاتساق الخطابي ليس للنص الفضائي فحسب بل حتى لنص (الحلم) ففي:"... يا إلهي . إنها بلاد تحترف الشتم بالعيون . ولكني لن أعتذر . سأكتفي بمغادرة المقهى وترك الصحيفة مكانها . أن أرى امرأة زرقاء ورجلاً شريراً في صحيفة ، ثم في مقهى ، ثم في أحلامي – إن شئتُ – هي محض حرية شخصية"، وفي نهاية هذا الخطاب التوتري سنجد أنه يتحد مع الذات المبئِّرة ليشكل معيار قيمة ضمن هذه المبادلات المهينة بينه وبين تلك العلامات اللونية . الإنتاجات الحركية للحركة في خطاب هذا النص هيمنة رمزية من حيث أنها تسيطر على فعل الخطاب وبالتالي على الذات الفاعلة التي تجعل من الفعل حالة من حالات التجلي الخطابية ؛ ففي نص (عطْس) نجد أن الفعل (عَطَس) يهيمن على الخطاب من ناحية وعلى الذات من ناحية أخرى ليتشكل من الفعل (كون خطابي) يدور فيه وضمنه ، لتنشطر الذات إلى ذات فعلية وذات حالة مصطنعة ؛ فـ" عندما أصاب عبد الفتاح المنغلق نزلة زكام حادة حمد الله أن لم يخلقه دجاجة . ولأن عبد الفتاح انتهازي كبير فقد قرر أن يستغل زكامه الاستغلال الأمثل . أولاً ؛ ذهب إلى مديره وعطس في وجهه ، فقرر الأخير منحه إجازة لمدة أسبوع . وهو يخرج من المكتب فكَّر أن اللحظة المناسبة قد حانت لمصالحة حبيبته التي هجرته منذ أسبوع لنسيانه عيد ميلادها ، فقد سمعها ذات مرة تقول ؛ إن الرجال حين يمرضون يثيرون الشفقة...". في هذا الخطاب يسيطر الفعل رمزياً على سياق التكييفات الدلالية للفعل (عطس) ليصبح عبارة عن كتلة انفعالية تتلقى تحولات سياقية وحركية ؛ إذ يتحكم فعل الحركة ليس فقط على الذات الفاعلة بل حتى على الذوات المتواصلة معها سردياً ، وفي سبيل الوصول إلى حالة من التعايش والتعاضد مع هذا الفعل تلجأ الذات إلى إسقاط تمثيل عاملي وكيفي مركَّب يسعى إلى إكساب فعل الحركة هيمنة أوسع وأكثر شمولية . وهذه المحاولات لن تقف عند حد الآخر ضمن الإطار المجتمعي القريب (مدير العمل ، المحبوبة) بل سيتسع بعد ذلك ليشمل الفضاء الأوسع للأفق (الشارع) ؛ فهذه الحركة سوف تسيطر على الذات الفاعلة لا واعياً ضمن متغيرات السياق وتطورات الحركة " ... فقد كان يفصله عن الاصطدام بالسيارة التي أمامه عطسة صغيرة . فكر عبد الفتاح وهو ينظر إلى سائق السيارة المصدومة يشوِّح بيديه بطريقة غاضبة من خلف زجاج النافذة أن العين بحاجة إلى مراس لكيلا تنغلق أثناء العطس..." . إن الفعل الحركى هنا يمثل تفاعلاً عاملياً بحيث يُوجد تواصلاً ليس بين الذوات فحسب بل بينه وبين أعضاء الجسد ، ولنقل تجاوزاً بينه وبين نفسه ، فالحركة التي تنشأ من فعل (العطس) هي حركة تتبعها حركة أخرى مقابلة ، ولذلك فإن الذات هنا ستنشغل بفعل الحركة بحكم تلك الهيمنة الفكرية والنفسية ؛ فقد "... قرأ المنغلق في إحدى الصحف أن العين هي العضو الوحيد في جسم الإنسان الذي لا يمكن أن يبقى مفتوحاً أثناء العطس..." ، ليشكل هنا الفعل امتداداً كيفياً للحركة ، وهو محاولة للربط بين إرادة الفعل والقدرة على فعله ؛ فـ " ... منذ ذلك اليوم وعبد الفتاح لم ييأس بعدُ من أنه قادر على إثبات العكس ...". ولأن الخطاب يصف الحركة بأنها (طريقة في الفعل) ، فإن إرادة القيام به تشتمل على فائض كيفي يبدو في السطح على شكل تكثييف فعلي للحركة ضمن اللاواعي ، وهي بذلك طريقة في الكينونة (مكثف + بدئي) ، تستند لا واعياً على الربط بين الإرادة والقدرة ؛ فـ " ... عندما واتته العطسة حمد الله وأثنى عليه ... لكنه سرعان ما وبخ نفسه لأنه نسي فأغمض عينيه . (في المرة المقبلة لن أنسى) ..." ، لينتج عن ذلك تكييفات تتمحور ضمن استحالة الفعل وهي : أولاً: معرفة عدم الكينونة ؛ يتحقق عندما تعرف الذات بأنها منفصلة عن موضوع القدرة . ثانياً: عدم القدرة على الكينونة ؛ عندما يكون النجاح فعل الوصول إلى التوازن بين حركة (عطس) وحركة (اغماض العين) مشكوك فيه . ثالثاً: إرداة الكينونة ؛ عندما تصر الذات على تحقيق ذلك التوازن بين أفعال الحركة . وهكذا سيتحوَّل هذا التكثييف في الكينونة إلى هاجس توتري لدى الذات ؛ إذ "... حلم أنه يعطس كثيراً بعينين مفتوحتين على العالم وجميع أشيائه الحية والميتة ..." ، وعليه فإن توقع ظهور متزامن ومتعاضد للإرادة والقدرة لا يمكن أن يتم إلاَّ عبر فعل الحركة (عطس) الذي هيمن على سياق الخطاب وتكثيفه .
__________________
ديواني المقروء |
|
#3
|
||||
|
||||
|
تابع عائشة الدرمكية:
الثاني : الموضوعات والتواصل بين الذوات إذا كان "الكاتب بتصويره لموضوع أو حدث أو شخصية ، لا يفرض أطروحة بل يحث القارئ على صياغتها فحسب..." ، بحيث يحفظ للقارئ حريته وفي الآن ذاته يحثه على أن يصير أكثر فاعلية ، فإنه بواسطة استعمال إيحائي للكلمات ، واستعانة بالحكاية والحدث والعقدة يُحدث العمل الأدبي ارتجاجاً للمعنى ، ويُحرك المتلقي للتأويل الرمزي ، ويوقظ قدرته على التداعي ؛ فالنص هنا يطلق العنان لمخيلة المتلقي، ليبتكر صوراً لعوالم أخرى ، لا نجد لها وجوداً إلاَّ في اللغة ، كتمظهر للمخيال وللعقل البشري ، الذي ما فتئ يخترع صوره الخيالية ، بـ"استعارة عناصر واقعية للتعبير عن الواقع ، وهو بصدد علمنة دراسة الخيال" . إنها إذن تلك العلاقة التي تربط بين النص وقارئه لتشكل علاقة تواصلية تحتكم على قدرته على حلِّ التشفير للعلامات التي يتلقاها ضمن خطاب النص . وعلى أن التشفير لخطاب النص سيقع من جانب القارئ وقعاً ذاتياً أي مستنداً على موسوعته الثقافية والمجتمعية ، وهذه الذاتية لا تبلغ ذاتها إلاَّ ضمن الحد الذي يجعل من ذلك الخطاب مفهموماً فهماً سطحياً أو عميقاً – يعود ذلك إلى موسوعة القارئ ومرجعيته – ، ومتى ما كان الخيال بعداً أصلياً من مرجعية النص ، فإنه لا يقل عن كونه بعداً أصلياً في ذاتية القارئ أيضاً ؛ وعليه فـ "باعتباري قارئاً ، فإني لن أعثر على نفسي إلاَّ بتيهي . تدخلني القراءة في تغيرات الأنا ، الواسعة الخيال . وتبعاً للعبة يكون تحول العالم هو التحول اللعبي للأنا أيضاً" . ففي الخطاب الذي نحن بصدد الحديث عنه سنجد أنه خطاب داخلي وخارجي حامل لآثار معنوية بالغة الخصوصية ؛ إذ يكون الخطاب هنا ذا ازدواجية تواصلية بين الذات وخطابها من ناحية والذات والآخر (القارئ) من ناحية أخرى ، بحيث يتم التكييف السردي بناء على فهم افتراضي جزئي على الأقل ، فلو تأملنا نص (أقول وقد ماتت بقلبي حمامة) سنجد أنه يتخذ أشكالاً خطابية ذات بعدين ؛ إذ يبدأ النص بخطابه قائلاً : " أنا واثق أنكم لستم بحاجة لمن يسرد لكم حكاية تافهة عن حمامة ميتة ، لأن هذا أمر عادي . بل إن بعضكم قد يكون خارجاً الآن من مطعم فاخر بعد أن التهم وجبة حمام مشوي دسمة دون أن يرِّف له جفن أو يخطر بباله سؤال بسيط من قبيل : من أين جاء الحمام هذا كله؟..." ، فهو إذن خطاب قائم على التأثيرية المباشرة على القارئ خلال تكييف تلفظي منتظم ، بهدف إنتاج بنيات كيفية مستترة ، تصدر تنويعات نفسية بهدف الهيمنة القصدية على القارئ . ليس ذلك فحسب بل إن الخطاب هنا سيلجأ إلى تمفصل شعوري ذاتي في شكل إحساس خالص ، شبيه " بمحاولة الإمساك بالدرجة الصفر للحيوي (الظاهر) الأدنى (للكينونة) ..." ،وهكذا سينتقل الخطاب إلى الذات في محاولة استمالة نفسية الآخر (القارئ) في : " ... حسناً . أنتم لستم بحاجة ، ولكني جدُّ محتاج لأسرد حكايتي قبل أن يتفاقم هذا الانهيار الذي أحسه يزلزل روحي من الداخل ..." ، وهكذا سينتقل الخطاب في أفق تأثيري واسع بين الذات والآخر في حالات من الدهشة والذهور ، بحيث يصبح الآخر (القارئ) أكثر طواعية في الإنصات والاندماج ضمن سياق النص. سيحدثنا الخطاب في هذا النص عن واقعة تأثيرية حدثت للذات ضمن سياقات توترية لا واعية يقول : "... قبل عدة سنوات من الآن صببتُ جام غضبي على أولئك الذين يتلذذون بذبح العصافير ،ولم يدر في خلدي ساعتئذ أنه سيأتي عليَّ يوم أهرس فيه حمامة . نعم . هذا هو التعبير الدقيق . هرستها . ليس بيدي ، ولا برجلي . بل بعجلة السيارة ! موفِّراً لهذه المسكينة ميتة أشنع وأسرع ، تليق بالقرن الحادي والعشرين!". يتضاعف هنا توتر وتأثر الذات في الخلط بين القصدية التي يمكن أن تكون إرادة أولية أو معرفة مسبقة ، وما بين النفي لأحد الافتراضين والإثبات للآخر فإن الذات تسعى لإفراغ حمولتها النفسية خلال محاولة التكييف مع الحالة التوترية والتأثرية المتجهة نحو الآخر (القارئ). ينفتح التوتر والتأثر في خطاب النص نحو الانفتاح على مستوى التواصل بين الذات والآخر ، وسنجده يعقد محاورة مباشرة بينهما في :" ... سأخبركم فقط عن وعيي . أنا لم أشأ أن أقتلها . قسماً برب الحمام والعصافير لم أشأ ذلك . من أراد فليصدقني، ومن لم يُرد فليصدقني أيضاً لأنني في هذه اللحظة بالذات أشعر بأنني أصدق من على وجه البسيطة . أنا أعرف مثلاً أن الإنسان يحتاج دائماً إلى من يخبره بأن فعلته ليست شائنة ، وأنهم لو كانوا مكانه لفعلوا الأمر ذاته ،ولكن صدقوني أنا لا أسرد لكم هذه الحكاية لهذا السبب .. ماذا؟! كأني أسمع أحدكم يزعق بي من بعيد : (تباً أيُّها السفاح ، لقد قتلت أفقر شاعر في الأرض ؛ الحمامة) . فلتقسُ عليَّ أيها الزاعق لأني أستحق أكثر من هذا ...". إن الخطاب المنفتح هذا سيكشف عن انغلاقه الأخلاقي المخيب للأمل من قِبل (القارئ) ، وعن جماليات التلاشي التي ستدفع بالذات نحو تقديم خطاباً محايثاً مقابل لذلك الإنغلاق في محاولة للهيمنة التأثرية من خلال تقديم مجموعة من الانشطارات الخطابية وهي : أولاً : العلاقة التي تربط الذات بـ (الحمام) في الفضاء العام ؛ "... وخاصة إذا عرفت أن علاقتي بالحمام لم تكن سيئة على الإطلاق...". ثانياً:العلاقة التأثيرية التي تربط الذات بـ (الحمام) في فضاء الشارع ؛ "... حدث كثيراً فيما مضى أن اعترض طريقي سرب حمام أو عصافير ، وكنتُ أتعمد ألاَّ أخفض سرعة السيارة لثقتي التامة أن هذا السرب سيطير في اللحظة الأخيرة قبل أن أصدمه..." . ثالثاً: الحالة المزاجية للذات ؛ "... غير أن المدهش في هذه الحكاية كلها أن هذا الصباح بالذات لم يكن مناسباً بالمرة لدهس حمامة. فأنا أولاً كنت بكامل نشاطي وتفتحي الذهني بعد أن تحصلت على سبع ساعات نوم كاملة لم أوتها منذ فترة طويلة ..." رابعاً:الفضاء الذي تم اختياره لواقعة التوتر ؛ "... ثم إنني لم أكن أقود سيارتي في الشارع السريع الذي لا يتيح لي تفادي المفاجآت . بل إن السيارة كانت تمشي وكأنها لا تمشي في الزقاق القريب من بيتنا ..." خامساً :قدرة الآخر على الانفلات من الواقعة ؛ "... لم تكن تعرج في مشيتها لأستنتج أن عطباً ما أصاب جناحيها ..." كل تلك الانشطارات التبريرية الواعية تحاول إسقاط هيمنة واضحة على القارئ ضمن سلسلة من التكرارات ، التي ستنتج إنصهاراً تبتعد الذات بعدها نحو الخطاب النصي البحت ، الذي يتوجه نحو الداخل لمحاولة لكسب امتلاء توترتي يصعِّد التوتر إلى حالاته القصوى ليكون الخطاب بين الذات ونفسها في حالة من التجلي القصوى ؛ يتضح ذلك من خلال النص في مثل :"... عندما اقتربت منها كثيراً بحيث أصبحت في منتصف المسافة بين الإطارين الأماميين لم أرَ شيئاً يحلق في الفضاء كما كنتُ أتوقع . لماذا لم تطر؟! هل كانت تنوي الانتحار؟! هل كانت تتحداني ؟! هل تجرؤ؟! لا أحد يستطيع أن يحزر ما يمكن أن تفكر فيه حمامةٌ ذاهبةٌ للموت في الصباح الباكر " وهكذا سيسرد لنا الخطاب تلك السيرورة العرضية للواقعة الخطابية حتى يوصلنا إلى حالة من الاستقرار المؤقت لكل تلك الانشطارات لتقرر الذات واعية (أنا متأكد إنني دهستها...) ، لكن ذلك الاستقرار لن يدوم طويلاً إذ تبدأ حالة توترية يسقطها الخطاب ويدفعها نحو الآخر ؛ " ... ولكن لا أدري أية فكرة جهنمية هذه التي واتتها وهي في النزع الأخير كي تمنعني من رؤيتها تموت". وللوصول إلى موضوعات الخطاب التي يقوم عليها النص فإنه يرسم مساراً معقداً ، يلقى في طريقه عوائق عليه تحملها ، و"يلقى اختيارات يستحسن أن يوظفها . ولكي نعطي فكرة أولى عن هذا المسار ، يمكن الاعتبار بأنه يقود من المحائثة إلى التمظهر في ثلاث مراحل أساسية : - البينيات العميقة : التي تحدد كيفية الوجود الأساسية للموضوعات السيميائية ، فكما نعرف فإن المكونات الدنيا للبنيات العميقة لها هيئة منطقية قابلة للتحديد . - البنيات السطحية : وتشكل نحواً سيميائياً ينظم في شكل خطابي المحتويات القادرة على التمظهر . منتوجات هذا النحو مستقلة عن التعبير الذي يمظهرها ، بما أنها تستطيع نظرياً أن تظهر من خلال أي مادة ، وفيما يخص الموضوعات اللسانية فإنها تظهر من خلال أي لغة . - بنيات التمظهر : تنتج وتنظم الدوال ، مع أنها تستطيع أن تشتمل على شبه كليات ، فإنها تبقى خاصة بهذه اللغة أو تلك (أو بصورة أدق ، إنها تحدد خصوصيات اللغات) ، وبهذه المادة أو تلك ." تتضح تلك التمظهرات في موضوعات التواصل الذاتي والبينذاتي التي تظهر في نص (المنبه) ، الذي يكون فيه (المنبه) لكسيماً أساسياً في إحداث العلاقات التي تشكل الخطاب ؛ ففعل الخطاب هنا ليس مجرد لحظة منفلتة أو زائلة ، بل هو فعل متكرر بموضوعات متعددة ، ليصبح (الخطاب) - بوصفه واقعة - صياغة على نحو أكثر جدلية من ناحية العلاقة التي تشكل الخطاب بذاته ، وهي العلاقة بين الواقعة والمعنى ، ففي :"قبل أن ينام تأكد أن المنبه مضبوط على السادسة . يدرك عبد الفتاح المنغلق أن وضع الرأس على الوسادة في حالة إنهاك شديد لا يمنع إطلاقاً حضور صورة المدير العام ..." ، يظهر الخطاب بوصفه واقعة ، ويُفهم بوصفه معنى ، أي المحتوى الخبري الذي يريد الخطاب إيصاله قصداً ، وحاصل هذا التأليف أن تتشكل وظيفتان للخطاب ؛ هما تحقيق هُوية الخطاب وإسناده ، فـ "ليست الواقعة من حيث هي زائلة ما نريد أن نفهمه بل معناها " ، وهي وقائع قائمة على (الأحلام) وهي كما يعبر النص " مفتوحة على جميع الاحتمالات" وعليه فإن الخطاب هنا يتوجه في إسناد واضح نحو ما يطلق عليه ريكور (قضية أولية أخلاقية واجبية) ، معنى ذلك أن سلطة اللكسيم (المنبه) إنما نابعة من كينونته النفسية لدى الذات (عبد الفتاح) ، وهي كينونة تعكس فلسفة أخلاقية تلامس الكلية (الكونية) ، ولذلك فإن " الإلزام الأخلاقي الواجبي ليس بدوره من دون صلات تجمعه مع استهداف الحياة الجيدة الخيرة " ، إذ يربط ذلك اللكسيم الذات بالعالم الكوني حوله حيث يربطه بمكان عمله بواسطة عتبة مهمة هي (المدير العام) ؛ فالخطاب الذي يؤسسه النص في تلك العلاقة خطاب قائم على التوترية والقلق ، ففي " قال المدير العام : سأقتلك بهذه الحربة أيها المتسيب . صرخ عبد الفتاح مفزوعاً وهبَّ واقفاً على الفور . تأكد أن المنبه مضبوط على السادسة ..." ، فالتخطيب الذي يعتمده النص هنا هو التجسيد الفعلي لاستحضار الواقعة مستعين بالأبعاد التاريخية والثقافية للذات باعتبارها أوليات في تقابلها مع الكونيات التي تشكل سجلاً لبنيات قابلة للتعميم ضمن سياق العلاقة بين الموظف ورئيسه . وتلك الأبعاد هي التي ستأخذ الذات إلى منصة الحكم ضمن بؤرة التدخل المستمر بين البنيات المستحضرة والبنيات القابلة للإدماج في تلك النوبات الحُلمية التي تؤسس خطاب هذا النص ، ولنسمعه يقول :"... أنا بشر يا سيادة القاضي ، وليس عدلاً أن أؤخذ بجريرة آلة غبية..." ، مما سيؤثر في تأطير الإدراك الحسي وتعزيزه بالتوترية ، فيحدث نفسه رغم ابتسامة القاضي بأن "... هذه ابتسامة جزار على وشك أو يذبح نعجته ، فقرر أن يستيقظ ليتأكد أنه ضبط المنبه...". بفعل هذا الإدراك الحسي نشأت تلك العلاقة التوترية بين الذات و(المنبه) ، وسيظل هذا التوتر على الرغم من أن الانفعال سينقل الذات من فضاء توتري إلى آخر أقل توترية في تجلي الانفعال نحو موضوع جديد هو تلك العلاقة التي تربط الذات بالآخر (الأم) . ولأن (الأم) هنا لا تشكل ذاتاً توترية بالنسبة للذات بل هي حالة من حالات الاطمئنان النفسي التي ربما أرادتها الذات بشكل غير واع في فضاء هذه التوترات ، إلاَّ أن الخطاب التوتري سيهيمن على تلك العلاقة ليسمعها تقول : " أريدك أن تتزوج يا بني . قلبي يحدثني أن المنبه غير مضبوط .ولأنه يطمع في الجنة التي تحت قدميها فقد قام وتأكد أن المنبه مضبوطاً ...". إن ما تمر به الذات في هذا النص إنما هي ارتجاجات متواصلة تظهر في متغيرات ، وتتداخل ضمن إجراءات تتغير كثافتها بتغير الآخر الذي تتواصل معه الذات ضمن اللكسيم (المنبه) ، لنجده الآن ضمن متغير جديد وذات جديدة هي (الحبيبة) ، ليدخل ضمن فضاء (الحلم) ليرى " أن عيني حبيبته جميلتان ، وكذلك شفتيها ، وهي تقول : إنها لا تحب الكسالى وأن لديها ساعة بيولوجية مضبوطة . كان يقود السيارة بسرعة فيما يتأمل العدسات اللاصقة ..(انتبه حبيبي) . يعلم عبد الفتاح المنغلق أنه لكي ينتبه المرء لابد أن يكون المنبه مضبوطاً ...".ليشكل ذلك تحديداً معرفياً لمدى التوترية التي يركزها الخطاب في الذات ، فهي حالة من حالات ارتجاج التوتر وتركيزه واتساعه في أفق كوني أرحب متمثل في (الشارع) والأفق المحيط به ، ليجعل من هذا الأفق موضوعاً للتوتر بالعودة إلى اللكسيم (المنبه) ، فالخطاب يربط بين (الانتباه) ، و(المنبه) من حيث أنهما وهج التوتر لدى الذات. وهكذا سيتحول الخطاب فجأة وبدون مقدمات من وهجه التوتري إلى عمق التكييفات التي تُخرج الذات من حالة التوتر إلى حالة الاطمئنان ، وهذه الحالة لن تكون إلاَّ ضمن سياق يشكل بؤرة تلك التوترات وهذه التكييفات وهو سياق العمل الذي يقرر الخطاب بأنه "... سوف ينال رضا مديره العام الذي لن يكتفي بترقيته ، بل سيستغل علاقاته الأخطبوطية ليظفر له بقطعة أرض سكنية تجارية قرب شاطئ القرم ". وعليه فإن هذا الخطاب سيشكل المتخيل المرسوم في عمق أفق الوجود التخيلي الراهن الذي يمثل أفق التوترات ليشوش على تلك التمظهرات المقلقة ، ويدمر الامتلاءات التوترية ويحوِّلها مكافأة في حالة من حالات الممارسة الافتراضية من قِبل الذات الأخرى (المدير العام). إن سلطة التوتر ستتبع الذات حتى عندما يكون خارجاً بعيداً عن السياق التوتري فـ " في الخامسة والنصف تماماً ارتدت الدشداشة عبد الفتاح المنغلق واعتمره المصر الأخضر ذو الخطوط المزركشة . كانت الساعة وهو يغادر الغرفة السادسة إلاَّ عشر دقائق . فكر عبد الفتاح وهو يدخل من باب المؤسسة أن المنبه سينسى هذه المرة أيضاً " ، فالذات هنا غير قادرة على الانفلات من ربقة اللكسيم ، لتستمر التوترية في دينامية متحركة ومستمرة بحيث تتعالى على محفل الخطاب لتسيطر على الذات ضمن تصاور توتري عميق . الثالث : البرامج السلطوية للخطاب "... إن اللغة في كل لحظة ، تقتضي أمرين متلازمين ؛ نسقا أو نظاماً قاراً ثابتاً ومتطوراً معا" ، ولهذا هي متولدة ناشئة بين هذا النسق وبين تاريخه أي بين ما يوجد عليه الآن وبين ما كان عليه ،وهو ما يشكل المعاني ضمن نسق الخطاب الخاص بكل نص؛ إلاَّ أن لمفهوم (المعنى) تأويلين يعكسان الجدل بين الواقعة والمعنى ؛ إذ يعني (المعنى) ما يعنيه المتكلم ، أي ما يقصد أن يقوله ، وما تعنيه (الجملة) أي ما ينتج عن الاقتران بين وظيفة تحديد الهُوية ووظيفة الإسناد ، (المعنى) إذن "... عبارة عن تعقل صوري وتعقل مضموني خالص معاً ..." ، وبهذا يمكن الربط بين إحالة الخطاب هنا على (الذات) ،ولذلك فإن النظام أو الشفرة يشكل أمراً افتراضياً بالنسبة للآخر . عندما نتحدث عن البرامج السلطوية التي تفرض هيمنتها على خطاب النص فإننا بلا شك سنتحدث عن الأفعال التمريرية التي تميز الوعد عن الأمر ، أو الرغبة أو الإثبات . وقوة هذه الأفعال التمريرية تمثل جدل الواقعة والمعنى ، بحيث تتطابق قواعد معينة مع قصد معين تعبر من أجله الأفعال التمريرية عن قوتها المميزة ، " ... ما يمكن قوله بمصطلحات نفسية كالاعتقاد والطلب والرغبة ، يكسى بوجود دلالي بفضل التطابق بين هذه الوسائل النحوية والفعل التمريري." ، إننا إذن سنبحث عن تلك السلطة التي تمثلها الرغبة الجامحة في تحقيق هدف ما ولا أدل على ذلك من نص (امبااااع) الذي يطالعنا منذ بدايته ضمن برنامج استهوائي صريح يربط بين الكينونة والفعل ليؤلف توليفاً قابلاً للتغير على مستوى الذات ومستوى الفعل ؛ إذ يبدأ النص " ثغت الشاة . سقطت دمعة من عين عبد الفتاح المنغلق على حافة السكين المشحوذة بعناية . قبل عشرين سنة كان عبد الفتاح يحب العيد ، وخاصة حين يطلق مفرقعاته في المصلى بانتظار انتهاء الخطبة . قبل ثلاث سنوات فقط بات المنغلق يتشاءم من العيد .. تحديداً منذ قال له أبوه : فضحتنا قدام الخلق..." هكذا يبدأ النص بعلاقة التوتر التي تربط (الذات) عبد الفتاح ، والفعل (فضح) الذي سوف يكشف عن تجليات مهمة في سياق سلطته على الخطاب ؛ فالذات هنا تتجسد في ذات إجرائية واقعة تحت هيمنة الفعل وسطوته من ناحية ، وهي تعبر عن الموضوع الذي يحيل عليه الفعل ، للوصول عبر مجموعة من التوترات إلى غاية أو أثر ، ليوصلنا ذلك إلى ما يسمى بـ (القيمة) على اعتبار أنها " موضوع يعطي معنى لمشروع حياتي (توجه أكسيولوجي)، وموضوع يستقبل دلالة من خلال الاختلاف في تقابله مع موضوعات أخرى..." وعلى ذلك فإن سطوة هذا الفعل وهيمنته ستظهر في النص سريعاً ؛ ففي ذكر سياقها يقول المعمري :" ...قالها أبوه في ثالث أيام العيد ، عندما كان أهل القرية مجتمعين لتناول وجبة الشواء في سبلة الشيخ سعدون بن خويطر . قال الشيخ لأبي عبد الفتاح  ما شا الله شواكم لذيذ ، باين عليه التيس إللي ذبحه عبد القادر كان كبير) . قال الأب : أنا إللي ذبحت التيس.لم يفهم الأب مغزى تعليق الشيخ إلاَّ حين سمع رد هذا الأخير على طلبه الذي طلبه قبل أسبوع من العيد . أثناء شرب الشاي . وعلى مرأى ومسمع كل من كان في المجلس قال الشيخ : الظاهر ما في نصيب يا بو عبد الفتاح ... أيش فيه ولدي يا شيخ ؟ رد الشيخ بصرامة : إللي فـ حياته ما ذبح هايشة كيف أستأمنه على بنتي؟!...". هذا الخطاب لا يفصح فقط عن الفعل (فضح) بل عن توترات تجسيده وإظهاره على سطح الخطاب ، لينتج في سياقه الخطابي نظيراً مراقب له هو الفعل(ذبح) . ما شا الله شواكم لذيذ ، باين عليه التيس إللي ذبحه عبد القادر كان كبير) . قال الأب : أنا إللي ذبحت التيس.لم يفهم الأب مغزى تعليق الشيخ إلاَّ حين سمع رد هذا الأخير على طلبه الذي طلبه قبل أسبوع من العيد . أثناء شرب الشاي . وعلى مرأى ومسمع كل من كان في المجلس قال الشيخ : الظاهر ما في نصيب يا بو عبد الفتاح ... أيش فيه ولدي يا شيخ ؟ رد الشيخ بصرامة : إللي فـ حياته ما ذبح هايشة كيف أستأمنه على بنتي؟!...". هذا الخطاب لا يفصح فقط عن الفعل (فضح) بل عن توترات تجسيده وإظهاره على سطح الخطاب ، لينتج في سياقه الخطابي نظيراً مراقب له هو الفعل(ذبح) . فهذا الخطاب يكشف عن بنيات سجالية – تعاقدية تربط بين الفعل (ذبح) ، والفعل (فضح) في سجال توتري قابل للتصدع والانشطار يكشف عن سلطة متجاذبة بين (القوة) و(الضعف) الاستهوائيين اللذين يصارعان من / إلى الاستقطابات المجتمعية التي تدفع الآخر (الأب والأم) إلى إحداث توتيرات مقابلة تحت وطأة تلك الاستقطابات فقد " ... اسوَّد وجه والد المنغلق ، واعتزل الناس ستة أشهر بعد تلك (الفضيحة) . وقال لولده بصوت متهدج : قلبي ما راضي عليك لين أشوفك تذبح ، قالت الأم : يا ولدي ما يجوز تغضِّب بأبوك : التيس إللي بتذبحه ما أهم من أبوك ...". إن (الذات) ضمن هذا الخطاب ليست تحت وطأة الفعل فحسب بل إن وطأة تلك الاستقطابات تدفعه خارجاً نحو إنجاز الفعل ، بينما تمنعه تلك التوترات النفسية العاطفية داخلاً نحو الامتناع ؛فـ " عبد الفتاح المنغلق يعي جيداً أن والده أهم من التيس ، المسألة فقط أنه أجبن من أن يذبح دجاجة ! ..." ، وبهذا فإن هذا التجسيد يؤكد الانشطار ويثبته ، لتكون الوظيفة الأولى لتلك العملية التكيفية هي نفي الواجب المجتمعي (الذبح) من خلال الإرادة ، وستتابع الانشطارات حتى نحصل على محور الكيفية الخارجية (المصدر) وهي كيفية خاصة بالذات بوصفها ذاتاً تابعة لتعاليم الواجب - محور الكيفية الداخلية المصدر - ،وهي كيفية خاصة بالذات المستقلة التي يريدها الذات أن تكون . إن لـ (القيمة) في هذا النص سلطة خطابية ظاهرة ؛ إذ إليها تعود كل تلك الانشطارات ، ومنها تنشأ كل التكيفيات التي تحاول الذات إنتاجها من أجل الوصل إلى غاية التكييف معها ، ومع الذوات المجتمعية ؛ ولذلك سنجد أن هذه القيمة تلاقي توترات مع الذات من ناحية ومع النظير القيمي من ناحية أخرى ما بين جذباً و نبذاً ، ولعلنا نلاحظ ذلك ملياً في خطاب النص فـ " قبل ثلاث ليال من العيد الذي تلا عيد الفضيحة قال الأب لابنه : ستذبح. ولما لم يذبح عبد الفتاح تقدم مسعود بن بشير لخطبة ابنة الشيخ ، فكان أن رُفِض... قبل ثلاث ليالٍ من العيد الثاني بعد الفضيحة قال عبد الفتاح : ما أنا بذابح . فكان أن تقدم راشد بن منصور لخطبة العنود ، فتم رفضه ... قبيل هذا العيد ، والذي يأتي ثالثاً بعد الفضيحة قال الأب : إذا لم تذبح فاخرج من بيتي . وقالت العنود : إذا لم تذبح فاخرج من قلبي ...". هكذا إذن تنتهي لعبة الجذب والنبذ ، وتبدأ الكيفية الانتقالية من الحالة السجالية – التعاقدية إلى إفراغ حمولتها جميعاً نحو الذات، لتصبح مثقلة بالانشطارات التوترية ، لتكون – بحسب القيمة – ذاتاً محققة لمعيارية تلك الكيفيات عبر المرور بحالة من العجز فقد " ... بكى عبد الفتاح وارتمى في حضن أمه التي قالت : يا ولدي كل شي في بدايته صعب ألين تتعود ..." ، لتستجمع بعدها الذات أدوارها الكيفية وتحقق القيمة . أما خطاب نص (العزاء) فإنه يطالعنا بمتغيرات وأشكال هيمنة توترية مختلفة ، فهذا النص يعتمد على القيمة السردية ، بحيث يمكننا أن نعتبره كشفاً عن أسلوب سلطوي جديد ؛ إذ يبدأ النص بحالة من التوترية الدنيا ، فيبدو الوهج خافت في :"قبل أن يدخل نظر إلى حذائه نظرة مودع ، ولكنه سرعان ما طرد الهاجس بالتفكير أنه في زحمة كل هذه الأحذية الجميلة لا يمكن أن يكون السارق غبياً ليختار أكثرها تواضعاً " ؛ إذن هو توتر يبدأ منذ بداية النص في محاولة لتوهج الخطاب الداخلي في النص ، والخارجي نحو القارئ. " ... شعر عبد الفتاح المنغلق بالزهو ، وهو بكلمتين فقط أنهض كل من كان جالساً في الجامع . قال في نفسه وهو يمد يده إيذاناً ببدء مهرجان التصافح : (أنا شخصية) . أيادٍ كثيرة كان على عبد الفتاح أن يصافحها..." ، يبدو الفعل هنا فعل خالص ، فهو فعل بامتياز من ناحية هيمنته على الذات الفاعلة ؛ فالفعل (شعر) يُجسد الذات بوصفها موقعاً يحيط بمنطقة فئة فضائية . إن الفضاء هنا باعتباره قيمة يندرج كلية في حس الذات المتؤثرة التي أصبحت ممتلئة شعورياً ، فهي إذن ضمن هذا السياق حس ذاتي يقع تحت سلطة الفضاء المكاني والزماني الذي يجعله (يشعر بالزهو) الشعوري التوتري ؛ فالفضاء هنا هو من يتحكم في استهواء الذات الفاعلة لتشعر بهذه النشوة. وعلى الرغم من زهو النص وتوهجه بالثروة اللغوية التي تتجسدها الذات ، إلاَّ أن تلك الثروة لن يكون لها تأثير كبير سوى على مستوى التصنيف المقولي حين "خطر له في تلك المهمة تساؤل حرَّاق ؛ كيف لي أن أصافح كل هذه الأيادي من غير أن أتحوَّل إلى ببغاء؟! . فعمد إلى الاكتفاء بمصافحة البعض دون أن ينبس بكلام ، جاعلاً هذا الصمت كفاصلة بين عبارتين ..." ؛ هكذا ستتوجه الذات نحو التكييف النفسي واللفظي بحيث يستطيع الإمساك بفعل الكينونة الإدراكية التي تمكنه من الهيمنة على سياق الخطاب في فضائه الجديد لذلك فإنه قرر "... أن يحتفل بطريقته الخاصة ، فهتف بصوت تعمَّد أن يكون عالياً : (أحسن الله عزاكم جماعة) ..." . تتمركز الذات الفاعلة هنا في الفضاء المكاني والزماني (الآن) ضمن نسق توتري تحاول خلاله الوصول إلى الامتلاء التوتري والقوة التي تمكنها من الوصول إلى الهيمنة فـ " ... ساعده أحدهم – وهو على ما يبدو أحد أقرباء الميت – فأفسح له مكاناً في صدر المجلس . وها هو عبد الفتاح يصبح واحداً منهم . يده من أياديهم ، لها ما لها من تمر وقهوة مُرة ، وعليها ما عليها من ضغط ومن هزٍّ كما تُهزُّ يانعات الثمار...". ستكون الذات الفاعلة هنا حالة وسط سياق فضائي جديد ، هي إذن (حالة نفس) ولابد أن تكون مؤهلة في أفق الفعل ،وهذه الأهلية الكيفية ذاتها تخضع لتحول الفضاء وذواته التي تحاول إدماجه ضمن الفضاء الداخلي المنسجم للخطاب . ستشتغل الذات الفاعلة على (الحس) لتأسيس خطاب قائم على التصدي للتوترات ، إنها حالة من الاستقرار المؤقت خاضع للتغيير وعُرضة للتشويش عن طريق التوْجِهة والتكييف ، ولذلك فإن الخطاب هنا سينطلق من حالة الآخر التي ستشكل توتراً جديداً يمثل ارتجاجات متواصلة تحاول الذات الإمساك بها في شكل متغيرات خاصة بكثافة وتداخل الإجراءات التي يمكن اعتبارها (توجهة) ؛ حيث " اقترب شيخ عجوز وهمس في أذن عبد الفتاح : جبت علوم ؟ لا ما جبت . ما حد تعاضل؟ لا ماحد...يعرف المنغلق أن عليه الآن أن يرشق الشيخ بسؤال : ومن صوبكم؟ ليتأكد هذا الأخير أنه من قبيلة محترمة . ولكن غيضاً ما بداخله هتف ؛ لا تفعل ...". إنها إذن حالة صراع نفسي داخلي في محاولة لاستقرار ذاتي قائم على إنتاج تمفصلات دلالية تمسك بالخطاب الظاهر للسياق ، على أن جزء من ذلك الخطاب افتراضي يمسك بظاهر الكينونة ويُسقط خطاباً لتسويغها ، ولذلك يعمد النص إلى إيضاح تلك الكينونة في شكل (خطاب شارح) يقحمه على الخطاب ، في محاولة لإيصال (القارئ) إلى شروط إنتاج الدلالة التي يريدها هو ، لذلك نجده يوضح أن :"عبد الفتاح ليس من هذه القرية . بل كان ماراً بالصدفة حين رأى السيارات الكثيرة أمام باب الجامع في غير ما وقت صلاة . قال في نفسه: السيارات الكثيرة في النهار تعني عزاء ، مثلما تعني السيارات الكثيرة في الليل عرساً . ولأن المنغلق يعتبر العزاء موقفاً ضد الموت فقد ترك سيارته في موقفها وترجل ليسجل موقفه..." يعتمد برنامج سلطة الخطاب في هذا النص على ظاهر الكينونة التي توجدها الذات كما رأينا وهو ظاهر قائم على الممارسة الإجرائية مباشرة ؛ فينتقل من ارتجاج إلى آخر عن طريق إسقاط بنيات للمنفصل لكي تتكفل الذات الفاعلة ضمن هذه الارتجاجات من الانعطاف زمانياً ومكانياً من خلال كيفيات الفعل التوتري ، لذلك سنجده ينعطف ضمن مجموعة من التوترات الارتجاجية في خطاب يشكل بصرياً سياقاً واحداً ، وهي: أولاً : ارتجاج عاطفي ؛ " كانت عيناه عسليتين . ألهذا إذن تذكر عبد الفتاح حبيبته؟! .. (قالت يوماً : ربما كنت الإنسان الوحيد في هذا العالم الذي يمجد الشخير ولا يستاء منه) . لم يندهش ، فقد أخبرته ذات حزن أنها مذ رأت أباها في رقدته الأخيرة وهي تحملق بتركيز شديد مشوب بالقلق في كل من تراه نائماً..." ثانياً: ارتجاج مجتمعي ؛ "... مسح عبد الفتاح المستطيل الطويل بعينيه فلاحظ أن الجميع تقريباً يحمل عصا طويلة ورفيعة في يده . تمتم في سِّره : (تا الله إن الموت لا تخيفه عصا لو كنتم تعلمون).." ثالثاً : ارتجاج فضائي ؛ " ... وحين تناهت إلى أذنه أبيات (الميدان) التي كان يتبادلها المعزيان المقابلان له أدرك المنغلق أن عليه أن يغادر المكان" إن ظاهر الكينونة الذي فرض كل تلك الارتجاجات التوترية يسيطر على خطاب النص ، لتبدو الذات هنا ممتلئة تماماً إلى أن تخرج من ربقته وسيطرته ، لنجده يضعنا أمام تمفصل كينوني يفصل الذات الفاعلة عن حالة الفعل الذي تأسس على النص ؛ إذ " ...فكر وهو يدير محرك سيارته قافلاً إلى بيته في القرية المجاورة أنه دخل وخرج ولم يعرف من الميت". إنه – أي الخطاب – يعيدنا بذلك إلى نقطة تأسيس النص . على سبيل الختام إن الخطاب من حيث هو واقعة ؛ أي من حيث هو وظيفة إسناد متداخلة ومتفاعلة بوظيفة هوية هو شيء مجرد ، يعتمد على كل عيني ملموس ، هو بذلك الوحدة الجدلية بين الواقعة والمعنى في الجملة ، وقد تتمعن مقاربة نفسية أو وجودية تركز على تداخل الوظائف ، واستقطاب التحديد المفرد والإسناد الكلي ، في هذا التشكيل الجدلي للخطاب ؛ فالتركيز على المفهوم المجرد للواقعة الكلامية لا يبرر إلاَّ اتخاذها وسيلة احتجاج على اختزال أكثر تجريداً للغة من حيث هي لسان ، لأن فكرة الواقعة الكلامية تذكرنا أن الخطاب يدرك زمنياً وفي لحظة آنية ، في حين أن النظام أو النسق اللغوي افتراضي وخارج الزمن ، "...لكن ذلك لا يحدث إلاَّ في لحظة التحرك الفعلي والانتقال من اللغة إلى الخطاب..." إن إرادة المعرفة التي تسعى إليها الذوات والمجتمعات ، وما يرتبط بها من استراتيجيات واستراتيجيات مضادة ، تعتبر الوجه الآخر لإرادة السلطة والهيمنة التي تخترق الوجود الإنساني وتحتويه ، ولذلك فإن ممارسة الخطاب بوصفه نوع من التفاعل بين فعل التفكير وفعل الكلام سيجعل "... الخطاب فكراً مكسواً بعلاماته ، فكراً جعلته الكلمات مرئياً ، أو على العكس من ذلك ستكون هذه الكلمات هي نفس بنيان اللغة المستعملة والمنتجة لمفعول المعنى" ، ولذلك فإن الخطاب بما يحمله من فكر يهيمن على النص ، وعلى الذوات المشتغلة في سياقاته ، بل على السيرورة السردية كلها داخل النص لتسقط بدورها تلك الهيمنة قصدياً أو لا قصدياً على المتلقي ، كما هو الحال في تلك النصوص التي حاولنا هنا سبرها . فما قمنا به في هذا البحث لا يمثل إلاَّ محاولة للاشتغال على الخطاب المهيمن على النص والمندفع من هوى ذاتي أو مجتمعي بوصفه مؤسس لفكر ما . إنها أفعال خطابية هووية تنتقل من حالة إلى أخرى ضمن سياق خطابي معين في محاولة لتجسيد التوترات باعتبارها توجيهاً وهو شرط أساسي ليكون الاستهواء قادراً على تجسيد ذلك التركيب الذي وقع فيه هذا الفعل الخطابي أو ذاك . مراجع : فوكو . ميشيل ، نظام الخطاب، ترجمة محمد سبيلا . دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2007م. ص 66. و Wodak .Rush and Paul Chilton , A New Agenda in Critical Discourse Analysis . John Benjamins Publshing Company , Amsterdam , philadelphia,2005.p283-309. اقترح ريكور ثلاث سمات مميزة لنظرية الأثر الأدبي . في البداية ، كون الأثر متوالية أطول من الجملة ، وتثير مشكلة جديدة للفهم ، تابعة للكلية النهائية والمغلقة التي يشكلها الأثر كأثر . ثانياً ، يخضع الأثر لشكل تقنين ينطبق على البناء نفسه الذي يصنع الخطاب، سواء كان رواية ، قصيدة ، أو بحثاً ، إلخ ؛ هذا التقنين هو ما عُرف باسم النوع الأدبي ؛ بعبارة أخرى يعود أمر التصنيف في نوع أدبي ما إلى الأثر نفسه . وأخيراً فالأثر يستقبل تشخيصاً ريداً يماثله بفردٍ ما نسميه أسلوباً . انظر ريكور . بول ، من النص إلى الفعل ، ترجمة محمد برادة ، وحسان بورقية . عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، القاهرة ، 2001م . ص 82. Wodak.ruth.Methods of critical discourse analysis . Ibid. P123-124 . Wodak.ruth.Methods of critical discourse analysis Ibid. P123. كورتيس . جوزيف ، مدخل إلى السيميائية السرية والخطابية ، ترجمة جمال حضري . الدار العربية للعلوم ناشرون ، 2007م . ص 144. ريكور ، من النص إلى الفعل ، مرجع سابق . ص 167. Widdowson . H.G , AN Applied Linguistic Approach To Discouse Analysis . Unpublished Ph.D . thesis , Department of university of Edinburgh , May 1973. P 10-13. وانظر ، دي سوسير ، فرديناند ، محاضرات في علم اللسان العام ، ترجمة عبد القادر قنيني . أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، 2008م.ص ريكور ، من النص إلى الفعل ، مرجع سابق . ص 79-80. كورتيس ، مدخل إلى السيميائية السرية والخطابية ، مرجع سابق . ص 149 . و Wodak.ruth.Methods of critical discourse analysis . Ibid. P124. ريكور ، من النص إلى الفعل ، مرجع سابق. ص 80. للتفريق بين الخطاب الشفاهي ، والخطاب المكتوب ، انظر Brawn.Gillian , George Yule , Discourse Analysis . Cambridge university press, New York ,1983.p10-13. غريماس . ألجيرداس ، جاك فونتيني ، سيميائيات الأهواء (من حالات الأشياء إلى حالات النفس) ، ترجمة سيعيد بنكراد. دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ، 2010م . ص 101. ريكور ، من النص إلى الفعل ، مرجع سابق. ص 127. خليل . إبراهيم ، في نظرية الأدب وعلم النص (بحوث وقراءات) . الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت ، 2010م . ص 220. حيمر. عبد السلام ، في سوسيولوجيا الخطاب . الشبكة العربية للأبحاث والنشر ، بيروت، 2008م. ص 223. و Paul Gee . James, An introduction to Discourse Analysis (Theory and Method) . Routledge ,Taylor & Francis Geoup . Landan and New York , 1999. P61. ريكور ، من النص إلى الفعل ، مرجع سابق. ص 107. المرجع السابق نفسه . ص 107. فونتاني . جاك ، سيمياء المرئي ، ترجمة على أسعد ، ط2 . دار الحوار ، سورية ، 2003م . ص 43. المعمري . سليمان ، عبد الفتاح المنغلق لا يحب التفاصيل ، الانتشار العربي ، بيروت ، 2009م. ص 17. المرجع السابق نفسه . ص 25. فونيني . سيماء المرئي ،مرجع سابق ، ص 17 . المعمري ، عبد الفتاح المنغلق لا يحب التفاصيل ، مرجع سابق. ص 13. تودروف . تزفيطان ، الأدب في خطر ، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي . دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، 2007م . ص 45. خالفي . حسين ، البلاغة وتحليل الخطاب . دار الفارابي ، بيروت ، 2011م . ص 39. ريكور ، من النص إلى الفعل ، مرجع سابق . ص 90. المعمري ، عبد الفتاح المنغلق لا يحب التفاصيل ، مرجع سابق. ص 49. غريماس ، سيميائيات الأهواء (من حالات الأشياء إلى حالات النفس) ، مرجع سابق . ص 69. كورتيس ، مدخل إلى السيميائيات السردية والخطابية ، مرجع سابق. ص 166 . المعمري ، عبد الفتاح المنغلق لا يحب التفاصيل ، مرجع سابق. ص 33. ريكور . بول ، نظرية التأويل (الخطاب وفائض المعنى) ، ترجمة سعيد الغانمي ، ط2 . المركز الثقافي العربي ، بيروت ، 2006م. ص 38. المعمري ، عبد الفتاح المنغلق لا يحب التفاصيل ، مرجع سابق. ص 33. ريكور . بول ، الذات عينها كآخر ، ترجمة جورج زيناتي . مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2005م. ص 397. المرجع السابق نفسه . ص 400. دي سوسير ، محاضرات في علم اللسان العام ، مرجع سابق. ص 22. ريكور ، نظرية التأويل (الخطاب وفائض المعنى) ، مرجع سابق. ص 39. المرجع السابق نفسه .. ص 42. المعمري ، عبد الفتاح المنغلق لا يحب التفاصيل ، مرحع سابق. ص 9. غريماس ، سيميائيات الأهواء (من حالات الأشياء إلى حالات النفس) ، مرجع سابق. ص 95. المرجع السابق نفسه . ص 12. المرجع السابق نفسه . ص 55. المرجع السابق نفسه . ص 57. ريكور ، نظرية التأويل (الخطاب وفائض المعنى) ، مرجع سابق. ص 37. فوكو ، نظام الخطاب، مرجع سابق . ص 34.
__________________
ديواني المقروء |
|
#4
|
||||
|
||||
|
ملامح العمارة المحلية و التقليدية في عمان
بقلم : سعيد الصقلاوي معمار ومخطط عمران حضري فضاء ثقافي منذ اقدم العصور ، شغلت المدينة حيزا هاما من الابداع الشعري والادبي ، واحتلت موقعا متميزا في بؤرة الاهتمام العلمي ، والجغرافي ، والهندسي . فلقد كتب البابليون ملحمة جلجامش ، والاغريق الياذة هوميروس ، والفرس الشهنامه. وكانت الاحداث في هذه الاعمال الادبية تحمل ملامح المدينة التي نشأت فيها . اضافة الى الروايات العديدة ابتداء من الف ليلة وليلة . ومرورا بقصة بين مدينتين لتشارلز ديكنز ، فبين القصرين لنجيب محفوظ ، ثم مدن الملح لعبد الرحمن منيف ، وغيرها من القصص و الروايات العربية و العالمية . واذا كان شعر الملاحم قد صور احداث المدن فان القصائد ذات الصوت الواحد في العصور المختلفة ابتداء من الجاهلية وحتى العصر الحديث كان لها دور بارز ومميز في ابراز ملامح المدينة الحضارية ، والثقافية ، والاجتماعية . ولقد نقلت الينا كتب الادب العربي و موسوعاته المختلفه صورا متعددة لمظاهر الحضارة العربية في بدوها وحضرها ، في قراها ومدنها ، في بلدانها واقاليمها ، في سواحلها وعمقها البري . ويكفي المرء نظرة الى كتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاي ، والامالي للقالي ، والعقد الفريد لابن عبد ربه ، والكامل في الادب للمبرد ، وغيرها من مراجع التاريخ الأدبي ليتعرف على احوال المدينة العربية من وجهة النظر الادبية . فالشعراء العرب منذ امريء القيس في الجاهلية ، ومرورا بابي نواس وابن الرومي وشعراء الصوفية في العصر العباسي ، وتعريجا على ابن حمديسى وابن زيدون وابي البقاء صالح الرندي في العصر الاندلسي، ووصولا الى شعرنا المعاصر من احمد شوقي وحتى ادونيس ونزار قباني وغيرهم، لم يدخروا وسعا في رسم صورة ثقافة المدينة العربية ، و التي هي في الواقع نتاج الفكر والعقل الانساني في هذا المحيط . وتعتبر الدراسة التي قام بها الدكتور مختار ابو غالي وثيقة ادبية حديثة ركزت في معطياتها وتناولها على موضوع المدينة في الشعر العربي المعاصر . واذا ما حاولنا التعرف في عجالة على اهتمام المؤرخين بالمدينة ، فسنجد انهم منذ هيرودوت ، ومرورا بالمؤرخين العرب كابن الاثير، والمسعودي ، ووصولا الى اشهر مؤرخي اوربا ، كأرنولد تومبي ، قد تناولوا المدينة من حيث تاريخها ، مبرزين فعل العقل الانساني في مسيرة حركة تطوره السياسي والمدني . وظلت المدينة منذ بطليموس ، وبليني في العصور الغابرة ، ومرورا بالجغرافيين العرب كالاصطخري ، وابن حوقل والهمذاني والادريسي وغيرهم في العصور الوسطى ، ووصولا الى العصور الحديثة مثل لويس ممفرد في كتابه تاريخ المدن ، وجمال حمدان في جغرافية المدن ، وغيرهم كثير ممن كان لهم دور فاعل في اثراء الاضاءات العلمية حول المدينة من الناحية الجغرافية ، والمكانية ، والتاريخية ، وغيرها من الامور المتعلقة بمسيرتها وتشكلها . والفلاسفة منذ ارسطو ، وافلاطون في جمهوريته الفاضلة ، ومرورا بفلاسفة المسلمين والعرب ، كالفارابي في مدينته الفاضله ، وابن خلدون في فلسفته عن العمران ، التي اوضحها في كتابه الشهيرمقدمة ابن خلدون وديوان العبر في المبتدأ والخبر . ثم وصولا الى فلاسفة العصر الحديث ، وهم كثر من الاوربيين والمسلمين والعرب ، وغيرهم من الاقوام والامم . واهتم مخططو المدن ، ومهندسو العمارة ، بالمدينة وانماط الحياة ، وتأثيرها على هندستها المعمارية . فمنذ الفراعنة ، فالعصور الوسطى ، ظهرت فلسفات متعددة دارت حولها تخطيطات المدن ، وحملت ابنيتها الملامح المعمارية لها. فنرى المدينة الاسلامية الاولى في بساطتها ، مثل يثرب ومكة ، والمدينة الاسلامية الاكثر تشابكا ، كبغداد والبصرة والموصل ودمشق. ثم الطرز المعمارية التي حملت تواريخ حقب ودويلات مختلفة ، كالطراز الفاطمي ، والمملوكي ، والاندلسي . وفي اوربا ايضا بدأت المدينة وليدة الحضارة الاغريقية فالرومانية ، فمدن العصور الوسطى التي مثلتها عمارة عصر الباروك ، فالمدن الصناعية الاولى في العصر الحديث ، وبعدها مدن الحدائق ، وغيرها من المدن التي ظهرت في القرن العشرين ، و كانت نتاج ثقافات وفلسفات و نظريات عديدة . ولم ينس علماء الاقتصاد دورهم في هذا المضمار فتعاملوا مع المدينة مرة بشكل كلي ومرة بشكل جزئي . فمن الناحية الكلية تبنوا ما عرف باقتصاديات المدينة، ومن الناحية الجزئية تبنوا ما عرف باقتصاديات القطاع ، كالقطاع الاسكاني ، والقطاع السياحي ، والقطاع الصناعي وما شابه ذلك . وقد شارك علماء الصحة والبيئة في موضوع المدينة ، فخصصوا دراساتهم وركزوها على بيئات المدن ، وصنفوا نتائجهم تبعا لما تحمله كل مدينة من مظاهر الصحة البيئية ، ووضعوا الخطط التنفيذية لمعالجتها او تنميتها . واذا كان للمؤرخين والجغرافيين دور بارز في موضوع المدينة ، فان دور الأثاريين يزداد اهمية بالغة فيما يقدمونه من نتائج علمية ، تضيء كثيرا من الجوانب التي رواها المؤرخون ، وتناقش القضايا التي طرحت حول موضوع المدينة في عصورها ا لمختلفة. و بفضل جهودهم تعرفنا على حضارات وثقافات بعض المدن العمانية القديمة ، مثل أوبار وسمهرم والبليد في ظفار، وصحار في الباطنة ، وبات في الظاهرة ، وبعض المستوطنات السكنية في سمد و وادي نام من المنطقة الشرقية ، التي يعود تاريخها الى 3000 ق.م. حسبنا ان ننوه هنا الى ان المشتغلين بالمدينة قد تناولوها من جوانب متعددة ومختلفة . بعضها اتخذ اتجاها عاما وبعضها ركز على الجزئيات التفصيلية . والنظر الى المدينة من سماتها المختلفة كالسمات الثقافية والحضارية ، والفنية والمعمارية ، او من موقعها الجغرافي ، او بيئتها ، او نشاطاتها السياسية والاقتصادية والتنظيمية ، اظهر انواعا من المدن تنسب الى اوضاعها ، او سماتها ، او انشطتها او نظمها . فظهرت المدن الرأسمالية ، والمدن الاشتراكية ، والمدن الشيوعية ، والمدن الصناعية ، ومدن البترول ، والمدن العسكرية. و وسمت بعضها بمدينة الثقافة كباريس ، ومدينة السينما كهوليود ، ومدينة الفنون التشكيلية كروما ، والمدن الدينية بالنسبة للمسلمين مثل مكة والمدينة والقدس، وبالنسبة للمسيحين مثل الفاتيكان . وكذلك الحال بالنسبة لعمان ، حيث عرفت نزوى بجانب دورها السياسي بمدينة العلم ، وصور بمدينة الشراع ، وصحار بخزانة الشرق، وظفار ببلاد اللبان . لقد اصبحت كل مدينة من هذه المدن تعكس " علاقة الفرد بالمجتمع الذي يعيش فيه " . والذي ينبغي ان نشير اليه هنا، هو ان المدن عاصرت كل المدنيات التي ظهرت على وجه البسيطة، وكذلك عاصرت كل الناس منذ ان عرف الانسان الاستقرار ومعنى التوطن ، ومفهوم وشكل المدينة، في بساطتها او تشابكها . ولكن الملفت للنظر هو ان الناس قد ذهبوا وواراهم الثرى، كل حسب مقدار انجازه، وظلت المدينة شاخصة في وجدان الانسان، وماثلة في ضمير الاجيال تروي تاريخه تمهيد في العمران العماني المحلي إذا كان التخطيط العمراني للمدينة القديمة ينطق بروح الأصالة التي تعني في المفهوم العام التمسك بقيم شكلية، ومعنوية ذات مضامين خاصة ، انطلاقا من ثوابت أرستها المعطيات الثقافية والحضارية للمجتمع ، فان التخطيط العمراني المعاصر للمدينة يخرج على المألوف في شكله ، ويختلف إلى حد ما عن السائد، في معانيه و مضامينه . ويبتعد عنه في أساليب معالجته الإنشائية ، توافقاً مع منطلقات العصر الفكرية والثقافية ، والمتطلبات التكنولوجية ، والحاجات الإنسانية النفسية ، والاجتماعية ، وتفاعلات الأنشطة الاقتصادية والصناعية . إن سائر المدن العمانية العريقة تتعانق فيها الأصالة بالمعاصرة ، فيتحد السائد بغير السائد ، و يتماهى المألوف مع غير المألوف ، دون خروج فج على قيم اجتماعية موروثة ، ودون شطط في التعامل مع الشكل والتخطيط العمراني المعاصر . فأنتجت نسيجاً حياً ، تجسد ملامحه رسالة بصرية حضارية تستنطق التاريخ . و تستظهر تجليات المكان . و تكشف عن حقب الأزمان في مشهد متنوع من البساطة ، وتكريس صراحة التعبير المعماري ، وعدم المبالغة ، انحيازا إلى البيئة العمانية في تكويناتها الطبيعية ، والى المجتمع في بنيته الهيكلية ، و إلى تطلعات المنجز منه نحو مستوى افضل للمعيشة والاستقرار السكاني . تتوافر فيه عوامل الراحة ، والأمن ، والسلامة ، والصحة و البيئية. تزخر المدينة العمانية باعتبارها مركزا حضاريا في سيرة التاريخ العماني بالعديد من مفردات التخطيط العمراني متمثلة في حاراتها المسورة و غير المسورة، قديماً ، و المنفتحة حديثا ، وأزقتها المتعرجة و دروبها المنكسرة ، و طرقها الضيقة ، ثم شوارعها الجديدة المستقيمة ، وأسواقها التقليدية ومساجدها الصادحة بذكر الله ، ومساكنها القديمة والمعاصرة ، و مجازاتها بقرب مجاري الافلاج و التي كانت بمثابة حمامات عامة ، وكذلك قلاعها وبروجها الشامخة فوق رؤوس الجبال وعلى الهضاب و السفرخ وقرب مداخل الوديان و على السواحل، و سوقها التي تعج بتفاعلات الأنشطة الاقتصادية في عرصات المدينة و حوانيتها التقليدية والمعاصرة ، فضلا عن سبل الري و الافلاج وأبنيتها وقنواتها و ابارها. لذا فان هذه الورقة تسعى إلى تسليط الضوء على جوانب عديدة من هذه المفردات ، وتحاول إيضاح مواطن التطور العمراني في المدينة وعناصرها المعمارية بغرض عرض مظاهر التغير الحضاري ، و توضيح اثر انعكاس التفاعلات الثقافية والحضارية ، والانفتاح على الآخر والتحاور معه في أبنية مدينة العمانية المعاصرة . وتخلص الورقة إلى أن البيئة الطبيعية بمناخها وتضاريسها ومظاهر سطحها قد لعبت في التخطيط العمراني للمدينة القديمة دورا بالغ الأهمية ينبغي أن يراعى أهمية هذا الدور في تخطيط مساحة المدينة ، و تحديد الاستعمالات المختلفة ، وان تتأكد أهميته في تخطيط الأبنية بفراغاتها الخارجية والداخلية ، وان يؤخذ هذا الدور في الحسبان عند وضع التصاميم الإنشائية للأبنية والطرقات وغيرها . وحرصت الورقة على إيضاح المواد المستخدمة في الإنشاءات القديمة والتي كانت مستخرجه من بيئة إقليم المدينة المحلية ، وأن يتم الاستفادة من هذا الانسجام بين طرق الإنشاء المختلفة ، مع المواد البيئية المحلية دون إضرار أو إخلال ، للحصول على تنمية مستدامة . و تؤكد الورقة أن أساليب الإنشاء التقليدية التي شيدت بواسطتها صروح المدينة العمانية العريقة هي أساليب يمكن تطويرها وتطويعها لتتلاءم مع المتطلبات العصرية للإنسان المعاصر ، وتحث هذه الورقة على أهمية مراعاة الجانب الاجتماعي في التخطيط العمراني وعدم إهمال الحاجات النفسية والسلوكية ، وان دراسة التغير السكاني ، والثقافي ينبغي ان يؤخذ في الحسبان عند وضع المخططات العمرانية. وتشدد الدراسة على أهمية تأصيل مفهوم عناق الأصالة بالمعاصرة وتكثيف حضوره في الثقافة المعاصرة لان ذلك يمثل جسرا طبيعيا لتعبر عليه تحولات المجتمع بثبات دون فقدان الهوية ، ودون تعريض الخصوصية و الحرمة إلى اهتزاز. البيئة و الثقافة مما لاشك فيه ان عمارة المجتمعات الانسانية قد تاثرت بتنوع و تشكيل البيئات المختلفة المؤثرة في انماط التفكير المعماري و الاشكال المعمارية و انواعها و وظائفها لتخدم الاستخدامات و الحاجات و المتطلبات المتنوعة و المتطورة بحسب النمو الاجتماعي و مناشط التنمية. و سوف نتطرق باختصار لهذه البيئات المختلفة. ثقافة البحر: وهي تلك المفردات الثقافية المرتبطة بالبحر من حيث النشاط والفعل والفكر والفن الانساني في صوره المختلفه . ومساحة هذه الثقافة تمتد على سواحل صور ونياباتها . تأخذ من البحر صفاته ، و من الشراع انطلاقه ، ومن الغنجة انسيابها ، ومن الانجر ثباتها ، ومن الانسان تواصله ومثابرته. ثقافة البر: وهذه تشتمل الثقافة التي تتفاعل مفرداتها في المحيطات الحضرية و الزراعية والصحراوية. تحتضن ابهى صور التلاقي الثقافي . يشي بذلك الازياء ، وطرق الحياة ، ونمط العمران والبناء ، واساليب الاداء الفني الراقيه . هذه الصورتاخذ من الذريرة § طيبها ، ومن الازياء فرحها ، ومن المصوغات ذوقها § اباءها ، ومن الحصون والبروج تاريخها وكفاحها . ونرى جانبا من الثقافة تتفتق في المحيط الزراعي ، في البساتين ، وبين الحقول . تأخذ من الخضرة القها ، ومن النخيل سموقها ، ومن الكيذاء§ عبقه ومن الياسمين رائحته . بينما تنبت الباقات الثقافية الاخرى في الواحات و المستوطنات الصحراوية . تأخذ من الصحراء نقاءها ، ومن السماء بريقها ، ومن الجمال صدقها ، ومن الكثبان قدرتها على التفاعل مع البيئة و التلاقح مع ثقافتها . الثقافة الادبية والدينية والفنية : لا تنبت الثقافة ما لم يتوافرلها النبع الدافق . وكانت منابع الثقافة تتمثل في مدارس تعليم القرآن الكريم والكتابة، و تسمى مثل هذه المدارس في بعض الدول العربية بالكتاتيب . و كانت هذه المدارس تتخذ من بيوت المعلمين او المساجد مقرا لها لقد مارست المرأة دورها الثقافي باقتدار حيث تم نشر التعليم من خلال تدريب البنات والصبيان على حد سواء . وكانت تنتشر في الحارات و الاحياء مدارس عديدة، مارس المخلصون للعلم فيها دورا رياديا في محاولة غرس بذور الثقافة . . وكان انشاء المدرسة يمثل مرحلة من التعاون بين الحكومة والمواطنين او بين المواطنين انفسهم. وبجانب المدارس ، لعبت السبلة او البرزة دورا تثقيفيا و تعليميا هاما . فقد كانت المجالس او البرزات في البيوت او في الخلاء او على ساحل البحر او تحت الشجرة منتديا ثقافيا يداوم على حضوره عشاق الثقافة والادب والفكر . وكانت السبلة او البرزه بمثابة الصالون الادبي والثقافي الذي عرفته مجتمعات عديدة . وكانت هذه الصالونات ملتقى للادباء والمفكرين يناقشون فيها قضايا الفكر ،والادب ، والسياسة ، والمجتمع , ولم يقتصر دور المسجد على اداء الصلاة فقط ، بل اتخذ مدرسة تلقن الاطفال علوم القرأن الكريم ، و السنة المطهرة. وعقدت فيه حلقات الذكر ، واجتمع فيه المواطنون على مائدة الافطار في رمضان ، وتحلق حوله الاطفال ينقلون بشائر الاذان المبارك . وكانت المرأة تتفاعل مع الثقافة من خلال مجالس النساء التي كانت تعقد في البيوت ، يتداولن الاشعار ، والأمثال ، والاخبار ، والاحاديث الدينية . فضلا عن جلسات الفن الشعبي الذي كن يمارسنه في بيوتهن مساء ، او في وضح النهار بين الحارات او في الميدان . الثقافة الاجتماعية والسياسية : يقصد بهذا المدخل ثقافة العادات والتقاليد الاجتماعية ، وثقافة النظام السياسي المتبع في المدينة ، فمن المعروف ان كل مدينة تتقاسم كثيرا من العادات المشتركة مع المدن العمانية المختلفة ، ولكنها تختلف عنها في خصوصيات هذه العادات المتوارثة يرفدها مد ثقافي توارثته الاجيال . وخضع في جزئياته الى تغيرات وتبدلات ، تبعا للتلاقح الثقافي ، والتطور الحضاري . واذا نظرنا الى ثقافة المدينة من الناحية السياسية ، فاننا سنرى ان المدينة سابقا كانت تدار من قبل المشايخ والرشداء في مختلف مناحي النشاط الادراي والاجتماعي والاقتصادي . وظلت سلطة الوالي مقتصرة على الامور الكبيرة ، والصعبة . كما كانت علاقة الحاكم بالمحكوم مباشرة ، و واضحة و هذه العلاقة جسدتها ابنية الادارات المحلية المحتلفة و اهمها مكاتب الولاة. لقد كانت المؤسسات الادارية الحكومية محدودة في مدينة. وكان مكتب الوالي هو المؤسسة الحكومية الاولى و الرئيسة في المدينة ، الثقافة الصناعية والزراعية : من المعروف ان الثقافة الصناعية والزراعية في أي مجتمع تعتمد على اتقان ادواتها ، وهذا الاتقان يبدأ بالتلقين فالتدريب فالممارسة .فاتخذت فكرة او فلسفة (الوليد) او صبي (الاستاذ) مبدأ للتقلين والتدريب . فكانت المراحل التعليمية الاولى للصناعة او الزراعة تبدا بتبني استاذ او معلم في حرفة ما مجموعة من الصبية (صبيان وبنات) يلقنهم مبادىء الحرفة ، ثم يدربهم عليها . وبعد ان تكتمل لدى المتدرب الادوات التعليمية التي تؤهله من ممارسة الحرفة ، يسمح له بذلك . هذا النوع من التثقيف والتعليم ما زال يمارس حتى يومنا هذا في الدول الصناعية. ويمارس في الجامعات باعتبار التلميذ واستاذه، مع اختلاف في تطور الادوات المستخدمة في التعليم والتثقيف والتدريب . وقد اظهرت هذه الطريقه عددا من الاساتذة في الصناعات المختلفة الثقافة العمرانية والتخطيطية : ان المتجول في شوارع المدينة وحاراتها ، والقادم اليها يلاحظ ان طرازها المعماري له خصائصه المتميزة التي هي نتاج عوامل حضارية قبل أي شيء . اذ ان العمارة وعناصرها تمثل " صورة من ثقافة الامة وتجسيدا لها " . و ينتج اشكالا " في الهندسة المعمارية و الزخرفة الخارجية ". و ان هذه الأشكال " تعكس سهولة الحياة و هدوئها في المدينة". فالعمارة هنا قائمة على مبدأ احترام حقوق الجار ، الذي اقره الاسلام . اذ لا ينبغي ان تجرح حرمة الجار . فصممت الشبابيك والابواب على ان لا تكون متقابلة وان لا ترتفع الابنية بما يخدش هذه الحرمة. كما لا يسمح باختراقها. و ذلك بعدم توجيه الشبابيك والفتحات نحوها مباشرة . واذ نظرنا الى تخطيط السوق القديم ، فاننا سنرى انه لا يختلف عن تخطيط الاسواق العربية الاسلامية القديمة الذي اعتمد على مبدأ " الرزق عند مواطن الاقدام " . فكانت الطرق الضيقة ، والمحلات المتقابلة ومساحة التجمع الكبيرة كي تسهل حركة التبادل التجاري . و صممت الشبابيك المنتشرة في الدكاكين والمحلات ، بغرض تسهيل البيع والشراء للنساء دون الحاجة الى دخولهن. ونظرا لموقع المدينة فكان لابد من الاستفادة من التهوية الطبيعية التي توفرها نسائمه . فصممت الشبابيك لتستقبل مصاريعها الخشبية هذه النسائم في فصل الصيف ، وعلى مستوى ارضية الغرف، بينما صممت الاخرى لتستقبل دفئ الشمس في فصل الشتاء . و أوضح هذا التمايز في توجيه المسكن ، و فتحات الشبابيك للاستفادة من التهوية ، و الاضاءة ، و التدقئة الطبيعية . و اضاف هذا التصميم المساكن ميزة التحكم " الدقيق في سريان تيار الهواء للغرف المختلفة في المسكن " . ولقد وصف تيم سفرن مساكن مدينة صور بالفخامه . ويلاحظ انها المساكن الوحيدة في المدن العمانية التي تفرش بالحصحيص§ وهو عبارة عن احجار المرجان المجروشة . و الذي اشاد به تيم سفرن وقال عنه :" انه يصدر صوتا مفرحا عندما تطأه اقدام أي شخص " . و يؤيد هذه النظرة دونالد هولي ، عند اشارته الى بيوت الساحل العماني ولاسيما صورفيقول: ان" ارضيتها تكون مغطاة بطبقة من الحجارة الصغيرة النظيفة" . ولقد ظهرت مظاهر الفخامة هذه في مواد البناء المستخدمة ، والتي كانت متوفرة محليا في صور. و كان من بينها الحجر الجيري بلونه البهيج ، الذي بنيت به حوائط المساكن . و قد كسيت مساكن المدينة بالنورة§ التي تضيف بياضا الى الحجرات ، و تضفي راحة نفسية على سكان المنزل ، فضلا عن الرونق الجميل الذي تزين به المساكن. وكذلك الاسقف التي استخدم فيها حطب الجندل§ المجلوب من الفريقيا ، والسميم§ العمانية المنقوشة والمزخرفة ، و المدعمة بقصائب المنجور§ في اشكال هندسية متماثلة، بغرض توفير الاحساس بالجمال والتالف معه . لقد تعاونت مبادىء الثقافة العربية الاسلامية ، ومبادئ الثقافة البيئية التي وفرها موقع المدينة على تحديد الملامح العمرانية والتخطيطيه للمدينة ،حتى اصبحت صورة المدينة جزءا من شخصية اهلها . واصبحت ملامح تلك الصورة تتميز جليه من خلال مظاهر ثقافتها وملامح اصالتها . وقد ساعدت ايضا مجموعة من المعطيات الثقافية المتصلة بحرفة صناعة الحديد والاخشاب وصناعة البناء على تحقيق الهوية المحلية للمدينة وتاكيد اصالتها العربية الاسلامية . الإدارة المحلية من الناحية التراثية تتم إدارة المدينة محلياً عن طريق سلطتين: أحدهما أهلية و يمثلها شيوخ القبائل و رشدائها و أعيانها؛ و الأخرى رسمية و يمثلها والي الولاية و عسكره و يتبعه قاضي الولاية. و هذا النظام الإداري المحلي في السلطنة مستقى من مبدأ التعاون و التشاور و المشاركة في إدارة المجتمعات. و هو مطبق بصورة عامة في جميع مناطق المدن العمانية. إذ تتم إدارة شئون المدينة بالتشاور و التفاهم مع جميع الأطراف المعنية بشئون القبيلة و المجتمع. أما فيما يتعلق بالأحكام القضائية فإن قاضي الولاية و هو يمثل السلطة القضائية في هذا الصدد - و كان يتبع في ذات الوقت إداريا والى المدينة - مخول بالحكم فيها حسب الشريعة الإسلامية و على الوالي و عسكره التنفيذ. و لذلك فأن المنشآت المعمارية المخصصة من الناحية التراثية لهذا الغرض كانت تتناسب مع وظيفتها . فمجلس القبيلة (أو السبلة) يتيح للشيوخ و الرشداء و الأعيان الاجتماع و الالتقاء للتشاور و التحاور في شئون المجتمع. و تمثل القلعة أو الحصن السلطة الرسمية. و يصبح وجودها قرب السوق ، و قرب جامع المدينة مهماً ، يسهل عملية الاتصال بها ، و يقوي مركزيتها ، باعتبار أن الوالي (سلطة الإدارة السياسية و التنفيذية) ، و مركز القاضي (السلطة القضائية) ، و مركز الحرس أو العسكر ( السلطة الأمنية). و مع انطلاقة العهد الجديد قد طرأ التغير الكبير على نمط الإدارة المحلية في تسيير شئون المجتمع، و اتساع عملية التنمية الحضرية في المدينة. و أخذت كل وزارة حكومية تخصص فرعاً يمثلها يقوم على أداء وظيفة إدارية و تنموية محددة ، فانفصل الأمن بمركز الشرطة عن عسكر الوالي ، و انفصل القضاء بمحكمته . و أصبح الوالي يمارس مهمته في سياق إداري حديث. و لم تعد هذه الإدارات مجتمعة تحت سقف الحصن و قلعته. فقد خرجت مبانيها عن النسيج العمراني المتوارث ، فامتدت المدينة. و لم تتقمص نسقها المعماري ، إذا أوجدت نماذج لم تكن مألوفة في تخطيطها ، و واجهاتها ، و مواد بنائها ، و ألوانها ، و تفاصيلها المعمارية . و لكنها تتلامس مع أصالة المدينة ، و إيحاءات عناصرها المعمارية.
__________________
ديواني المقروء |
|
#5
|
||||
|
||||
|
تابع ورقة الكاتب -سعيد الصقلاوي:
المياه تزود المدينة بالمياه بواسطة مصدرين رئيسين هما:اة الفلج او البئر. و هذه المياه تصل إلى التجمعات العمرانية ، و إلى المزارع. و يقوم بإدارتها مختصون تواضع عليهم ، و أقرهم أهل المدينة. و ارتضتهم إدارتها المحلية بسبب خبرتهم الطويلة ، و بصيرتهم الراشدة ، و معرفتهم الدقيقة بشئون إدارة و إصلاح و صيانة الأفلاج و سواعدها و سواقيها، و توزيع مياهها. فيحصل كل مواطن من أهل المدينة أو مستفيد على نصيبه المقرر من المياه. و يدفع في المقابل ما يفرض عليه من التزامات مالية و أدبية. و هذا النظام المائي المتوارث يمكن اعتباره فيما يعرف اليوم بشبكات المياه للمدن و التجمعات العمرانية. و كما تحتاج عمارة شبكات المياه المعاصرة عددا من المنشآت المعمارية وعددا من العمليات الهندسية في المساحة و الهيدرو لوجيا و التخطيط و التصميم و التنفيذ ، كذلك الحال بالنسبة لنظام المياه ( الأفلاج) المتوارث. إذ تطلب وجوده التعرف على مصادر و منابع المياه ( أم الفج أو عينه) ، ثم التخطيط لكيفية جلبه للتجمعات العمرانية و للمزارع ، و توزيع حصصه عليها . فنشأ عن ذلك عمارة ألأفلاج و صيانتها. و استخدم في ذلك تقنيات بنائية محكمة في أساليب تنفيذها ، و استخدام مواد بنائها التي كانت متصالحة مع الطبيعة و محافظة عليها ، و في نظرنا يمكن تصنيفها ضمن مصطلح التنمية المستدامة. مفردات هذه العمارة ينبغي أن تدرس باستفاضة في مبحث مخصص لذات الغرض. المسكن يمكن تصنيف المساكن في المدينة و اقليمها بحسب الفصول إلى (بيت شتوي ، و بيت صيفي) ، و بحسب المكان الجغرافي إلى ( مسكن المدينة ؛ مسكن المزارع ؛ مسكن القرى الجبلية) ، و بحسب الظاهرة الاجتماعية إلى بيت حضري ( مسكن الحضري)؛ بيت ريفي(مسكن البيدار) ؛ بيت رعوي(مسكن الشاوي). و بحسب الهيئة إلى مسكن محصن (بمعنى له طابع تحصيني كبيت الرديدة و بيت سليط و بيت الفليج و بيت السيد نادر و غيرهما) ، و مسكن غير محصن ( بمعنى ليس له طابع تحصيني و قد مثلت هذا النوع سائر المساكن). وبحسب المواد إلى بيت حجري و بيت طيني و بيت سعفي. ولكل من هذه التصنيفات مسوغاتها. و لكل صنف من هذه المساكن تخطيطها المتوائم مع معطيات الوضع الاقتصادي ، و معطيات الوظيفة ، و البيئة :التضاريس ؛ و المناخ. و توافقت جميعها في استخدام نفس مواد البناء الأساسية. و مع التطور الحضري المعاصر في بنية ونسيج العمران في المدينة ، واكب هذه التصنيفات أنماط أخرى من المساكن المعاصرة يمكن تصنيفها في المساكن المبنية بالمواد الثابتة ( المشيدة بالطوب الأسمنتي) ، و الأخرى في المساكن المبنية بالمواد غير الثابتة ( و هي المساكن الجاهزة المصنعة من ألواح الخشب الحبيبي و غيره ) . و بحسب الملكية إلى ملكية خاصة و تشمل المساكن المملوكة و المؤجرة ، و ملكية عامة و تشمل المساكن التي شيدتها الحكومة لإيواء المسئولين و الموظفين الحكوميين. و بحسب النوعية إلى مساكن اجتماعية شيدتها الحكومة لذوي الدخول المحدودة و الضعيفة ، و مساكن شيدها المواطنون أنفسهم. و يجدر بنا أن نوضح بإيجاز مكونات أنماط المساكن التراثية في المدينة العمانية. مسكن الحضري و يقصد به المسكن الذي يشغله الإنسان أو المواطن الحضري الذي يستقر في المجتمع المديني. كما يمكن تسميته بالمسكن المديني و ذلك بنسبته إلى المدينة أو بنسبته إلى المجتمع المديني. و هو ذات المسكن المسمى بالبيت الشتوي و ذلك لاستخدامه في الفصول الباردة ، يقابله المسكن الصيفي الذي يبنى في المزارع و يستخدم في فصل الصيف . و جاء هذا التصنيف من النظام السائد في المجتمع الذي يتحرك تحت و وطأة القيظ إلى المزارع ، ليقضي فيها فترة الصيف ناعماً بطقس مريح ، و مستمتعاً بأيام جميلة يقضيها بين المزارع الوارفة بالخضرة ، و البساتين الغناء بشتى الأطايب ، ثم يعود قافلاً متربعاً بعد انقضاء الصيف مزوداً بمحصول و فير مما جناه من طنائه ، أو من استطنائه أو بيعه محصوله أو حصاده من التمر و الدبس و غيره. و خططت المساكن الحضرية ضمن النسيج العمراني للمدينة لتتلاءم مع اعتبارات الحياة حيث الاكتظاظ السكاني . و حيث يمكن أن تجرح الطرق الضيقة حرمة المسكن فينبغي حمايته بحجب الرؤية الخارجية كلية أو تقليل آثارها عن طريق الاعتماد على الحلول المعمارية أو قوانين البناء (فقه العمران). و يمكن لها أن تخترق خصوصيته فينبغي صونه بإيجاد صيغة معمارية تعتمد على الفصل في الحركة داخل الفراغ المعماري و أحيانا استعماله. و حيث حركة الناقل و المنقول ، و الحامل و المحمول ، والعامل و العاطل ، و الخاصة و العامة من المارة ، و حركة النقل النشطة و المتواصلة ، فينبغي تأمينه. و حيث الندرة في توفر الأرض الصالحة لبناء مساكن بمساحات كبيرة ، فينبغي التوسع رأسياً عوضاً عن التوسع الأفقي. و حيث متطلب الحاجات الاقتصادية و الاجتماعية ، فينبغي استغلال طوابقه (أدواره) و فراغاته المعمارية . و حيث متطلب العوامل البيئية و بخاصة المناخية ، فينبغي توجيه المسكن ، و ملاءمة تخطيطه وجدرانه العريضة ، و تجميعه مع غيره في نسق تتلاصق جدران المساكن فيه كي توفر أكبر قدر من اكتساب أو فقدان للحرارة. لقد أملت تلك المعطيات تأثيراتها على نمط تخطيط المسكن الحضري ، و على شكله . و بنيت أغلب مساكن المدينة حول حوش مركزي. و تتدرج ارتفاع المسكن من طابق إلى طابقين فثلاثة طوابق. و أصبحت مركزية الحوش عاملا هاماً في الإضاءة و التهوية و تلطيف الطقس للمستويات السفلى من المسكن . و مجمعا لحركة التوصيل و التلاقي في المسكن. و الحوش عميق و ضيق أحيانا. و نظرا لوجوده ينفتح المسكن في حالات كثيرة على الداخل. الجدران بها فتحات و لكنها لا تواجه الأماكن العامة . و حواجز الأسطح (الذروة ) ترتفع بحيث تمنع الرؤية من الداخل كي لا تجرح الخارج ، و تمنع الرؤية من الخارج كي لا تخترق الداخل. و يمثل المجلس في المسكن النزوي التراثي الغرفة ( الفراغ) المشتركة التي تستخدم اجتماعياً للزوار ، و اقتصاديا كمعمل (و رشة) لصاحب المسكن. و لذلك يموضع المجلس عادة في المسكن المكون من طابق بقرب المدخل . و حين يستخدم الطابق الأرضي للتخزين ، يموضع المجلس في الطابق الأعلى. تتمتع الغرف ( الحجرات) بتهوية و إضاءة جيدة عن طريق النوافذ الطولية أو المربعة الصغيرة و الصريحة ، و أحياناً تكون الغرف صغيرة معتمة قليلة الإضاءة تكتسبها عن طريق المراقات ، أو الفتحات العلوية . و يكون السلم غالباً مفتوحاً يقود إلى الأدوار العلوية أو إلى السطح حيث تجفف التمور. و تموضع دورات المياه في أماكن بعيدة عن الحجرات . أما المطبخ فيموضع في الجزء المفتوح من الحوش . و يتم توفير الماء عن طريق الوسائل التقليدية المتبعة ، و يوصل مباشرة إليها . هذا النوع من المسكن مبني بالطوب الطيني . و للطوب الطيني خاصية ضعيفة في توصيل الحرارة. فحيث تنخفض درجة الحرارة في الشتاء يوفر هذا الطوب قدراً من التدفئة، و حيث ترتفع درجة الحرارة في الصيف فإنه يوفر قدرا من التبريد ، نظرا لضعفه في فقدان و اكتساب الحرارة . و جدرانه عريضة لا تقل عن ذراع ( 50 سم تقريباً ) ، و تختلف العروض باختلاف الطوابق و الارتفاعات . تثبت العوارض (الجسور) من جذوع النخل على و سادة في الجدار بمسافات متقاربة ، ثم تفرش و تثبت مواد التسقيف المكونة ، من الدعون ، و السميم ، و العصابات من الزور و العسق، و فوق ذلك يفرش الطين المعجون بالتبن ،أو تفرش طبقة من الصاروج. وتصلح أي تملس و تنعم حتى تحمي السقف من الأمطار و الشمس و الضغط. و يمتاز عدد كبير من المساكن بسقوفها المطلية بالألوان الزاهية ، و كتبت عليها آيات من القرآن الكريم ، و أبيات من الشعر. و بالرغم من محاولة المواطن العماني - في تخطيط و بناء مسكنه - التمسك بالقيم الاجتماعية الثابتة المتعلقة بالخصوصية التي استطاع أن يوفرها بالفصل في الحركة و الاستعمال داخل المسكن ، إلا أنه لم يوفق كثيراً في توفير الحرمة بحجب اختراق الرؤية من الخارج إلى الداخل ، و من الداخل إلى الخارج ، بسبب قوانين التخطيط و البناء المعاصرة التي لم تسعفه في تحقيق في تحقيق ذلك. و بالرغم من الاستعاضة بالتبريد و التكييف الصناعي عن توجيه المسكن نحو مهب الرياح ، و عن الحوش المركزي بقاعة مركزية مسقفة تتوسط المسكن أو تأخذ جانبا ًمنه ، إلا أن ذلك حرمه من الاستمتاع بالبيئة الخارجية في شمسها الطاهرة ، و هوائها النقي ، وسمائها الصافية ، و نجومها اللامعة ، و أصبح تفاعله مع المحيط الخارجي للمسكن غير مألوف. و في ذلك أثر ينعكس على صحة الساكن. و بالرغم من استعاضته بالطوب الأسمنتي عن الطوب الطيني ، و بالأسقف الخرسانية عن الأسقف المشيدة من الجذوع و مشتقات النخيل ، و بطرق البناء المعاصرة عن طرق البناء المحلية ، إلا أن ذلك لم يساعده في تخفيض كلفة المسكن ، و لا تخفيض درجات الحرارة في الصيف ، و لا زيادة التدفئة في الشتاء ، و لا منع التشققات ، و تسرب الرطوبة . و هو ما يستوجب البحث عن مواد ، و طرق ، و أساليب فعالة. مسكن البيدار يشغل هذا النوع من المساكن شر يحة سكانية تسمى البيادير ، و مفردها بيدار و هم الفلاحون ، فكما أن لفظة الفلاحين مشتقة من الفلاحة فإن لفظة البيدار مشتقة من البيدر و جمعها بيادر ، و هي لفظة فصيحة. و هؤلاء إما أن يعملوا لصالحهم ، أو أن يعملوا لصالح غيرهم من ملاك المزارع أو الطناة أو المستطنين. و قد خططت هذه المساكن لتتناسب وظيفتها مع متطلباتهم، و مع إيقاع حركة حياتهم. فتوفر لهم الدعة و الطمأنينة ، و تكسبهم الراحة و السكينة. يبنى لمسكن في المزارع من دور واحد (طابق) ، و أحياناً دور (طابق) و غرفة علوية كبيرة ، و له سلالم خارجية تقود إلى سطح المسكن الذي يستغل لأغراض النوم صيفاً ، و لتجفيف التمر و البسر في النهار. جدرانه مبنية من الطوب الطيني غير المشوي ، ملحومة بملاط من الطين. و سقفه مشيد بجذوع النخل و مشتقاته من الدعون و السميم (مفردها سمّة) ، ثم تفرش فوقه طبقة من الطين أو الصاروج لحماية المسكن من الأمطار. تتوفر في المسكن نوافذ تفتح على المزرعة ، بالإضافة إلى الفتحات العلوية (المراقات) أعلا الأعتاب لتجديد التهوية و الإضاءة. مسكن القرى الجبلية في ولاية نزوى قرى واقعة في الجبل الأخضر لها طبيعتها و خصائصها المكانية ، و ظروفها البيئية التي انعكست على عمارة المساكن المحلية فيها. لقد خططت أغلب المسكن لتكون مستطيلة الشكل. يلائم بناؤها تضاريس الجبال الصخرية ، و أسطح مدرجاتها المنبسطة. و المساكن ذات سطوح منبسطة ، و تبعث أقواس سلالمها الحجرية الشعور بقدم المكان و تاريخه. و قد خططت الأدوار السفلية من المساكن للحيوانات ، أما الأدوار العلوية فتتخذ قاعة لمعيشة الأسرة ، و فيها غرف استقبال الضيوف. و شيدت جدرانها من الأحجار ملحومة بملاط من الصاروج أو من الطين. و سقفت المساكن بالأخشاب و السعفيات ، ثم غطيت بطبقة من الصاروج و حياناً من الطين للوقاية من الأمطار. و توضع أحيانا سقوفاً من شرائح الحجارة حتى تسد الفرجات بينها. مسكن الشاوي(الراعي) هذا المسكن أقرب إلى المأوى ، و مستواه المعماري يختلف عن مسكن الحضري ، أو مسكن البيدار ، أو المسكن في القرى الجبلية. و لكنه يلبي حاجات شريحة سكانية ، و هم الرعاة أو الشواوي. يتكون المسكن غالباً من غرفة واحدة ، تبنى جدرانها من الأحجار المرصوفة فوق بعضها بغير ملاط من الصاروج أو الطين للحمها . و يبنى السقف من الأخشاب و السميم و الدعون ، ثم يصرج بطبقة من الصاروج ، أو يمسح بطبقة من الطين. بمعنى أن طبقة من الصاروج أو الطين توضع فوقه لتساعد في تماسكه ، و لتحمي المسكن من تساقط الأمطار. و يندر وجود النوافذ ، و لكن توجد فتحات صغيرة علوية صغيرة مربعة و أحياناً طولية رأسية يطلق على مفردها مراق أو مبراق ، و ذلك بغرض تجديد التهوية و الإضاءة داخل الغرفة. المسجد لعلنا نختار مدينة نزوي باعتبارها تمثل مركزا دينيا للعمانيين و لذا سوف نتحدث عن بعض مساجده لاعطار صورة عن بعض مساجد عمان التراثية. تحتوي مدينة نزوى عددا من المساجد الأثرية المشيدة و فق معايير و أساليب العمارة المحلية و التي كانت و لا تزال في لحمة النسيج العمراني تخدم حارات المدينة المتنوعة. يستقر جامع المدينة قرب السوق ، و القلعة ، ليكون ملتقى أهل المدينة و سكانها. يتفرقون منه راجعين إلى مساكنهم ، أو ذاهبين إلى أعمالهم " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل الله" صدق الله العظيم. يذكر ناصر بن منصور الفارسي ثمانية عشر مسجدا و جامعاً أثرياً في مدينة نزوى. تتعاقب في سلك زمني يبدأ بمسجد الشواذنة الذي شيد في العام السابع من القرن الأول الهجري ، يتبعه مسجد سعال في العام الثامن من نفس القرن . و في عهد الإمام الوارث بن كعب(172هـ - 192هـ) بني مسجد النصر و كان اسمه سابقاً مسجد السوقية، ويليه مسجد الشيخ في عقر نزوى في العقد التاسع من القرن الثاني الهجري . و يأتي بناء مسجد الشجبي في مطلع القرن الثالث الهجري ، يليه مسجد أبي الحواري. و في ذات القرن بنى العلامة عزان بن الصقري اليحمدي مسجد غلافقا ، وبنى العلامة الحسن بن زياد النزوي مسجد الحسن. كما بني مسجد الأئمة و مسجد الشروق. و بنى العلامة محمد بن روح مسجد روح في مطلع القرن الرابع الهجري ، كما بنى العلامة مخلد بن روح بن عربي الكندي مسجد مخلد في نفس القرن ، و لعل مسجد أبي الحسن قد بني في ذات القرن. و في القرن الخامس الهجري بنى العلامة أحمد بن محمد الهنقري مسجد ابن الهنقري. وبنى الفقيه أبو عبدالله محمد بن أبي غسان النزوي مسجد أبي عبدالله. و في مطلع القرن العاشر الهجري بنى الإمام محمد بن اسماعيل الحاضري مسجد الإمام محمد بن اسما عيل. و بنى الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي(1649-1688م) مسجد اليعاربة في القرن الحادي عشر الهجري ، كما شيد الشيخ مسعود بن رمضان بن راشد النبهاني مسجد ابن أبي رمضان. و زخرت المدينة في العهد الزاهر بكثير من المساجد ، و أهمها مسجد السلطان قابوس. مسجد الشواذنة يمكن اعتبار مسجد الشواذنة أحد نماذج العمارة المحلية للمساجد في نزوى ، و يقع هذا المسجد في قلب محلة العقر. و يلاحظ عليه أنه مستطيل و لكنه عميق الشكل ، بمعنى أن محرابه يتوسط الضلع الأقصر من المستطيل ، و ليس العكس. و توافقاً مع مبدأ الحرص على الصلاة في الصف الأول يبنى المحراب في المساجد عادة في الضلع الأطول ، و يصبح المسجد ذا شكل مستطيل. و تتشابه هذه الحالة مع حالة مسجد نخل و عدد غير قليل من المساجد في عمان. و قد تعزى هذه الظاهرة إلى تضاريس الموضع ، أو لعلها تعزى إلى فتوى فقهية يحسن التعرف عليها. و يلاحظ أيضاً أن المسجد لا يحتوي على مئذنة، و قبة ، و هي ظاهرة سيطرت على غالبية عظمى من مساجد عمان . و برز في أسطح المساجد عنصر معماري يطلق عليه البومة ( قبة صغيرة مفتوحة من الأعلى أو من الجانب) ، و لعل وجودها خاضع لاعتبارات التهوية و الإضاءة القمرية. إن أغلب سقوف المساجد العمانية مسطحة ما خلا بعض المساجد ، كالمسجد الجامع في ولاية جعلان بني بوعلي و مسجد أولاد علي بن ربيع في ولاية صور ، حيث بني سقفهما من عدد من القباب الصغيرة . و من حسن الحظ أن رمم الأول ، و من سوء الحظ أن هدم الثاني في حملة أسبوع البلديات ، و أعيد بناؤه بصورة مشوهة. و نرى أن هذا التكوين المعماري لم يعد ماثلاً في المساجد المعاصرة التي بنيت في العهد الجديد ، إذ أصبحت المساجد مكونة بالإضافة إلى بيت الصلاة ، و صحن المسجد من مئذنة أو أكثر ، و قبة . وأصبح شكل المسجد في أغلب التخطيطات المعمارية مستطيلاً ، أي أن المحراب يتموضع في الضلع الأطول من المسجد. و برز المحراب إلى الخارج عن الحائط فتمكن الإمام من الصلاة فيه ، بعد أن كان المحراب في المساجد الأثرية غير بارز إلى الخارج ، و كان مطلاً على الداخل فقط . و كان دوره مقتصراً على الإشارة إلى اتجاه القبلة . زين المحراب في المساجد المعاصرة بالزخارف المختلفة إما بالجبس(النورة) على كامل جدرانه الداخلية ، أو في إطاره الخارجي. و أحياناً تبطن الجدران أو تبروز بالرخام ، أو البلاط المزخرف ، أو الخشب المنقوش . بينما انحصرت زخرفة المحاريب في المساجد الأثرية على تزيين الإطار بالنقوش الجبسية ، و نادرا ما تبطن كامل جدران المحراب بالنقوش. و إذا كان ذلك سمةً عامة في المساجد الأثرية في عمان ، إلا أن عددا من المساجد الأثرية في مدن أخرى ومنها قلهات على سبيل المثال قد تراءت عليها مظاهر التزيين ، و الزخرفة و صفها إبن بطوطة في كتابه الشهير تحفة النظار في غرائب الأسفار و عجائب الأمصار في قوله: "تحوي مدينة قلهات مسجداً من أجمل المساجد و أبدعها ، فجدرانه مرصوفة بالقيشاني الذي يشبه الزالج و يقوم على مرتفع يشرف منه على البحر و المرسى. و قد بنته امرأة صالحة يسمونها بيبي مريم ، و تعني كلمة مريم في لغتهم ( سيدة نبيلة)". و نرى أن لهذا التحول دلالة على التسامح ، و التلاقح ، و التواصل في سياق الفكر و الثقافة الإسلامية.
__________________
ديواني المقروء |
|
#6
|
||||
|
||||
|
تابع ورقة الكاتب - سعيد الصقلاوي:
السوق ينبغي النظر إلى السوق باعتباره مركز المدينة التجاري ، أو قلبها التجاري النابض بالحركة الاقتصادية ، و بالحياة الاجتماعية. و هو أحد المكونات الرئيسة الهامة – بجانب القلعة و الحصن و الجامع- التي يعتمد عليها كثير من مدن العالم الإسلامي ، و التي تتوجه منها وإليها حركة المجتمع. و يمكن اعتبار مدينة نزوى ممثلة لهذا النمط ، و نموذجاً لعدد كبير من المدن العمانية ، باستثناء مدينة صور العمانية و التي تعتبر مركز المنطقة الشرقية الإداري. يقع السوق الرئيس لمدينة صور(مركز المدينة التجاري) في القسم الساحلي منها ( صور الساحل / أم قريمتين) بمعزل عن أي من حصون المدينة ، و لكن أحد أسواقها يقع في بلاد صور بالقرب من الحصن. و إذا كان المسجد يعتبر مصدر إشعاع للحياة الروحية ، فإن السوق يعتبر كذلك مصدراً للحياة الدنيوية ، بغض النظر عن صغر و كبر المدينة. فهو المكان المشغول ، و المأهول ، وهو المكان الجاذب اجتماعياً , و اقتصادياً . لقد ظل السوق في العالم الإسلامي لقرون طويلة يعمل بجانب نشاطه الاقتصادي و التجاري على إتاحة الفرصة لاجتماع المواطنين ، و التقاء بعضهم بعضا ، و منحهم فرصة تبادل الأفكار و التشاور و التفاهم فيم يعني مجتمعهم ، و التعرف على مقتضيات أحوالهم الاقتصادية ، و الاجتماعية . و بالإضافة إلى ذلك فهو يسهل عملية التواصل مع المجتمع ، و مع إدارته المحلية الرسمية لقرب موقعه منها. من الناحية المعمارية ، يتكون السوق من وحدتين متقابلتين هما: السوق الغربي ؛ و السوق الشرقي. و من الناحية الاقتصادية و التجارية تتوزع بضائع الأغذية و المنسوجات و المعدات و الأدوات في محلات (حوانيت/ دكاكين) متقابلة ، و ذات أبواب خشبية في السوق الغربي ، بينما يحفل السوق الشرقي بمحلات و منصات اللحم و الأسماك . و رغم بساطة السوق في تخطيطه المعماري ، فإن المتسوق يتحرك فيه على محاور ثابتة و واضحة ، تمكنه من الاتصال بالحصن و القلعة و الجامع ، و تفضي به إلى مخارج و مداخل المدينة. و تمكنه أيضا من التلاقي بالآخرين و الاطلاع على المعروضات فوق منصات العرض التي تبدو واضحة ، متناسبة مع الغرض المخصصة له. لقد أصبح مبدأ الرزق عند مواطن الأقدام متحققا و مشهوداً في هذا السوق. إن اختلاط الأصوات الصادرة عن عملية الطرق في أثناء صناعة المشغولات الفضية ، و الذهبية ، و الحديدية ، و النحاسية ، و فناجين القهوة ، تشد الزائر ، و تثير سمعه. و تمنحه إحساساً بنمط السوق الشرقي . و تدعم ما المحنا إليه من الحراك الاقتصادي و التجاري فيه. يحاول دونالد هولي رسم صوره عامة لتخطيط و عمارة الأسواق المحلية في عمان فيصفها بأنها متشابهة إلى حد كبير . فيذكر " تجد السوق في معظم البلاد محاطة بأسوارها مما يسهل حفظ أمنها و حراستها في الليل . و تقوم منطقة السوق عادة على مقربة من القلعة التي تكون مركز الدفاع و السلطة في المنطقة . أما الشوارع فضيقة تقوم فيها الدكاكين صفوفاً ، و هي مربع الشكل تشرف مباشرة على الشارع و تقوم عادة على منصات مرتفعة. و يمكن إغلاق الدكاكين كلية في الليل ، إذ ليس للدكاكين واجهات زجاجية و لذا فإن صاحب الدكان يستطيع إحكام إغلاق دكانه بقفل خاص . و بعض الأسواق مغطاة بكاملها كما أن لبعضها شرفات عريضة تبرز من الدكاكين نفسها " . و نرى أن هذه الصورة العامة يصعب تعميم ملامحها الكلية على جميع الأسواق في مدن عمان ، و لكن قد تنطبق على بعض منها ، و قد تتشابه مع ملامح بعض الأجزاء منها ، أو قد تتماثل مع جزئيات الصورة فيها ، مثل الشوارع الضيقة ، و تغطية السوق ، و إشراف الدكاكين المباشر على الشوارع الضيقة . فصورة سوق مدينة صور يصعب اعتبارها مشابهة لنفس صورة سوق مدينة نزوى ، أو صورة سوق مدينة بركاء ، أو صورة سوق مدينة المضيبي ، أو صور سوق مدينة الرستاق . و لكن إيقاع السوق ، تنظيمياً ، و إدارياً ، و إنشائياً قد يتقارب إلى حد بعيد ، و إن اختلفت التفاصيل التخطيطية ، و المعمارية في سياق و نسيج الطابع العمراني العام. و برغم بناء سوق جيد بتقنية معاصرة تتوسل ملامحه محاكاة السوق القديم معمارياً إلى حد ما ، إلا أن الدور الهام الذي اضطلع به النمط المحلي لم يعد متوفراً في النمط المعماري المعاصر. لقد اتسع السوق ممتدا على الشوارع الرئيسية متخلياً عن مركزيته. و أصبح التنقل و الحركة للوصول إلى بعض محلات و مكوناته بالسيارة عوضاً عن السير على الأقدام ، ففقد شيئا من دوره في التواصل ، و التعارف ، و التلاقي. فتراجع دوره في الحراك الاجتماعي ، و إن ظل التبادل التجاري نشيطا. لقد أخذت الدول الغربية و من بينها المانيا بفكرة مركزية السوق كي يكون مكاناً للاستمتاع و الاتصال بين المواطنين بجانب التبادل التجاري و النشاط الاقتصادي. فحولت طرق السيارات ممرات للمشاة و المتسوقين . و أوجدت فراغات تشكل نقاط تجمع و التقاء . يرتاح في فضائها المتسوق ، و يتزود من محلاتها المحيطة بها ، و يستمتع بجولته في السوق ، و يمارس فيه انسانيته. منطلقات نظــــرية العمـــارة التحصينية عملية البناء والتشييد ومنها القلاع والحصون في عُمان يدعمها ارث حضاري ضخم تمتد جذوره الأولى إلى ما قبل التاريخ الميلادي وما زال هذا الموروث يتفاعل مع تطور حركة العمران بحسب الظروف والأحوال التي تكتنف الواقع العُماني . وهذا الموروث يشكل المرتكزات التي تتمحور عليها ديناميكية الحركة بغض النظر عن مدى قوة الدفع التي تعتبر مؤشرا هاما وحيويا في نشاطها وازدهارها. لقد كانت عملية التحصين لدى الإنسان العُماني بالغة الأهمية، ومن المؤسسات التي ارتكزت عليها حركة التعمير في المستوطنات القديمة. فاحتلت القلعة أو الحصن مكانا بارزا في مخططات المدن، إدراكا بقيمة الدور الذي يتميز به عن باقي المؤسسات في تامين مصالح البلاد، وكسرا لحدة الرغبة لدى المناوئين، ومنعا للتفكير في سهولة إمكانية تحقيق مآربهم. فلقد دلت الاكتشافات في منطقة بات من عبري على وجود أبنية ذات تحصينات مختلفة، ومنها على شكل دائري أو على شكل خلية النحل وبعضها تحصينات دفاعية يرجع تاريخها إلى الألف الثالثة قبل الميلاد، وهذه التحصينات كانت على شكل برج يصل قطره إلى عشرين مترا، ويرى الأثريون انه ربما كان ارتفاعه في حدود عشرة أمتار ( ). قامت نظرية الدفاع الحربية العُمانية على مرتكزات عدة وعلى موروثات تمتد في تاريخها إلى ما قبل الإسلام وعلى الأخص إلى ما قبل الألف الرابع الميلادي مرورا بالعصر الجاهلي وانتقالا إلى عهد الخلافة وتعريجا إلى القرن السادس عشر والسابع عشر ووصولا إلى القرن العشرين. وانطلقت تلك الموروثات من أبعادها المختلفة شكلت فيما بينها نسيج النظرة الاستراتيجية الدفاعية، وأكدت على ان هذه النظرة لم تعول على عامل منفرد ومحدد بذاته، وانما تشابكت في تشكيلها كافة العناصر اللازمة والضرورية باختلاف الحقبة الزمنية وباختلاف وسائل القتال وتعدد أنماط التحصينات وباختلاف المستوى الحضاري للمجتمع فظلا عن القدرة الاتصالية بحركة الزمن في المحيط الدولي وعن كيفية التفاعل معها والتعامل بمنطقها. يعتبر التاريخ العُماني أحد المرتكزات الحيوية التي اعتمدت عليها نظرية الدفاع . فالخبرة التي تمتد إلى حضارة أم النار والتي أبانت عن بعض جوانبها التحصينات الأثرية القديمة التي عثر عليها في منطقة بات بالبريمي والتي يعود تاريخها إلى الألف الرابعة قبل الميلاد، تنوعها من قلعة إلى سور إلى حصن دل على وجود الخبرة المكتسبة في هذا المجال. لقد كان قتال العُمانيين ومحاربتهم غيرهم من الغزاة ناتجا عن إيمانهم بعدم القبول بالظلم أيا كان نوعه سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا. كما ان قتالهم لبعضهم في صورة حروب أهلية قد شهدت عليه مسيرة التاريخ العُماني على نحو أخص في مواضع مختلفة وفي حقب زمنية متباعدة وأخرى متقاربة نابع من مقاومتهم للأعداء وذمهم للشر . أما المستوى الفكري والحضاري فهو ينبعث من الإرث التاريخي الضخم للمجتمع العُماني معتمدا على أساسيات نهجه الرئيسي وهو الذي هيا الأسباب للعُمانيين لإيجاد الوسائل التي مكنتهم من امتلاك أمرهم من خلال توافر المعرفة بكيفية تعاملهم مع الأحداث وسيلة وحركة و هدفا. ويعتبر الاتصال الدولي من العوامل الهامة التي أثرت في نظرية الدفاع أو الحرب. فلقد تمكنت عُمان بفضله من التعرف على الوسائل القتالية التي يتعامل بها العالم في مختلف مناطقه وعلى امتداد أزمنته فعلاقة عُمان بالهند وفارس والدول الغربية( ) أتاحت الفرصة لكي تتطلع عن كثب على ما لديهم من تقنية في صنع السلاح وكذلك إمكانية استيراده والاستفادة منه، وبالتالي حدث تطور في استخدام الوسائل من سهام إلى بنادق، ومن مجانق إلى مدافع وقد اثر ذلك على العمارة الحربية والأبنية الدفاعية فبدلا من المزاغل لرمي السهام استحدثت الفتحات لإطلاق النيران من البنادق وكذلك استحدثت منصات الْمدافع ، وروعيت هذه الأساسيات ، كما أفاد ذلك في قيام صناعة حربية للمدافع ، والبنادق ، والذخيرة ، وكذلك السُفن الْحربية (انظر الرسومات). وبالتالي فان النظرة الحربية أو الدفاعية العُمانية قامت على ثوابت تتمثل في التاريخ المجتمع وأخرى متغيرة تتمثل في المستوى الحضاري والفكري وكذلك الاتصال الدولي ونعتقد ان هناك أمورا أخرى تفصيلية تنبثق من الثوابت والمتغيرات المشار إليها وان هذه العوامل جميعها لعبت دورا هاما وبارزا في تخطيط التحصينات وفي اختيار مواقعها وفي عملية بنائها وهيكلية إنشائها وتنوع أنماطها واختلاف أشكالها. والناظر إلى خارطة عُمان تتكشف له حقيقة واضحة المعالم مردها ان على الساحل تنتشر عديد من المدن والحواضر العُمانية في أقصى الشمال مرورا بالشرق وانتهاء بالجنوب وهذه المدن تعتبر بمثابة ثغور من جهة البحر تختلف أهميتها باختلاف موقعها من مسرح الأحداث ومن ضمن هذه المدن على سبيل المثال لا الحصر صحار وصور وقريات وخصب وبركاء ومرباط وصلالة ومسقط وغيرها. كذلك استفاد العُمانيون من منحدرات الجبال في بناء التحصينات قدر استفادتهم منها في النواحي الزراعية وبالتالي هيأ ذلك لظهور عمارة شبة تحصينه أو حربية تكاد تنفرد بها عُمان دون غيرها في المنطقة على الأقل حيث استخدمت في بناء تحصينات مدرجة على شكل بيوت في الجبل الأخضر على نحو أخص غير اننا نميل إلى ان استخدامها للأغراض السكنية كان اكثر من استحكامات حربية ( ) . تكاد ان تنحصر الأشكال التي انتظمت فيها التحصينات العُمانية في نماذج محدودة ومألوفة في جميع الأبنية إذ ألقت بظلها على الأبنية المحلية الأخرى كالمساكن والمساجد والمدارس القديمة ومكاتب الجمارك(الفرضة) في السابق وغيرها. فمن خلال الدراسة التي أجريناها على عدد لا باس به من أبنية التحصينات في مختلف المناطق العُمانية اتضح لنا ان الأشكال المتداولة منها المستطيل، مثل(قلعة بركة الموز والراوية،العربي الخ) ومنها المربع، مثل(قريات وراس الحد وافي وبدبد، الخ) ومنها الدائري واشهرها قلعة نزوى ومنها البيضاوي ويشخص ذلك واضحا في مبنى البرج الرئيسي وقلعة الرستاق(القلعة)، ثم الثلاثي الشكل الذي يظهر في حصن السيب حيث يعتقد انه برتغالي( ). كما ان الاكتشافات الأثرية في بات قد قدمت إلينا نموذجين من التحصينات ربما كانا سائدين وهما الشكل الثلاثي أو المثلث والشكل الدائري في صورة برج ضخم( ) . ونعتقد ان جغرافية الموضع وطبوغرافية الأرض قد لعبت دورا في تحديد شكل المبنى إلى حد ما وهذا أمر متعارف عليه في علم هندسة البناء وفي النواحي المعمارية والإنشائية وكنتيجة منطقية للتطور الفكري الحربي لدى العُمانيين فان التحصينات التي شيدت في مختلف مناطق عُمان خضعت لمبدأ التطور في هيكلية بنائها وما عمليات التجديد والإضافات التي أدخلت عليها(كصحار والرستاق والجلالي والميراني، الخ) إلا انطلاقا من الادارك بضرورة ذلك وحتميته وقد تنبه حكام عُمان منذ عهد اليعاربة إلى هذا الجانب ومما لا شك فيه ان هذه التعديلات وليدة الخبرة المكتسبة وتطور الأساليب القتالية ووسائلها من البنادق والمدافع وغيرها دون الاستغناء عن الوسائل التقليدية من السهام ومجانق وسيوف وغيرها، ذلك ان الوسائل المستجدة لم تلغ سابقتها كليا وانما ظل هناك ما يشبه المراوح في استخدامها معا وبدا التخلي عن الوسائل التقليدية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين غير ان عددا يسيرا تمثل في السيوف والخناجر ظل يستعمل محليا على نطاق ضيق وبعيد عن التنظيم الرسمي. ولذا فإننا نلاحظ في بعض التحصينات العُمانية وجود المزاغل التي تستخدم في رمي السهام بجانب فتحات طلقات البنادق التي كان يتخذ لها أماكن متفرقة من البناء التحصيني فوق المداخل وبعضها داخل نطاق السور(كحصن جبرين والحزم وصحار،الخ) ثم وجود الأبواب المتعددة ذات المستويات الارتفاعية المختلفة والعروض المتفاوتة وما يتبعها من دهاليز وممرات سرية فضلا عن وجود فتحات لصب المحروقات على المهاجمين كما في حصن الحزم وقلعة نزوى، وذلك بجانب الكوة، والمراق اللتين تطلق منهما النيران وبخاصة نيران البنادق. وامتازت بعض التحصينات بتفردها المتطور عن غيرها بحيث تركز بناؤها على إمكانية قدرتها لتحمل القذائف المدفعية كقلاع مسقط(الجلالي والميراني ومطرح،الخ) وبالتالي ظهرت فيها منصات المدافع وفتحات وكوي لإطلاق نيران البنادق ونرى ان هذه الميزة قد توفرت أيضا في قلعة نزوى وروعي ذلك عند تخطيطها وإنشائها وتم تدعيم القلاع القديمة(كالرستاق وصحار ونخل،..الخ) لتأخذ نفس الفرصة فيظل وجودها ديناميكي الحركة والنشاط. وخضعت الأسوار أيضا إلى مثل هذا التطور إما بتعديل القديم أو إنشاء الجديد وفق المستجدات الحربية فاختلفت عروضها وسماكتها وارتفاعاتها بحيث اصبحت صالحة كممرات ومماشي للجنود يمارسون من عليها اطلاق النيران كما ان اصبحت تستخدم ذات الفكرة في الحوائط العلوية للابراج الكبيرة كقلعة نزوى(انظر الرسوم) وتطورت بعض الأسوار إلى ان زودت بأبراج متقدمة على امتداد السور وفي اغلب الأحيان يكون تصميمها نصف دائري وذلك بغرض جعل قوس النار يكون اكثر انتشارا في محيط الإطلاق (سور صحار وسور جعلان بن بو حسن). واشتركت التحصينات من المباني مع الأسوار في الاستفادة من الشرفات والمتاريس وكذلك الأبراج المقامة فوق المداخل (حصن جبرين، أسوار قلعة الرستاق وبركة الموز وسور مسقط، الخ)حيـث تجاوبت مع متطلبات الوسائـل القتالية الحديثة. وتطورت أماكن تخزين العتاد من مخازن بسيطة للأسلحة التقليدية إلى مبان يخزن فيها عتاد من الذخائر الحربية للمدافع والبنادق مما استدعى مراعاة ذلك أثناء التفكير في تعديل القديم أو إنشاء الجديد كي يتلاءم المبنى مع الوسيلة المخزنة. وكما اختلفت أشكال الأبراج اختلفت أيضا أقطارها حسب النوع التحصيني وموقعه فمنها بلغ قطر برجه 6 أمتار (كحصن أفي) ومنها 7 أمتار (بيت الفلج) وغيرها 9.6 مرا (كحصن العوابي) ومنها 11.9 مترا (كقلعة الرستاق) وتعد قلعة نزوى اضخم برج إذ وصل قطرة إلى ما يزيد عن 37 مترا( ) وإنما أوردنا ذلك على سبيل المثال للتدليل على التطور في استخدام الأبراج حسب الوظائف المستجدة عليها( ). وترتب عن الاختلاف في أقطارها اختلاف في سماكة أسقفها وكبر دعائمها وهذا معروف في علم هندسة الإنشاءات( ) فكلما كان بحر السقف كبير كلما زادت سماكته وكذلك كبره وعدد دعائمه والعكس صحيح وهذا مرتبط أيضا بحساب الانتقال والأحمال فضلا عن الاهتزازات التي تحدثها طلقات القذائف المدفعية وهذا التشكيل البنائي قد عرفه العُمانيون منذ الألف الثالثة قبل الميلاد كما عرفه العرب في الأندلس( ). أما الخنادق فلا نكاد نلمح عليها تطورا ملموسا كمثل الذي اتخذه الرشيد في تحصين بغداد حيث انه كان يفضل الخنادق عن بأسوار عالية ومن قبله الأمويون( ) وإنما اتخذت الخنادق شكلها البدائي فيما عدا تلك التي حفرت حول حصن الخندق بالبريمي حث بطنت بالحجارة وكذلك خندق مسقط( ). تشير الكشوف الأثرية إلى ان الإنسان في القديم قد عرف أنواعا من مواد البناء واستخدمها في تشييد تحصيناته ومنها الحجارة الضخمة المنتظمة ذات المقاسات المختلفة (1×1×0.8متر) والتي كان يوضع بعضها فوق البعض بدون ملاط يربطها( ). وقد شاعت مثل هذه الطريقة عند الفينيقيين فظهرت في آثارهم بمدينة قرطاج( ). كما استخدم العُمانيون أنواعا من الطوب المشوى أو الطوب الأحمر ذات الأشكال المتعددة منها المربع والمخروطي والمستطيل ويبدو ان الطوب المخروطي(المقطوع) كان يستخدم اكثر في المباني الدائرية وفي الأقواس لتناسبه مع ذات التشكيل بعكس الطوب المربع الذي يتلاءم مع المباني الركنية ذات الزوايا الحادة غير ان الطوب المستطيل يتميز بإمكانية الاستخدام في التشكيلين الدائري والركني. واستخدام الأحجار ذات الأحجام الصغيرة اقتضى في المقابل استخدام كميات اكبر من الملاط وكذلك بالنسبة للطوب بمقاساته المختلفة وأنواعه المتعددة لان الملاط قد تراوح بين الطين اللبن والصاروج مع إمكانية التكسية بالجص وأحيانا للأسطح أو بالطين اللبن نفسه واستخدام الصاروج بالاضافة إلى ذلك كمادة عازلة للأسطح من المياه حيث يتوفر فيه خاصية عدم التسريب. وهناك بعض مواد البناء التي استخدمها الإنسان العُماني ومن خلال عطاء البيئة له. ويعتبر الخشب من جذوع النخل وأشجار السمر والسدر والجوز وغيرها من العناصر الهامة التي دخلت في تشيد الأسقف وصناعة الأبواب والشبابيك والمشربيات واستخدمت كعوارض أو جسور تعرض فوقها الأسقف بمساحاتها المختلفة كما استخدم كأعتاب للأبواب والشبابيك كفواصل للجدران وكدعائم للأقواس والعقود. كما استخدمت البسط والسميم وسعف النخيل في تهيئة أرضية الأسقف ومن ثم زخرفتها ايضا. ويستخدم الجص كمادة واقية تظلي بها الجدران من الخارج وأحيانا من الداخل ثم استخدم في أعمال الزخرفة الفنية كالمشبكات والمزررات فوق العقود والمقرنصات وغيرها. ويلاحظ أيضا ان القصور والبيوت المحصنة كجبرين والحزم والبيت الكبير في إبراء وبيت السيد نادر وغيرها هي التي تظهر عليها مظاهر الترف والذوق الرفيع من خلال ما تتميز به من زخرفات ونقوش على جدرانها وأسقفها وشبابيكها وهي بالتالي بالرغم من محاولة جعلها صارمة الملامح إلا ان الرقة والفخامة تطغى عليه .في حين ان القلاع والحصون الأخرى كنزوى والرستاق والجلالي ومطرح وغيرها تمتاز بالصرامة والقوة ومرد ذلك في اعتقادنا إلى الوظائف المخصصة لكل منها. ويرى بعض الباحثين ان تأثير العمارة الصفوية كان باديا للعيان في حصن جبرين( ) من خلال الأقواس المدببة المستخدمة داخل وخارج المبنى وكذلك من خلال العوارض الخشبية التي تربط بين الأعمدة ويرى آخرون ان تأثير مغوليا يوجد في بيوت إبراء ومسقط ويعزون ذلك إلى الاتصالات بين عُمان والإمبراطورية المغولية في الهند ومه احترامنا لهذا الرأي إلا انه ربما جاء الأول باعتبار ان الدولة الصفوية قامت عام 888هـ( ). وان الدولة اليعربية قامت بعدها بفترة طويلة تصل إلى قرن تقريبا. وبالرجوع إلى تاريخ العمارة العربية في الأندلس على وجه الخصوص نجد ان مثل هذه الأقواس قد استخدمت في مسجد قرطبة( ). وكذلك العوارض قد استخدمت في الجامع الأزهر بالاضافة إلى قرطبة وان المقرنصات والمزررات وغيرها، كلها عناصر معمارية ناتجة عن الحضارة الإسلامية( )، وان هذه الحضارة هي نتاج الفكر الإسلامي الذي امتزج فيه العربي بالأعجمي وهذا الفكر كانت له منطلقات ثابتة ومشارب واحدة اتفق عليها جميع المسلمين أخذا وعطاء وهذه الأسباب ترجع تشابه أنماط التشكيل والتصميم المعماري، وإلا كيف نفسر وجود قوس مغربي في نقش على باب في صور( ) وكيف نفسر النقوش والزخارف على شبابيك وأبواب المباني في المنطقة الجنوبية وان عملية الابتكار هنا قائمة على معادل موضوعي وهو الفكر الإسلامي روحا ومعنى وشكلا وجوهرا. وان القول بان أساليب البناء تعرضت لتأثيرات غربية وأفريقية وان التصميمات حاكت بيوت البرتغاليين فيه شئ من الاحجاف ذلك اننا نقبل مبدأ التأثير والتأثر الخاضع لطبيعة الاتصالات الدولية ولكن لا يمكن ان نطلق على تصميمات عربية شكلا ومضمونا أنها نسخة من البيوت البرتغالية خاصة و ان البرتغاليين كانوا فقط على السواحل . وعلى أية حال فإننا نخلص من ذلك إلى ان بعضها مختلط الوظيفة ومتشعـب الاستخدام كجبرين والحزم والرستاق التي استخدمت كمدارس وسكن وكذلك كثكنات عسكرية للدفاع بالاضافة إلى كونها مراكز حكم إدارية وبعضها كانت وظيفته حربية بحتة كقلعتي الجلالي والميراني وكالأسـوار المحصنة في الباطنة وجعلان وغيرها .وهذا يسوقنا لطرح قضيـة الشكل والوظيفة في العمارة الحديثة( ) وعودا إلى ما ظهر من مظاهر الفخامة والترف والثراء في جبرين والحزم وكذلك في بيت السيد نادر وبيت النعُمان وغيرها من القصور المحصنة نرى ان وظائف هذه الحصون الرئيسية التي مارستها كانت وظائف سلمية إنسانية وان زخرفتها دليل عليها ثم ان تخطيطها من الواجه التصميمية كان معدا للغرف ذاتها وبالتالي جاء منسجما مع وظيفته وقد ابرز ذلك تنـاسق كتلها مما هيـأ لها واجهات متسقة معها. بيد ان القلاع ذات الوظائف الحربية كالجلالي ونزوى والميراني ومطرح وغيرها قد تعارضت وظيفتها مع شكلها فلم تظهر فيها أعمال الزخرفة ولو ظهر ذلك لكان مناقضا لما هي عليه من صرامة وحدة وجلال وهيبة ولكـانت أيضا تلك الزخرفات متعارضة مع تشكيلها الكتلي واتسـاق واجهاتها . وبالتالي جاءت مخططاتها من حيث التصميم متنـاسبة مع الوظيفة المخصصة لها . وبدارسة الحركة داخل هذه المبـاني وبين مكوناتها يعـزز ما أوضحناه من تمازج الوظيفـة مع الشكل وتناسقهما وانسجامهما. ولابد أيضا ان نشير هنا إلى البيئـة العُمانية التي أمدت هذه العمارة بكثير من الميزات جعلتهـا صامدة في وجه الزمن عن طريق مواد البناء المحلية المتعايشـة مع البيئة في حرها وبردها وفي جدبها وخصبها وكذلك من حيث تشكيل الطبوغرافيا من جبال وهضاب وأودية وتلال شكلت واجهات هذه التحصينـات وجعلتها جزاء لا يتجزأ منها وخير دليل على ذلك قلعة نخل التي تتعانق مع الطبيعة في تشكيل فني رائع جميل.
__________________
ديواني المقروء |
|
#7
|
||||
|
||||
|
المكان في الرواية العمانية الحديثة
– المفهوم والدلالة والتأويل- للكاتبة د. عزيزة الطائي 5/1 المقدمة يحتل المكان حيزا مهما في الدراسات السردية، حتى عَّد مع الزمان دعامتين أساسيتين يرتكز عليهما البناء الروائي. إن تحديد المكان من السمات التي ميَّزت الرواية في القرن التاسع عشر، وقد أشار إيان وات(Ian Watt) إلى هذا التحول الذي طرأ على تشكيل الرواية"(239). ويأتي الاهتمام بالمكان في هذا المبحث كنتيجة تتعلق بالهوية وارتباطها بالبيئة، مقابل رغبة في تطوير الذات، واستعادة علاقة فاعلة بين الذات والمكان لتحديد هذه الهوية. والحق أن الرواية في كلِّ ذلك لا تكشف عن المكان بقدر ما تكشف عن نفسها. إذ ينبهنا عرضها له، وحضوره فيها إلى مقامه منها، وأثره الفاعل فيها، ومساهمته الجليلة في بناء عالمها. ومعنى ذلك أنْ لا بد من توازي المقاربة الأولى، وتكمِّلها مقاربة معاكسة نتخذ فيها من المكان مطيَّة إلى الرواية لنعرف ما أهَّله ليكون معدنا من أهم معادنها، وما تحتاج إليه من الطرائق والفنيات لتحوِّله إلى مادة فنية سردية، وهي في ذلك تتوسل إستراتيجية متعددة العناصر. منها إدراكها لأهمية توزيع الفضاء في الإشارة إلى منابت الشخصيات، وتحديد مواقعها، وضبط محتوياتها، واتجاه حركتها، ورسم مواقفها، ومدِّها بالدوافع إلى الفعل. ومنها الحرص على أن تتوفر له العمارة المناسبة؛ لأن "كيفية التعامل مع الشخصيات مع ما استقر من الأشياء والموجودات هي المولدة للوعي، وهي المساهمة في إنشاء المواقف والحوارات. ومنها أيضا العمل على اختيار هيكل عام للمكان تجد فيه بنية العالم الروائي دعائمها وأسسها، وتشتق مما اجتمع عنده من أنواع الفضاء، وما انعقد بينها من الصلات معانيها ودلالاتها"(2). ولا شك في أن الرواية تصدر مزاولتها هذه للمكان عن رؤية أيديلوجية عامة تجد فيها شتى مظاهر الفضاء، وإن تعددت وتباينت مناط تجانسها وترابطها. والحق أنَّه حيثما تولَّى بنا النظر في الفن الروائي طالعنا المكان، حتى لنكاد نقتنع بأن لا سبيل إلى الاستغناء عن دراسته؛ إن شئنا الإحاطة بصناعة الرواية إحاطة جيدة. وقد كان بالإمكان أن نقتصر على ما بسطناه من شؤون المكان والبحث في كيفية تعاطي الرواية العمانية له وتوظيفها إياه، ولكن هذا المسعى على أهميته القصوى واقتناعنا بأنَّه يمكن أن يكون مبررا وجيها للإقرار بضرورتها، لا يمثل إلَّا جزءا من الموضوع وبعضا من مراميه. والإشكالية الرئيسة لا تكمن فيه، وإن كانت تحتاج إليه، بل تكمن في الطرف الثالث الواجب اجتماعه إلى الطرفين السابقين: الرواية والمكان. ونعني به المجتمع أو الإنسان عامة؛ لأن الإنسان هو المتصرف في الفضاء، وهو المنتج الفعلي لدلالات هذا الفضاء، والرواية نفسها تجهد لتكون نسخة من عالمه، وعينه من بعض مناحي واقعه. وطالما أن هذه الدراسة تعنى بدراسة المكان في الرواية العمانية الحديثة؛ كان حريا بنا الوقوف على دلالاته؛ حتى يأخذ بعدا أكثر تخصصا وعمقا فيما يتعلق بطبيعة بنيته، من خلال انتقائنا لثلاث روايات عمانية، اختلفت رؤاها الفنية عند معالجة المكان، وهي: - المعلقة الأخيرة لحسين العبري الصادرة عام 2006 - همس الجسور لعلي المعمري الصادرة عام 2007 - سيدات القمر لجوخة الحارثي الصادرة 2010 5/2 دلالة الجسور في رواية المعلَّقة الأخيرة تطرح رواية المعَّلقة الأخيرة لحسين العبري(*)، أسئلة جوهرية في أصل الأشياء والعلاقات، وحول الإنسان وحضوره في المجتمع، كما تنطلق التساؤلات إلى آفاق الهم الإنساني (المطلق، الوجود، الأمان، التجذر، الحرية، المواطنة). إن حضور الخيال في هذه الرواية، وما يحمله الرمز من إيحاء؛ حوَّل العمل الروائي وسما به من الواقعي إلى الفني. حتى أصبح فيه "الجسر هو غير الجسر، والمشنقة غير المشنقة، والمصر غير المصر(*)! "فكلّ شيء سيكتسب صفات أخرى تعمل على بناء الصورة السردية"(8) التي ستعكس ما يدهش ويربك. تحضر الجسور في رواية المعلقة الأخيرة لحسين العبري في مواضع، وأشكال على مسار السرد الحكائي، لتعبر عن امتصاص كامل للحياة الإنسانية؛ وحضورها يأخذ ثلاثة أنماط، هي: - النمط المفهوم، وهنا يتجلى مفهوم الجسر بمعنى الانتقال إيحائيا دون ذكر للفظة الجسر. فالجسور تحضر بالمعنى التواصلي مع العالم الخارجي، والانتقال من المكان الضيق إلى المكان الأرحب؛ إذ يرتبط مفهوم الجسر بدلالات مكانية أخرى كالبيت والمكتب والشارع والحمَّام والمرآة، ومن أمثلة ذلك قول عبدالله بن محمد واصفا "كان ينظر إلى المرآة في حمام غرفة النوم بعد أن أخذ مصَّره البني اللون ليلبسه. حاول لفّ المصَّر على رأسه فلم يستطع أن يحكم ربطته النهائية لأن تلك النظرة في المرآة أشعرته أن شيئا مهما كان يعتمل داخله ويدوم ويطفو أخيرا على سطح تفكيره. بالطبع لم يكن شيئا في الحمَّام، ولا في المرآة، فلم يكن ثمة شيء مختلف هناك عن ذي قبل. لا بد إذن أن يكون التغيير الحاصل كان كامنا هناك في داخله. حاول لفّ المصَّر مرة أخرى لكنَّه للمرة الثانية، لاحظ أنَّه لم يستطع أن يعقد الربطة النهائية بشكل جيد. هو يعرف أنَّ الأمر هو أنّه في حالة وجد مستعصية، وأن المشكلة هي ليست بالضبط في داخله هو، بل إنَّها كانت هناك تتدلى في البعيد معلَّقة على الجسور، ومصورة ومكتوبة على قصاصات جرائد مثبتة على لائحة مكتبه"(240). نلاحظ ارتباط مفهوم الجسر من خلال علاقته بالمكان العالي بدلالات جمالية ونفسية، إذ أن المرآة تقدِّم جسرا نفسيا ينقله من حالة المكان المحدود المقيَّد (داخل البيت) إلى حالة المكان الرحب المتمثل بجزئيات مدينة مسقط بكل ما تضج به من حيوية وجمال وصخب. المكان العالي هنا، يمنح إمكانيات التأمل والتدقيق في الكون، وبالتالي الإبداع، من المرآة كمفهوم انتقالي/ جسري، هي محرِّض على الإبداع، وبالتالي تجسير العلاقة الداخلية النفسية مع المصَّر، من خلال معطى التأمل الذي تبعثه المرآة، وقد يشكل الحاجز الزجاجي الشفَّاف للمرآة، بعدا مؤلما داخل الحمَّام "وأثناء لبسه لمصّره كان يفكر في قضية الجسر التي كانت بالنسبة إليه قضية مهمة. الحق أن العديد من الناس هذه المرة كانوا يعدّون هذه القضية مهمة"(241). فمواجهة المرآة بفاصل زجاجي جعل الإحساس مزدوجا، فلبس المصر البني ومواجهة المرآة في آن واحد، له دلالة الجسرية التي يضيفها المكان من خلال الانتقال من حالة إلى أخرى، من حالة السلب إلى حالة الإيجاب، من حالة اللاجمالي إلى حالة الجمال، من القديم إلى الحديث، ومن الألم إلى الأمل هذا الانتقال الذي كان سينعدم فيما لو انعدمت المرآة. في هذه الرواية لايمكن أن نفصل بين عالمين يشكلان المكان: الداخلي والخارجي، فهما متشابكان إلى حد التعقيد، وهما مسؤولان على تشكل الصورة السردية في سير الأحداث وتطورها، وحركة الشخصيات داخل الفضاء السردي، وفي تنوع وتلون الأمكنة والأزمنة. وفي الحوار مع النفس المشبع بالتساؤلات القلقة. إن الخلاص الذي تمَّ على الجسر لم يكن خلاصا مقحما من قبل الكاتب. إن الصورة السردية تكشف عن عنصرين جوهريين في عملية بنائها، وهما "عنصر التواصل وعنصر فعل الموت"(242). فحين تتوقف القراءة عند جسور: القرم والجسر الجديد وجسر داخلية البلاد فإنها ستعتبرها أداة للتواصل. إنها أدوات تربط بين ضفة وضفة، أو بين مرحلة ومرحلة، أو بين عهد وعهد في فترة انتقالية تمتاز بالتوتر والقلق، فترة تحولت فيها القرى الواقعة بين الجبال الوعرة، إلى مدن حديثة متطورة. - النمط الفني، وهنا يحضر مفهوم الجسر عبر الرؤية التي يرسم عليها البطل الجسور كما مثَّلت في ذاكرته، مع مراعاة الأبعاد الفنية والنَّفسية والدلالية لموظف بسيط في دائرة الوطن. تحضر الجسور مع المشانق المتدلية من على هذا الجسور، ومع المشانق التي شاءت الرواية أن تتدلى من على أماكن أخرى، والأشياء التي تختفي وراء ألوان المصار (بني، أزرق فاتح، أزرق غامق)، وبالأخص المصر الأزرق الغامق، وقد تصدرت واجهته في المقدمة بالاهتمام. لإننا لا نعثر على مشانق مصنوعة من حبال رخوة أو غليظة تتدلى من على الجسور أو من على النخيل أو من أي مكان عالٍ تلفت الأنظار وتستميل الأفئدة الواجفة تحضر عبر تشكل الصورة السردية، وإنما سنصادف لونا آخر من المشانق لا ترعش إلَّا من له القدرة على احتواء الوجود بكامله في لحظة تختزل كل الأمكنة والأزمنة في صور وأشكال لا حدود لها. هذه الصور والأشكال التي كانت موجودة منذ الأزل وتتجدد باستمرار. إن المشنقة أو المعلقة غير المرئية، وهي تتخذ أشكالا مخالفة في إحساس كل إنسان على الأرض، وبين هذه المشانق التي تتدلى على جسور من الإسمنت والحديد أو من جريد النخيل أو من كل شيء يملأ العين ولا يمس ما ورائها، فتمتد إلى النساء ومصممي الديكورات، بل وحتى أكياس الشاي من خلال هيئتها الدائرية. بحيث ستبدو عملية غمس الشاي في كوب ماء عملية إعدام لذيذة؛ وبعد ذلك كلِّه ستمتد القضية إلى أطفال المدارس الذين "سيتعملون في مناهجهم الدراسية؛ وفي الرياضيات التطبيقية: كيف يعدون عدد الأفراد الذين يمكن لرقابهم أن تعدم داخل مشنقة واحدة"(243). هذه هي العوالم التي كان يتحرك البطل داخلها؛ ويحاور الأشياء، مرة وهو ينظر إلى مصرِّه الغالي ذي اللون الأزرق الغامق بعد أن يربطه بإحكام، ومرة ثانية على اللائحة المعلقة في مكتبه "انتصب عبدالله طويلا أمام اللائحة بعد أن سلَّم على زميليه محدقا في قصاصات الأوراق المثبَّتة. كان الحبل المشنقة منتصبا في صورة كبيرة على جسر القرم، وثمة حبل آخر منتصب على الجسر الجديد، وثالث على جسر داخلية البلاد"(244) في الوقت الذي كان "يحك جسده أكثر من مرة، ويشعر بألم خفيف يتآكله على الكتفين وأعلى الظهر؛ ويشعر بتوتر يظهر على هيئة عرق خفيف ينتج على ظهره أولا ثم رقبته"(245)، وكأن في ذلك نوعا من التعبير عن الإحساس بالوخزة الإحساس الحارق، والوخزة الجاثمة، والشعر الأبيض الذي يشع على الصدغين والذقن و"الصدفة التي ابتناها لنفسه واستطاع أن يخفيها عنا مدة عشرين سنة"(246). إن هذا الداخل هو المسؤول، لكن الواقع السردي سيفرض العالم الخارجي أيضا "إذ لو كان الأمر أمرا مهما وذا شأن؛ لكان اقتنع في داخله؛ إن القضية تستحق أن تتصدع صدفته بسببها. لكن أن يكون السبب خارجيا شيئا بعيدا ومعلقا على الجسر؛ شيئا هامشيا، فهذا ما لا يستطيع فهمه"(247). وانطلاقا من هذه الرؤية ينطلق بطل الرواية عبدالله بن محمد في تقديم رؤيته للمكان، ليس بوصفه مكانا عيانيا مشاهدا، وإنَّما بوصفه كتلة من المشاعر والأحاسيس التي يضفيها الإنسان المأزوم على المكان، فينقله من دائرة المشاهد والعيني، إلى دائرة الفني المتخيل الذي يطفح إنسانية. فالمكان الفني الذي يسكننا لا الذي نسكن فيه، وهذه الدلالة هي ما يمكن أن نلحظه في تعليق البطل على علاقة المشانق بالجسور"لم يكن عبدالله آنذاك قادرا على إدراك ما الذي كان يفعله حقا. كان كل ذلك الجمهور الحاشد ينتظر منه شيئا. فكان لا بد له أن يفعل شيئا"(248) فالمقطع السابق يلخص علاقة المكان/ الجسر الذي يعد معلما من معالم المدينة الحديثة، المكان/ البطل مسقط وحضوره في الأماكن التي يراها، وهو يوجه مصَّره الأزرق الغامق ليشكل نهاية ما يدور في الذهن، وبهذا يتحول الجسر بالمصَّر الأزرق إلى مكان للإبداع ليفصح عن وجع الذات التي تستحضر ما هو غائب لتشخِّصه بصريا عبر مشهد النهاية بالانتحار من على الجسر، وكأن في ذلك كسر لحالة الضياع التي يعيشها عبدالله بن محمد"استغرق الأمر أكثر من خمس ثوان ليصرخ أحدهم فجأة وقد شاهد الرجل وهو يقذف بنفسه في الهواء وطرف المصرالآخر حول رقبته. كان ذلك عبدالله بن محمد ذاته حاسرا رأسه جاحظا بعينيه متأملا الأفق ومتدليا من على حافة الجسر"(249). هكذا تشكل الجسر فنيا، إلى أبعد من التوثيق التاريخي لما يحيط به من حكايا وأحاديث، حين احتفى الروائي باليومي والمتداول والعميق ليبلور صورة عالم متشعب، مسترسل، مثله مثل المشانق المتدلية في أي مكان، في حين أن الجسر يظل شاهدا وثابتا. وأكثر من ذلك حين أضحت دلالة المكان هي مجاراتها لوعي الناس وأحاسيسهم. إذ شكلت النفس الإنسانية براعة في رسم ما تكابده من معلَّقات ومشانق بفعل جسور المدنيَّة. - النَّمط الحقيقي، وهذا النَّمط يحضر بكل تداعياته بعد عودة اكتمال رؤية الجسر باكتمال امتداد الجسور بين المنطقة الداخلية والقرم والجسر الجديد، ليتأمل الجسور الممتدة في العاصمة مسقط، بكل ما تثيره في نفسه من تداعيات. وليس المراد بلفظة الحقيقي المعنى اللغوي المباشر بحد ذاته، وإنَّما المراد، أنما يتحكم بالسرد هو بنية مرجعية، أي الجسر الحقيقي وما يثيره ذلك من إشارات ودلالات جمالية وثقافية وتاريخية، وهو ما يصرح به البطل/ عبدالله بن محمد "في اليوم الثالث: الذي تكرر فيه مشهد الحبل المشنقة أمام جمهور الموظفين والعمال في طريقهم إلى أعمالهم بدا الأمر أشبه بتهديد حقيقي... الحبل المشنقة يتدلى من الفراغ من على جسر القرم، والسيَّارات تتزاحم، وتبدو أعين السائقين متجهة باتجاه الحبل بينما ينتشر رجال شرطة على رصيف الطريق"(250). من هنا يحضر الجسر في هذا النمط كمعادل موضوعي للمكان وكرمز من رموزه، ولكن هذا المعطى المكاني قد يتحول إلى فلسفة قائمة بحد ذاتها، تدل على التحول والانتقال، المهاودة والصراع، الغربة والضياع، وهذا ما نلحظه في قول البطل "في اليوم الرابع بدا الجميع ينتظر بلهفة وفضول ما يمكن أن يحصل. لكن لم يحصل شيء، لم يكن هناك حبل مشنقة، ولا حبل، ولا حتى أي شيء معلقا على جسر القرم"(251). إن دلالات الجسر كمكان دال على مساحة أكبر، إنَّها فلسفة خاصة زادت من تأزم المكان وضياعه. فما بين الجسر والمشنقة كمكان، منظار الجسر كمكان، بينما المشنقة التي تتدلى منه، هي النهاية، هو انتحار للإنسان. لذا تختلف النَّظرة إلى الجسر كمكان بين منظار الضياع والحضور، إذ لاحظنا أن الجسر في البداية يحضر عند شخصية البطل عبدالله، وهو غائب عن المكان بدلالة فنية الحدث، وبدلالات إيحائية الانتقال من حالة إلى أخرى. دلالة الجسر مرتبطة في مواجهة الجسر معاينة، لذلك تتناغم دلالات الجسر في الرواية مع المسار السردي لها؛ لتتخذ دلالات تصعيدية تساير الحدث، ومن هنا نقول أن تلك الدلالات ستجتح للتعبير عن النهاية المأساوية للبطل. هكذا يصبح فعل الشنق أو فعل الموت اختيارا، فليس هناك قوة سلطوية تستطيع أن تمنع أحدا من صنع مشنقته وتعليقها كما يشاء هو، ويختار"إن هذا ليس توقيته. لن يكون هو رجل المشانق إن جاء الآن. سيكون غيَّر من سلوكه، ويكون قد خدعنا جميعا!... كانت الأفكار تتقاذفه داخله بعنف. أيعقل أنه يكون فعلها الآن وهنا؟ أيعقل أن يكون قد قام الرجل أخيرا بتعليق شيء ما على الجسر؟ في مثل هذا الوقت؟"(252) فتظهر جدلية عبدالله بن محمد بمسميات الجسور (مسقط، القرم، الداخلية، الجسر الجديد) يقابلها المعلقات على رقاب الحسناوات تتدلى على صدورهن، التمائم تتدلى من على المرايا الصغيرة في مقدمة السيارات، أو على هيئة أشكال من مبدعي مصممي الديكورات -وهي أكثر المشانق سحرا وألقا- وبعضها غير مرئي ولا يدرك على أية صورة معدة سلفا. وهذا النوع الأخير قد يخرق العادة فيتدلى من الأسفل إلى الأعلى، وليس من الأعلى إلى الأسفل! مما يجعل هذه المعلقات من مفردات المكان الأولى بالنسبة له. تلك العلاقة التي تظهر لوثة الجنون الفلسفي نتيجة الوعي الحاد بآلام الحياة، وتناقضاتها، فيصل إلى حالة اللامحدودية من أي شيء، فيبدأ بشهوة الطيران في الفضاء المعلق بين الجسر والأرض يقترب من الجنون في أن تصفعه الحياة بالانتحار، الحياة التي ضيعته كثيرا. 5/3 سطوة المكان في رواية همس الجسور بينما رواية همس الجسور لعلي المعمري، تتناول الصراع من أجل الهوية الوطنية، وتحقيق العدالة الإنسانية، ومصير حياة الثائرين من خلال التطرق إلى التاريخ العماني الحديث، بدافع سياسي، متخذة من ثورة الجنوب العماني حدثا رئيسا، لتبلور الحكاية وتصاعدها، حتى انهزام الثورة وتشتت زعاماتها. تتحرك الشخصيات في فضاء مفتوح هو المجتمع العماني بأسره، وآخر مغلق هو المعتقل حيث السجناء السياسيون الذين ينادون بقضايا وطنية كالاستقلال، والآخرون من الخارج الداعمون والمناصرون للقضية العربية، والذين يوالون الاحتلال؛ أي السلطات التي تتحكم في البلاد. إن أبرز دلالات فضاء المكان في رواية همس الجسور يتشكل كعنصر مركزي في بناء العمل الروائي، وذلك لارتباطه الوثيق بالعناصر البنائية الأخرى، ودخوله علاقات متعددة مع بقية المكونات السردية، كالأحداث والشخصيات والرؤى السردية واللغة والزمان، وعدم النظر إليه ضمن هذه العلاقات التي تربطه بجميع عناصره "يجعل من العسير فهم الدور الفني الذي ينهض به المكان داخل الرواية"(253). تقترح علينا ثلاثة أنواع من المكان(256): المكان العسكري، وهو المكان الذي يمثل معقل عمليات الثُّوار. والمكان المحاصر، وهو فضاء المكان، الذي مثَّل امتداد الثُّوار وملاذهم. والمكان المفرغ، وهو فضاء إستانبول الذي تمَّ فيه سرد الحكاية، وما حملته من ذكريات ونتائج آلت إلى الموت دون تحقق لقاء منتظر بين الثائرة الكوبية همينة/ أمينة هانم، وابنها العماني وليد معسكر الثوار يعرب بن حمدان. - المكان حدود المأسأة: وهو الذي يعنينا في هذا المقام، وقد توهج ظهوره منذ بداية الحكاية، وحتى نهايتها "لقد كانت رحلة شاقة ليلة أمس، قطعتها من مسقط مرورا بالدوحة حتى وصولي مطار أتاتورك الدولي، ما كان سبب ذلك التعب والإرهاق المسافة وطولها أبدا، بل من كان يجاورني في الطائرة..."(257). لا تعنينا في هذا العنصر ظاهرة المأساة في حد ذاتها. بل همّنا فيه معرفة ما بلغته من مدارج الوحشية لننفذ من خلالها إلى المحركات الغامضة والقيم الدفينة التي تحركها وتغذيها، ونفصح عن أثر المكان في كلِّ ذلك. وليس من الهين الإحاطة بكل مظاهر المأساة في هذا الأثر، لكونها هي الإيقاع الرئيسي الطاغي عليه. ولهذا عمدنا إلى اختيار أبلغها دلالة وأقدرها إبرازا لظاهرة المكان، وكيفية فعله في الإنسان في زمن الفجائع، ومنها قصة أمينة وابنها يعرب. سيتبين لقارئ الرواية أن هذه العبارة تشكل المفارقة الجسيمة لذاكرة الثَّورة، وما آلت إليه من نتائج الفقد والخذلان والضياع. فتتأسس دلالة المكان بهذا المقطع "منذ وصولي إلى مدينة إستانبول، مع شقائق الخيوط الأولى لضياء فجر هذا اليوم، والمدينة غارقة في المياه... ويبدو أن مناخ الأتراك يعي يقينا أنني قادم من جفاف قاحل أصابني بالظمأ، وأصاب الصحراء بالجفاف"(258). إن الظمأ والجفاف ليس في حقيقتهما غير مأساة المكان الذي ألمت به من كل صوب، وراحت تدّكه، وتقتل الحياة فيه، وتسدَ عليه الآفاق، وقد انعكس ذلك على معقل الثَّوار، فكانت متذبذبة متوترة بين قطبين، هما: الثَّورة والمكان. ليكون اللقاء في مقهى "باديهانا الواقع في جادة إيطاليا بأطراف حيّ تقسيم، خلف شارع الاستقلال"(259)؛ منطلقا للتعارف، فتتأسس مغزى الحكاية ودوافعها بسرد المكان/الموت. لتعيد ذاكرة أشلاء المكان همينة/ أمينة هانم بكلمة التحية لأهل جبال الجنوب "عندما قالت كلمة أخذت ترددها ثلاث مرات خبور. وحينما تيقنت من نطقها السليم لكلمة خبور وجدتني أجيبها وأنا فاغر الفم ومندهش: خبور خير"(260). ثم يضيف الأثر مكمِّلا هذه الصورة الثانية "لقد ساورتني في تلك اللحظة ثورة من الشك في هذه المدعوة أمينة هانم... واعتقدت أنها واحدة من السائحات التي أغرتها السياحة بالسفر إلى ظفار بعد أن فتحت البلاد أبوابها في هذا القطاع، وإن مثل هذه الكلمات البسيطة والتي يتحبب بها السيّاح في تعاملهم مع السُّكان هناك في السهل والجبل جعلها لصيقة بذاكرتها حتى الآن، أو ربما تكون باحثة في الحضارات الغابرة والتي نبتت وبادت في جنوب شرق الجزيرة العربية حينما سمعت إردم يذكر عمان"(261). وممّا يهزُّنا في هذه الصورة جمال المشهد الأول المتوهج بحرارة التفاصيل العميقة للمكان وعلاقتها بالحدث. ومنها جسور إستانبول "الجسور تقع وتتقطع، بل وتتكسر في جملتها وتفاصيلها، وحينما تحدث مثل هذه الأزمات تحل القطيعة والانفصال محل الروابط..."(262)، وكذا الحديث عن جمال منطقة ظفار وتنوع تضاريسها بين السهل والجبل والحضارة الغابرة التي تشكلت فيها، والسياحة التي ماتزال تستقطب السُّيَّاح لجمال طبيعتها، المعبِّرة عن أصالة تاريخها وحضارتها. والمعمري بهذا ينحت للتضاريس محتواها الوجداني. ويؤسس لكيان المكان عمقه الحضاري عبر الذكريات، وجذور الانغراس في بيئته وفي نفسه بالتحية الخاصة لهذا المكان بكلمة خبور. والمشهد في جملته معرض لسحر الحياة ببساطة الحياة اليومية المفعمة بالبساطة والترحاب، والأمن والأمان. وهو خال من كل أثر لمعسكر للجيش، أو معقل للثوار، أو كل ما يدعو إلى الثورة أو الضياع. حدث حين تبعثر شتات الثُّوار على الفضاء، حتى غدت كلمة خبور/ خبور خير فاتحة للحكاية والحوار. فحكاية همينة/ أمينة هانم لا تنتهي عند هذا المكان. فصلابة الثورة الجنوبية، وقسوة نتائجها جعلت منها حدثا لا معقولا. "سألتني أمينة هانم؛ من أي منطقة من عمان، وهل أنت من السكان الأصليين... فأجبتها بأن أصلي وفصلي من تلك البلاد...، وأخبرتها إن كانت تعرف جغرافية المكان، قائلا لها إنني من منطقة الباطنة الشريط الساحلي الممتد..."(263). تلك هي دلالات المشهدين المعنيين. ولكن الحركة المزدوجة في المشهد الثاني قد تعنينا أكثر. فهي التي ستبدأ معها الحديث عن زحف، وتقهقر حركة ثوَّار الجنوب العماني التي غدت قصة حياة. ومتى ضاعت هذه القصة من قبضة اليد، وأضحت في موضع الشك من الغياب أو الموت. بفقد الماضي وقيمته ومعناه، فكأنه ضائع لم نطل من ورائه شيئا، ولم نتحصل غير البحث والانتظار. "- وهل تعرف سيف بن علي؟ سألتني عن هذا الاسم بلغة عربية مكسورة، وبرطانة ثقيلة. - إنَّه ابني، أجبتها، لذلك ينادونني أبو السيوف. لكنها تفحصتني بدقة، ردت بنفس الرطانة الثقيلة وهي تقول: - إنه لا يمكن أن يكون ابنك سيف بن علي، فمن أعنيه إن كان حيا لا بد أن يكون أكبر منك بكثير على الأقل بثلاثين سنة"(264). بهذه المقابلة الشفيفة التي حملت معها الصدفة مفاجاءات المكان العماني في مقهى باديهانا في مدينة إستانبول ينجلي معنى الفقد واللامعقول، ودلالات الماضي والغياب، فقد تشتت الثُّوار وعائلاتهم عند انهزام ثورتهم، بل خسروا فيه أول رمز للمكان/ المعقل الذي يستمدون منه طاقة الشعور بالتجذر في فضاء معين. وخسروا أداة يعيدون بفضلها تعبئة أنفسهم وصياغة كيانهم لمواجهة الحياة في كل يوم. والأدهى أنهم فقدوا امتدادهم. إنها قصة تتسم بالتجذر والألم. متكئة على فضاء إستانبول وحوانيتها ومقاهيها فضاء خصبا لسرد مأساة ثُّوار الجنوب وما ألمَّ بهم. لتستكمل ضياعها حكاية حدود مأساة المكان في المستشفى الأمريكي "وقبل أن نعرج لنتركها ترتاح في شقة أمينة طلبت منها الذهاب إلى ثلاجة الأموات بالمستشفى الأمريكي، كي تلقي نظرة على جثمان صديقتها أمينة. والحقيقة أنني أصبحت مسكونا بالرعب من ثلاجات الأموات، بعدما شاهدت جثة يعرب وهي مهمشة وموضوعة بدرج من أدراج ثلاجة الجثث في مستشفى بورصة...، وقرأت بالعربي كلمة خبور المكتوبة على الريشة، ووضعتها بين يديها المضمومتين على صدرها وطلبت غلق درج الثلاجة وأنا أقول لنفسي: هكذا بدت خبور في باديهانا، وهكذا انتهت في درج لحفظ الجثث"(266). إن ما أكده الكاتب/ الراوي في الباب الأخير/ باب الهمس والصمت من وصية همينة/ أمينة في كيفية التصرف بجثتها يشي بمراحل المكان الذي لازمته بقناعاتها، وما حصدته من معاناتها مع الثُّوار في الجنوب، لهو أكبر دليل على قدرية الموت، وسطوة تجذر المكان في هذه الرواية "تطاير بعض من رماد مخلفات جثة أمينة على أديم مياه البوسفور، بناء على وصيتها التي نصَّت على حرق جثمانها وتقسيمه ثلاثة أقسام بالتساوي: قسم يذر وينثر في مياه مضيق البوسفور، وهذا ما نفذناه أنا وهيلد. وقسم أوصت بنثره على ضفة ساحل من سواحل جزيرة كوبا، وسوف تقوم بتلك المهمة هيلد. أما القسم الأخير فيرسل إلى عنوان صديقتها راية وهي تعرف كيف تتصرف به..."(267). ذاك هو المكان الفارغ في فضاء إستانبول الذي شكَّل لُحمة أساسية للبناء الروائي، وقد حددنا منه الخطوط الكبرى للبنية الداخلية والنَّفسية للثورة الشعبية في الجبال الجنوبية وانعكاساتها، وما حصدته من تفاعلات ما انفكت تنال من مفهوم الوطن. وتترجم نفسها إلى واقع فعلي جديد بقدرية الموت وموت الحرية، دون لقاء كان منتظرا بين الطبيبة الثائرة الكوبية أمينة، وابنها يعرب حمدان المنغمس بملذاته. ومن الطبيعي ألَّا يهتم هذا المبحث بالمعيش اليومي في علاقته بالثورة إلَّا بالقدر الذي يساعده ذلك على تبين حدود المأساة. لذلك لم يعرض منه إلى تفاصيله الواردة في حكايات يعرب بن حمدان الذي مثَّل حصاد تجذر الثورة. - المكان العسكري منطلق المأسأة من أدعى الأمثلة إلى الرفض والاحتجاج فضاء المعقل العسكري للثُّوَّار، وهو الذي مثَّلته مركزية معقل التاسع عشر من يونيو في الجبال الجنوبية في إقليم ظفار. وهو في جملته يستمد سطوته من مبادئه وأهدافه وتطلعاته بالتخلص من نفوذ الاستعمار البريطاني، وتحقيق كرامة الإنسان في عمان والخليج العربي. أي - لا من وجود الدولة-، بل من انعدامها. فهو اللادولة واللاوطن. وهو قوة الحق، وملاذ الأحرار. وهو مقر كل المتطوعين من الدول العربية وغيرها، لأجل حق الإنسان وكرامته. صحيح أن كل الفضاءات التي تعبر بنا انضوت لأجل المكان العماني؛ ولكن هذا يقودنا بجلاء إلى الخطوط الكبرة للبنية السياسية الداخلية والخارجية التي تترجم نفسها على المكان كواقع فعلي جديد، حين اتاحت للثوار إيجاد الحلول محلها. وهكذا مثَّل المكان العسكري دورا بارزا في مسار أحداث رواية همس الجسور، وما ترتب عليها من نتائج مؤلمة. كان لقراءة همينة/ أمينة لكتاب بعنوان موجز تاريخ الصراع في ظفار، دافعا لها للذهاب إلى معسكر الثُّوَّار لتبدأ الحكاية من هناك. هذا الكتاب كشف لها الكثير عن مآسي الناس هناك مما دفعها إلى الالتحاق بعيادة معسكر الثوار"...قضت في الجنوب العماني أربعة أعوام ونيف، تداوي وتطبِّب من يحتاج إلى علاج في عيادة التاسع من يونيو في قطاع المنطقة الغربية من إقليم ظفار"(268). وحسبنا هذا الشاهد دليلا على كثرة الأخطار المتربصة بالثوار. انضوت تحت هذا الفضاء جنسيات عدة: كوبا بيروت دمشق عدن دبي مرورا بعُمان، لكنها جميعا هدفها الوصول إلى المكان العسكري لمعقل الثوار، يبرز أهمية المكان العسكري ما سمعته أمينة، وهي في طريقها من دمشق إلى عدن حين حدثها يوسف البرعي بدقة عن كفاح الشعب ضد الجور والاستعمار "لقد كان واضحا ومحددا في إعطائي فكرة عن المناخ وطبيعة المنطقة التي سوف أعيش فيها، كما أنه زادني بمعرفته بالواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي يعيشه إقيم ظفار... كان في استقبالنا في بيت عمان بدمشق دار ضيافتنا الرفيق سعيد سيف والرفيقة خيار مفتاح، وكلاهما كان شعلة من النشاط والتوقد، قدَّما لي ما أحتاجه من مساعدة لتسهيل مهمة سفري عبر طيران الميدا إلى عدن"(269)، وهذا دليل وشهادة على القيم الجهادية التي كان يتمثلها الثوار في ذلك المعقل. أما طبيعة الملتحقين للجهاد في هذا المعقل فكما بينه يوسف البرعي وترجمه لأمينة أبو غسان عن طبيعة الثوار في ظفار"...وبدأ يوضح لي أن الثورة في ظفار تختلف عنها في كوبا وبقية العالم، ولكنها تشترك مع غيرها في الأهداف والنيات، فلا توجد طبقة العمال ولا الفلاحين بينهم، وإنما هنالك الأغلبية من الرعيان وأبناء القبائل، وبعض نساء الإقليم، والشرفاء من بعض البلدان العربية، بغية مسح الظلام من أجواء ظفار وإلغاء القرون الوسطى من سماء عمان وكل شبر في إرضه"(270). ولعل هذا يقودنا إلى دوافع التحاق بعض الفئات الأخرى بمعسكر الثورة في ظفار "لذلك اجتهد الرفيق لدى مكتب المنظمة والجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي في تسهيل أمورهم كون طريق رحلتهم سيكون نفس الطريق الذي سيسلكه الرفيق أبو غسان، ولأنه صوت معروف، حيث كان ينتسب للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"(271). ولعل أبرز ما هدد الثُّوار في إقليم ظفار، مواجهتهم قوى عسكرية منظمة تدعم سياستها دول كبرى كبريطانيا، ومجاورة لها مصالح في الأرض العمانية وما جاورها هي إيران(272) التي غدت تروع مأمن الثوار وتماسكهم، وتخطف منهم البقية الباقية من إصرارهم على التمسك بالوطن وقضيته. وحسبنا هذا الشاهد دليلا على كثرة الأخطار المتربصة بالثُّوار. "كنَّا أنا وحمدان دون سوانا نتلقى بعض التوبيخات والتلميحات، بل والإهانات من قبل بعض القيادات الجديدة التي حلَّت محل القيادات القديمة لمعسكر التاسع من يونيو دون مبررات واضحة لأفعال صدرت منا"(273). فما عادت له إمكانية أن يكون مواطنا مدنيا مستقلا بذاته. وما عاد للفضاء المدني من وجود، فكل الفضاء فضاء عسكري أو لا يكون، والناس كلهم مقاتلون أو لا يكونون. "وأثناء وقوفي على باب خيمة العيادة وهو يهم بالذهاب لرؤية يعرب شعرت بقوة داخلية تدفعني كي أحضنه بشدة، لكنني لم أجرؤ على ذلك، وتركت بصري يحرس خطواته وظله وهو يمشي باتجاه الخيمة يحمل شمعة في يده اليمين. ما إن أدرت له ظهري عائدة إلى الداخل حتى سمعت صوت انفجار لم تسعفني الذاكرة لإدراك من أين جاء مصدره، وبعدها بثوان سمعت وأنا شبه مشلولة صوت طائرات الفاتنوم تقصف كل شيء في المعسكر ومخيم التاسع من يونيو، وآخر ما أتذكره من رؤية وأنا مصابة أنزف دما لا أعرف من أي بقعة يسيل من جسدي المشلول، مشهد خيمتنا تطير من الأرض بما فيها مع ضوء ووهج القنابل الساقطة على موقعنا"(274). ومعنى ذلك أن الصلة بالمكان تكف عن أن تكون حقا طبيعيا. بل وتكف هذه المعتقل الذي بناه الثوار جميعا أن يكون دافعا لحرية الناس جميعا وتعود القوة من جديد لتقرر وحدها شأن المكان."ذهبنا مهرولين إلى قائد المعسكر الذي كان يقف وقفة عسكرية... وبدوره كان قد جهز لي العدة والعتاد..."(275)، ورغم كل ذلك تبقى ذكرى معقل الثوار ملاذا أخيرا. ويبقى معه شيء من الفضاء. هو الفضاء الذاتي الشخصي الذي كان سببا لمأسآتها وضياع أسرتها. إذ كيف يمكن "كانت مدينة حوف المكان الأقرب والآمن الذي نلجأ إليه للتسوق وجلب حاجياتنا ومتطلباتنا التي تلزمنا بشكل دائم، ولا تستغني عنها في مخيم ومعسكر التاسع من يونيو"(276). ومن بليغ الدلالة في هذا الشاهد إشارته الخفية إلى بعض المعاني الدقيقة العالقة بمفهوم المعسكر. ذاك هو إقليم ظفار بمكانه العسكري، وقد حددنا منه الخطوط الكبرى للبنة السياسية الداخلية والبنية الاجتماعية والتركيبة العرقية لمعسكر الثوار بين جباله الممتدة حتى الحدود اليمنية، وما اتفق لها من تفاعلات ما انفكت تنال من مفهوم الوطن وتترجم نفسها على المكان إلى واقع فعلي جديد حتى أتاحت للعسكر مصادرة الوطن. يتضح مما تقدم أن ثورة الجنوب المعنية ليست حرب جيش يواجه جيشا أو جماعات مسلحة. وليس القصد منها هزيمة الجيش المقبل وتدمير منشآته العسكرية. بل القصد هدم البنية الفكرية والثقافية التي تنهض عليها الحياة كلها وتستقر فيها بعض مدلولات الهويَّة/ الأيدلوجية بين هذه القبائل. وبالتالي يغدو هذا التغيير "حاملا لرؤية إنسانية لا تجرح المشاعر ولا تحمل نكرانا للذات(279). والذي تشير إليه الرواية على نحو متكرر يتقاطع ومقولة أمين معلوف بأن"الهوية انتماء واحد يحصر البشر في موقف متحيز ومتعصب"(280).
__________________
ديواني المقروء |
|
#8
|
||||
|
||||
|
تابع ورقة -د. عزيزة الطائي :
- المكان المحاصر نهاية الثُّوَّار يمثل حصار معتقل الثُّوَّار ظاهرة هامة في المحنة التي آلت إليها مأساتهم. ومن دواعيه العامل الحربي، وهو الظاهر. وعامل الحساب السياسي وهو المضمر. ولا بد من مراعاة هذين العاملين معا لفهم المكان المحاصر، وإدراك دلالته ومراميه. وقد لا نوفق في هذا المسعى إن لم ننظر في كيفية مآل الثورة، وما عرفت من تطورات أدت إلى ممارسة الحصار على كمين الثُّوَّار في الجنوب العماني وتفجيره عام1975، فما يحمله معقل الثوار من ذاكرة شمولية عامة، باعتباره منتجا - عقائديا وفكريا- من الوعي البشري، ويصبح من الضروري تسليط الضوء على الجوانب الذاتية منها، ذلك أنه في نهاية المطاف يعمل – وفقا لبيرجر- "كمقاييس ثابتة لذاتية الإنسان"(281) ورغم الحصار الذي فرضته بريطانيا وشركائها على المعسكر، كان هناك تواصلا بين عناصر الجبهة في عمان وجبهة التحرير الوطني في البحرين من جهة أخرى وجماعات مستقلة بمن فيهم بعض العمانيين المقيمين في البحرين، فالرسالة القادمة لعليا من دمشق تحمل في طياتها "أخبارا سيئة عن البحرين والاعتقالات الجماعية التي يشنها هندرسن رئيس جهاز الاستخبارات وأعوانه..."(282) ويكفينا هذا شهادة على أن أخطر ما في العنف والحصار هو تردية الإنسان. فأزمة الحكاية تبدأ عندما تسرد أمينة بداية مأساة حكايتها في معسكر التاسع من يونيو "وكان صيف عام 1972 قد حل... استدعينا، نحن كافة الطواقم الطبية، من قبل قائد المعسكر، وطلب منا إلغاء كافة الإجازات والمهمات الميدانية التي نقوم بها بين الفنية والأخرى في مواقعنا في مستوصف المعسكر خلال الفترة التي تبدأ من شهر يونيو ولغاية نهاية شهر أغسطس..."(283). إن تطورات الأزمة أدت إلى ممارسة الحصار وتبريره، وصورة ذلك يوم تأجج التوتر بين الثوار والحرس "كانت المدينة تحت حراسة بعض العمانيين من معارف زوجي حمدان، وثمانية من البريطانيين من فرقة SAS، وكانت خطة الثوار شن هجوم مكثف على الحرس..."(284). كانت الانتصارات أو الهزائم خفيفة، وكانت سجالا بين الأطراف المتحاربة. ولكن هذه الوضعية لم تلبث أن تطورت لصالح قوى النظام "لكن الطيران Strike Master البريطاني حسم نتيجة المعركة لصالح النظام، مخلفا في ساحة المعركة منظرا فظيعا وبشعا..."(285) وبالتالي كانت الخسارة المعنوية في نفوس الثوَّار أكبر بكثير مما كان محسوبا. ومن تبعات قام شاه إيران بإرسال 200 مقاتل وسرب من الطائرات العمودية إلى ظفار، "فكان خط القرن الذي أصبح مركزهم عبارة عن خط دفاع شائك بالأسلاك والألغام وأجهزة إنذارات تمتد إلى الساحل في المغسيل وعلى أربعين ميلا داخل اليابسة"(286). الأمر الذي زعزع الخط الدفاعي وأدى إلى تقهقر الثوار نظرا لتعزيزه بسياج من الأسلاك والألغام والأعمدة المدببة يصعب اختراقه، "وكانت تلك هي الشعرة التي قصمت ظهر الجبهة الشعبية لتحرير عمان، بالانسحاب إلى حدود الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية"(287). ومن تبعات ذلك أن فكَّر بعض الثوار بمنحى آخر نظرا لبعض الممارسات الخاطئة، والأفعال الشائنة، التي بدت عند بعضهم وقاموا بالانسحاب أو الانضمام إلى السلطة المركزية التي تمثل الاستعمار "كان زوجي أبو يعرب مؤمنا كل الإيمان بمبادئه التي اعتنقها عن الثورة وضحى من أجلها وما زال يفعل، لكن هنالك أحوالا غيرت دافع الاستمرار والوثوق بهؤلاء البشر..."(288). ومن مهازل السياسة عام 1973 "كانت حرب أكتوبر التي دارت بين الفلسطينين وإسرائيل في الشرق الأوسط وتمَّ اغتيال الملك فيصل، وكان الشاه قد زاد قوة المساعدة للحكومة العمانية بإرسال ثلاث كتائب من القوات الإيرانية الخاصة لتحل في ظفار مع مساعدات لوجستية وثلاثين طائرة عمودية، وبذلك أصبحت القوات الإيرانية في ظفار ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل، أما المساعدات الأردنية التي أرسلها الملك حسين إلى عمان فقد كانت أيضا في نفس العام"(284). بينما عام 1974 كان إيذانا لنحر الثوار وتشتيت شملهم "فقد كثرت الانسحابات ونقشت ظاهرة هروب الثوار بأسلحتهم ومعداتهم العسكرية من مخيمنا ومخيم التاسع من يونيو إلى المدن التي تخضع للدولة العمانية، والتي أصبح اسمها سلطنةعمان منذ عام 1971"(289). والحق أن هذا يعادل السير قدما نحو الموت باستسلام بعض قواد الثورة وزعماتها إلى السلطة الحاكمة المتمثلة بالدولة العمانية، جرَّاء تدخلات بريطانيا وإيران ودعم الأردن بإرسال جيوشها لدعم الدولة العمانية الجديدة. وكما تغيرت علاقة المحاصرين بأنفسهم تغيرت كذلك صلتهم بالأشياء التي تربطهم بالمكان، الأشياء التي كشفت لهم عن وجوه من الاستغلال ما كانت تظهر لهم لولا الحصار. كل شيء في المكان أصبح رخيصا وهزيلا. "سألته عن دور الرفيقة خيار مفتاح... أجانبي بأنهم جمدوها من عضويتها، وجمدوا كثيرا من الكوادر الممتازة التي تعمل من أجل الثورة، وليس للمصلحة الشخصية"(290). إن الحصار انتزع الأشياء من حيادها وأبعدها عن كل معاني جميلة للإنسان، وحولَّها للانهزام والاستسلام ليجعلها مهملات لا قيمة لها للمقاومة وبالتالي للحياة "وكنا أنا وحمدان نحتاط حينما نتحاور بشكل سري عن الأمور الحساسة والمهمة التي تحدث من حولنا...، ويبدأ تلك الجولة حمدان بحديثه عن الهروب الكبير لقادة وميلشيات فرق الجيش الشعبي، ثم يعرج على الجوانب السلبية للتدريب السوفيتي والصيني على حرب العصابات، وأن تلك الأساليب لا تلائم رجال الثورة..."(291). لكن هذه الأسباب أمكنت المكان المحاصر لمعقل الثوار من قوى عظمى تناوشته وكانت الدولة العمانية تعي ذلك كلهأن يقدم آلاما عميقة وتضحيات رائعة عاناها وهو في عزلة كاملة عن العالم. وكان استسلامه عام 1975. ويوم ذاك عرف من وحشية الأعداء حين كبلوه بالقنابل ما يفوق طاقة الاحتمال البشرية. حتى ضاعت عشر سنين من حياة أمينة وهي في غيبوبة جرَّاء تلك سقوط تلك القنابل "ليل شهر أكتوبر من عام 1075 في معسكر التاسع من يونيو، وصحوتي يوم الخامس والعشرين من أكتوبرعام 1985 بمستشفى سيمون بوليفار في هافانا بكوبا الوطن"(292). وهكذا كانت نتائج وحشية الحصار الذي فرضته بريطانيا، وعززته المصالح المشتركة بين الدول. 5/4القرية مخزون التاريخ وتحولاته في رواية سيدات القمر وأخيرا رواية سيدات القمر لجوخة الحارثي، وهي رواية تتفتت فيها الرؤية السردية وتتوزع، ولكنَّها تنتج عن أصل واحد. رواية مهتمة بأمر التغيير والتحولات في المجتمع، تحكي قصة المجتمع العماني وما طرأ عليه من تغيرات تاريخية واجتماعية وتعاقب الأجيال، مواقف متراكمة عبر التَّاريخ، وثقل الواقع، ومنظور المجتمع للمرأة، ووسائط تعامل الرجل معها. منطلقة من قرية العوافي المتخيلة مكانا سرديا خصبا لقصص ممتعة مؤثرة، ترسم في مجموعها صورة التَّطور الذي طرأ على الناس وأنماط حياتهم. المكان في هذه الرواية هو مركز الثقل، وهو المضطلع بجزء هام من الوظيفة الدلالية؛ لذلك لزم أن يتفق له من العناصر والسمات والمركبات ما يسمح له بهذا الدور. فكان مثقلا بمظاهر الجدّة والعمق والتشابك والتناقض، ناطقا بمعاني السمو والجلال، ملتفا بلفائف الغموض والغريب، مزاوجا بين صلابة الواقع وطراوة الحلم. وهو "إنتاج تقرير ثقة عن تجارب الأفراد الفعلية"(331) متخذا دعوة مستمرة إلى التفكر والمراجعة للوصول إلى الواقع والمثال. فكما يقول الراوي: "هذه السحب الكثيفة، تروقني فكرة العلو والتخلص من الجاذبية، هكذا أراقب الغيوم من علٍ، وأتذكر اندهاشي حين اكتشفت للمرة الأولى إنّها ليست سميكة" (332). - المكان العشق الصامت رسمت الكاتبة مجتمعا كبيراً من خلال رسم عالم أصغر منه، هو قرية العوافي المتخيلة، والانطلاق منه أحيانا إلى مدن وبلدات أكبر أو -أكثر التطور الذي طرأ- إلى مدن غربية كبرى. دخول العلم ومظاهر المدنيَّة الحديثة وتغير أنماط الحياة. العادات والتقاليد القديمة والعلاقات -الشرعي منها والمحرم- والخرافات والأساطير والعبيد والإماء وتجارة الرقيق وآثارها الإنسانية في نسيج هذا المجتمع القروي. تلك هي طرافة الرواية مجملا في فضاء أحداثها وتناقض شخصياتها. ومدخلنا إلى مكانها. من عشق ميَّا الصامتة على ماكينة الخياطة تبدأ الرواية، ومن اختيارها اسم لندن لابنتها الذي لم يرتضِ كل المحيطين بها "يا ميَّا يا بنتي، قالت ميَّا نعم، رتبت المرأة على يديها وقالت لها: مازلت مصرة على هذا الاسم الغريب للمولودة؟ أحد يسمي بنته لندن؟ هذا اسم بلاد يا بنتي"(333). لذلك كان الاسم خارقا لمألوف الناس، بينما هو بالنسبة في نفس التي ظلت صامتة بوفائها لمن عشقت، له مدلوله المكاني والحضاري. ولئن شاء السرد له هذه الهيئة، فلكي يستأهل أن يكون تراكم المكان موطنا للتاريخ الجديد الي تؤسس الرواية انشاءه. والراوي/ عبدالله نفسه لا بد أن تتفق له الخصائص ما به يسمو لهذه المهمة. لذلك كله وما حمله من حكايات متعثرة مبعثرة من شتات القرية؛ إلَّا أنه ظل زاهدا، مترفعا عن سفاسف الحياة، أما روحه متطلعة إلى أمكنة جديدة متنوعة "كانت الطائرة تخترق سحبا كثيفة وعينا عبدالله تجافيان النوم على الرغم من الرحلة الطويلة إلى فرانكفورت"(334). فليس أشد عليه من أن يكون لا مكان له "أيتها المضيفة اللطيفة المصبوغة بعناية، ما شعورك وأنت تقضين كلّ حياتك معلّقة بين السماء والأرض؟ أنا كنت مثلك بين السماء والأرض حين رأيتها"(335). هكذا يتشكل فضاء المكان الذي ستجري فيه الأحداث، ستعمل الذات الكاتبة من الراوي عبدالله على تكوين بناء منسجما مع مزاج وطباع الشخصيات، وذلك "لأنه من اللازم أن يكون هناك تأثير متبادل بين الشخصية والمكان الذي تعيش فيه أو البيئة التي تحيط بها"(336) حيث يصبح بإمكان بنية الفضاء الروائي أن تكشف لنا عن "الحالة الشعورية التي تعيشها الشخصية بل وتسهم في التحولات الداخلية التي تطرأ عليها"(337). تظهر القرية بسماتها البدائية "الحوش الترابي المستطيل ينتهي بصالة ضيقة مفتوحة بعقد نصف دائري وغرفة وحيدة"(338). بينما المدينة "وقفت امرأة عمي في حوش بيتها المصبوب بالإسمنت في وادي عدي"(339). مدلولان يؤسسان مكان الرواية بين أصالة قرية العوافي وما تحمله من تاريخ وعادات، وبين المدينة وما تشكله من حداثة وعمران. "قالت لندن: لا أحب الخوير يا أبي، لا مكان فيها للمشي، قلت لها لا تبالغي، قالت: كل هذه الشوارع مصممة لأقدام السيارات لا لأقدام البشر"(340). يلج القارئ في عالم الرواية مزودا بفكرة مسبقة عن المكان؛ استفادها من عنوانها للفظة القمر، التي لا يقتصر معناها على هذا الكوكب الذي ينشدّ إليه الشعراء والرومانسيون، بل هو يتعدى ذلك إلى معاني الأنوثة الخصبة(الأنثى القمراء) ذات البياض، وكثرة الماء. فنجية تستنكر موقف عزان حين نادته، ليأتي إليها، ولكنه هرب "ركض كأنه جني فاجأه وهرب!.. يرفضني أنا. القمر؟" (341). روعا سرديا مهما على الواقع بكل تحولاته، تمثل هذا في فعل النَّفس، وفعل الوجود الخارجي. - القرية الرمز الأكبر للطبيعة يتشكل المكان مع طبيعة الشخصيات، وتركيبتها في المجتمع، وفي نظرتها لنفسها "حين كبرت نجيّة كان بيتها هذا – المكون من غرفتين مفتوحتين على صالة مطلة على الحوش بجدار واطئ"(342). ومن ذلك إن القرية هي الرمز الأكبر للطبيعة المكانية، إذ تطالعنا مشاهد من الدلالات تتصل: أولها: كون القرية تمثل الأرض الأصل. فهي عامل أمن وطمأنينة، والعودة إليها عودة إلى هذه الأم الخالدة، لذلك كان الأنس إليها مدعاة للتوازن النفسي والانسجام الحميمي مع الطبيعة، بما تمنحه للإنسان من شعور بالتواصل والاستمرار."كان عزان زوج سالمة راجعا من السهرة عند البدو تملكه إحساس بالنشوة،... من بعيد لاحت له أنوار العوافي،... وقد قرر عزان أن يعود إلى العوافي"(343). وهي إلى جانب ذلك الرفض والبلاء عندما انفتح السرد إلى عالم الرق وصلته بأسيادهم، تتعزز قيم القرية القديمة "إن أهل العوافي لن يروه الضابط الناجح... هؤلاء الناس يؤمنون في الماضي لا في المستقبل"(344). وقول سنجر لأمه "نحن أحرار يا أمي"(345) ثانيها: ما تمثله القرية من معاني الجدب التي هي رمز للموت الطبيعي لإنسانية الإنسان، وفي هذا يقول الراوي: "أرى نافذة الطائرة سيل الأنوار يسيل من المدن على البحر، سيل متعرج ومهادن، لا يشبه سيل العوافي الذي أغرق زيدا"(346). حتى الدكان فيها فالاتساع يحدث خارج حدودها حتى وإن لم يكن في المدينة "لم أكن قد رأيت سوقا في حياتي، فالدكان الوحيد في العوافي، وحلويات العيد على ألواح من الخشب بجانب مصلى العيد... أما في عبري فكان السوق عبارة عن صفين متقابلين من الدكاكين، وربما المخازن"(347). وعندما يجري تجاهل الارتباط ونفي العلاقة بين الإنسان والمكان، فإنه لا يكون له إلَّا معنى الغياب. قرية فضاؤها مظلم، بيوتها طينية، مساحاتها ضيقة. ولا يرجى التئامها بغير إحلال الإنسان في الوضع الطبيعي الذي ينبغي أن يكون فيه. وثالثها: مفهوم الخصوبة الذي تستقر فيه إشارة خفيّة إلى الحدث الجنسي الأول الذي أنتج الحياة، وهو تجسسيم الرمزي الذهني المتواصل التي لولاها لا ما كان الوجود. فظريفة ليست محض خادمة، وإنَّما هي زوجة وأم وخليلة "عادت ظريفة من عرس أسماء منهكة من الرقص والغناء والخدمة، لكنّها وجدت التاجر سليمان مستيقظا بانتظارها، إنّه يحبّ خاصّة أن يأخذها بعد الأعراس لزينتها ولروح التجاذب التي تشعّها أجواء الزواج الجديد. كانت ظريفة ترغب في الراحة، لكنّها أرضته على عجل فنام"(348). هي تاريخ وذكرى ومكان هي حالة مجتمع. وهكذا تشتق شخصية ظريفة من عناصر المكان وحركته وعطائه. وهو ليس جمال الأشكال بقدر ما هو جمال الاتساق "والانسجام وتجاوب الموجودات مع خفق الطبيعة ونبض الحركة فيها"(349) والقرية تحمل خطابا آخر، أشار إليه الراوي "على كثرة أسفاري مازلت أفضل الجلوس بجانب النافذة ومراقبة المدن الكبرى وهي تصغر تدريجيا حتى تتلاشى"(350). ومن البين أنه يعني أن القرية هي فضاء وجوده وحريته مع تقلص المدن الكبرى أمامه، وكأن القرية بمساحتها الصغيرة والمغلقة، هي الأصل حين يستعيد الحياة التلقائة والبساطة والأمان في حضن ظريفة كما أشار الراوي"خبئيني في صدرك يا ظريفة أنا خائف، احشري رأسي بين حجرك وصدرك، دعيني أستنشق العرق والمرق، ودعيني أنام"(351). فيسقط عن الإنسان بعض من قناعه ليخلص للآخر وينفتح له. فيتخفف من عبء الفردية إلى حد كبير. ويخرج من عزلته يتعاطى الجماعة لأن الوجود الإنساني هو الأصح والأهم في عرف القرية. هكذا تتخذ القرية، وانفتاحها على المدينة بجليل من الرمز والإيحاءات. فهي مصدر القيم القاسية والأعراف البالية، وهي الوسيط التجذر بين الإنسان والأرض، أو الطبيعة عامة. وهكذا ستنتهي القراءة للمكان في رواية سيدات القمر إلى اكتشاف نوع من التطابق والاندماج بين طبيعة القرية وتركيبة الشخصيات التي تفيم فيها، وتتخذ الصلات بينهما مظهرا يكون من الضروري فحصه قبل أي تفكير حول الفضاء الروائي. - المكان بين الحلم والواقع رواية تتشكل فيها علاقة إشكالية بين الواقع المعقد والحلم المتجذر. هذه العلاقة تبنى عليها الرواية في مستوى الشكل والمضمون، وفي مستوى المكان والشخصيات التي تتفاعل معه من خلا تعاطيها الحياة، فيغدو الحلم واقعا والواقع حلما."قالت لي لندن: أحب الغيم يا أبي، وأنا صغيرة كنت أحلم أنّ لي جناحين مثل البنت في الفوازير وأطير وأجلس فوق الغيم"(352) فما كان المكان فضاء فعليا ماديا أو فضاء ذاتيا مجردا. بل كان هذا وذاك، وإن بدا الحلم الخيالي أقرب وأميل. وحاصلها أنَّه مقدم على قراءة رواية يشكل فيها المكان/ الحلم أساسها الأول، أو يتبوأ فيها مقاما مميزا في أقل تقدير. فالحلم حاضر في الرواية حضورا مكثفا، بل لا يأذن للواقع أن يكون ذا حضور مستقل عنه، فيغدو الواقع(*) حلما، ويغدو الحلم واقعا، ويتداخل الاثنان حتى يصعب – إن لم يتعذر الفصل بينهما- أحيانا."شعرت مرارا بأنَّها ستموت تحت وطأة الرغبة في رؤيته"(353). مولد ناظم اتكأت عليه الكاتبة عبر رحلة الفضاء، رحلة المكان، وما يجول بخاطر الطائر المحلق الذي يستعيد الزمن، ويستحضر شريطا من الأحداث مشتتا، وصورا من الشخصيات واضحة في ذهنه، غامضة في لفظه. صحيح أن الفصل بين الحلم والواقع ماثل في وعي الشخصيات الروائية أحيانا، فها هي ميَّا تقول مفصحة عن هذا الوعي: "أحلف لك ياربي إني لا أريد غير رؤيته، بالعرق على جبينه مرة أخرى، بيده على جذع النخلة، بالتمرة يلوكها في فمه"(354)، وشبيه بهذا الموقف موقفها يوم ولدت ابنتها وكذا موقف أسماء يوم عرسها "فتحت أسماء عينيها فتذكرت أن اليوم يوم عرسها. تململت لبرهة في فراشها، تحسست بطنها لفكرة تكور بعد أشهر قلائل"(355) بيد أن الفصل الواضح كثيرا ما ينسحب متراجعا، تاركا مكانه لتحول الواقع إلى حلم من جهة، ولتحول الحلم إلى واقع من جهة أخرى. فمن الأولى يصير الواقع، كل الواقع، فهذا الرواي عبدالله يقول:"أنا جلست في هذا المقعد المعلق بين السماء والأرض انتظر وصولي الوشيك لفرانكفورت، أنا في حجر ظريفة في الحوش الشرقي من البيت الكبير، عيوني مفتوحة على القمر المكتمل في السماء، وظريفة تمسد شعري وتحكي"(356). ومن جهة أخرى تحول المكان الحلم إلى واقع، يشعر الراوي أن الأحلام تمزقه باستمرار "لم يكن الناس في العوافي يعرفون أنّ وجهها الصلب شديد السمرة يخفي وراءه نهما عجيبا للحياة، وإن عرفوا أنّ هذه المرأة الميّالة للصمت والتكتم هي في الحقيقة -الماما الكبيرة- في حفلات الزار التي تُقام كل شهر في الصحراء خارج حدود العوافي وقلعهتا ومزارعها"(357). فكلما حاولت جميع الشخصيات الابتعاد عن واقعها، أعادتها إليه أحلامها المتجذرة. إن العلاقة بين المكان الحلم والواقع في رواية سيدات القمر، ليست علاقة سطحية ضحلة يتسنى استجلاء أبعادها، بل هي علاقة إشكالية قادت إلى تشعب في العلاقات الإنسانية. فنحن كما يذكر أمين معلوف"مؤتمنون على إرثين: عمودي يأتي من الأسلاف، وأفقي يأتي من العصر"(358) ومن الجهة الأخرى، جهة تحول الحلم إلى واقع، وهكذا تشعرنا الرواية باستمرار أحلامها وتمزقها. 5/5 الخاتمة لقد مثل المكان في الرواية العمانية مشروعا سرديا مهما، وعينا على الواقع ماضيه وحاضره، الواقع بكل إشكالاته وتشققاته وأزماته. ولا يدون تاريخ مكان الإنسان بما يحمله من دلالات في أدق خصائص حياته سوى الأدب. ومن خلال قراءتنا للمتن الدروس، والتي سعينا من خلاله تناول المكان، وربطه ببقية المكونات الروائية في ثلاثة محاور، وهي: أنواع المكان، والعلاقة بين المكان والحدث، والعلاقة بين المكان والشخصية يمكن أن ننتهي، إلى: - أن المكان من أهم عناصر البناء حضورا وتفاعلا وتوظيفا في الرواية العمانية، على تفاوت بطبيعة الحال في كيفية هذا الحضور والتفاعل. ولكن الدراسة كشفت عن فهم واضح لأهمية المكان في العمل الروائي، وإفادة جيدة من دلالاته وعلاقاته بالمكونات الأخرى، بل إن المكان في عدد من الروايات يكاد يحتل مرتبة البطولة، ويشكل شخصية رئيسة. - وقد كشفت دراسة المكان أيضا عن ارتباط الروايات العمانية ببيئتها خلال هذه الفترة بصورة أقوى وألصق من المراحل السابقة، سواء قُدِّم ذلك بوضوح من خلال الروايات التي صورت بيئتها المكانية المحلية بدقة وعناية، وكانت هي المسرح الوحيد للأحداث وحركة الشخصيات، والخلفية الرئيسة للبيئة الروائية، أو قُدِّم بصورة أقل وضوحا عبر القضايا الاجتماعية المرتبطة بالبيئة العمانية، والتحولات الجديدة التي شهدتها أثناء الطفرة، وبعدها كقضية السفر إلى الغرب للدراسة أو السياحة أو التجارة وما صحب ذلك من انحراف سلوكي، وقضية اللهاث المادي المسعور وتخلخل العلاقات الاجتماعية، وقضية انتقال أبناء القرى إلى المدن بحثا عن المال، ورغبة في التمدن، وقضية الانحراف السلوكي والفكري جرَّاء الانفتاح الثقافي والإعلامي، وقضية تعليم المرأة وعملها، وغيرها من القضايا الاجتماعية المرتبطة بالبيئة العمانية، والمتأثرة بالتحولات الاجتماعية فيها، والتي قُدِّمت عبر شخصيات منتمية للمكان ومرتبطة به بأسمائها وقضاياها وحركتها منه وإليه. - يتميز المكان في النص الروائي العماني بالتنوع، فلا وجود لمكان واحد فقط في الرواية؛ هناك دائما إطار مكاني عام، وأمكنة متعددة داخل هذا الإطار، حتى الروايات التي تنحصر فيها الأحداث في إطار مكاني صغير أو ضيق تأتي مشتملة على عدة أمكنة داخل هذا المكان. فلو أن رواية اتخذت من قرية معزولة مكانا روائيا لأحداثها، فإننا داخل هذا الإطار المكاني الصغير سنجد عدة أماكن كالبيوت والأزقة والحقول وغيرها، أو لو أن رواية اتخذت المدينة مكانا لأحداثها فإننا داخل هذا المكان الكبير نجد الشارع والمقهى و الأبنية مكان الدراسة، وغيرها. - إن المتأمل في الرواية العمانية يلمس تأثير طبيعة المكان (قرية أو مدينة) على نوعية الأحداث والقضايا المطروحة في عدد الروايات التي كان المكان فيها حاضرا بصورة فاعلة، بوصفه جزءا صميما في بنية العمل، وعنصرا فاعلا يؤثر ويتأثر بالعناصر الأخرى. - لاحظنا أثناء الدراسة أن العلاقة بين المكان والشخصية، جاء من خلال ثلاثة محاور: 1) المكان مؤثرا في الشخصية في رواية سيدات القمر، ويمكن أن نلمس هذا التأثير من خلال إدخال العالم الخارجي بتفاصيله الصغيرة في عالم السرد الروائي التخييلي لإشعار القارئ بأنه يعيش عالم الواقع لا عالم الخيال، فاختيار الكاتبة للأسماء وربطها بالمكان وسيلة من ضمن الوسائل المحققة لإيجاد هذا الانطباع المباشر بالواقع لدى القارئ. 2) كشف المكان عن طبيعة الشخصية في رواية المعلقة الأخيرة. إن وصف أشكال المعلقات بأحجامها وأنواعها وألوانها، وصولا بدلالات جسور المدينة، كل ذلك لم يأتِ دون مسوغ، وإنما سيق لأجل التعرف على شخصية عبدالله بن محمد المأزومة ومستواها الاجتماعي، و وضعها المادي، وذوقها وطبعها ومزاجها. كما أنها قامت بالدور التنفسيري داخل النص الروائي. 3) المكان متأثرا بالشخصية في رواية همس الجسور. فالشخصية ساهمت في الكشف عن جوانب تعدد الأمكنة من خلال الراوي أبو السيوف، لأنها هي التي ترينا الأمكنة الكبيرة والصغيرة، فهو لا يظهر في العمل الروائي إلَّا من خلال حركة وجهة نظر شخصية تتحرك فيه، ولذلك فهي لا ترينا منه إلَّا ما تريدنا أن نراه؛ ومن ثم فإن مشاعر الشخصية وحالتها النفسية قد تنعكس على رؤيتها للمكان.
__________________
ديواني المقروء |
|
#9
|
||||
|
||||
    اليكم صور الندوة
__________________
ديواني المقروء |
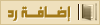 |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
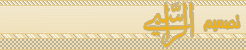 |
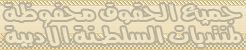 |